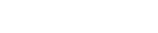خاص هيئة علماء فلسطين
د. مولاي عمر صوصي
الملخص
يعتبر تفسير القرآن الكريم عملا جليلا لشرف موضوعه، لكنه في الوقت نفسه محاطا بالمخاطرة لما يحتمل أن يكون فيه من التقول على الله تعالى وتأويل كلامه بالتشهي والتسلط، من هنا برزت أهمية الحديث عن أصول التفسير لتعصم المفسر من الزلل والسقط. وممن اهتم بالتفتيش عن هذه الأصول نجد العالم الجليل ابن تيمية حيث أفرد لها كتابا يحمل اسم “مقدمة في أصول التفسير” وكذا المفسر الكبير ابن عاشور في مقدمة تفسيره “التحرير والتنوير”، فقصدت إلى المقارنة بين عمل الرجلين لاستكناه معالم الوصل والفصل بينهما والاستفادة من خبرتهما لتكون نبراسا للمشتغل بالتفسير وحامية له من الوقوع في الافتراء على الله عز وجل.
Abstract
The interpretation of the Holy Quran is a great work for the honor of its subject, but at the same time surrounded by the risk of what is likely to be a pounce on speech of God Almighty and the interpretation of his words wrongly, hence emerged the importance of talking about the principles of exegesis to keep the interpreter from sliding and falling. Those interested in the search for these rules we find the savant Ibn Taymiyyah, where he wrote a book entitled “Introduction to the Origins of Interpretation” and the great exegete Ibn Ashour in the introduction to his exegesis entitled “Liberation and enlightenment.” I compare the work of the two men, to be a guiding light for the interpreters and protect them from mistakes.
المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام متلازمين أبدا وسرمدا على خير البرية محمد وعلى آله ومن اقتفى أثره ولف لفه إلى يوم الدين.
إذا افتخر كل ذي فن أو علم أو صنعة برايته فحق لأهل تفسير القرآن أن يبزوا الأقران ويثقل بهم الميزان، كيف لا والقرآن الكريم صلة الوصل بين السماء والأرض ومعجزة أهل الإسلام ومعين أهل البيان ومرجع من رام الإحسان وباتباع أحكامه وتوجيهاته يستقيم الإنسان ويصطف البنيان ويعلو العمران.
وإذا كان فريق من المفسرين والفقهاء يقفون عند ظواهر النصوص خوفا من الاجتراء على كلام الله تعالى والافتئات عليه، فإن جمعا آخر يرى في ذلك قصورا عن إدراك المعاني الخفية وجمودا على القشور مما يفوت على السابح في بحور القرآن الحكيم اقتناص اللآلئ ويستر عنه الجواهر ويعمّي عنه درر الحكمة ويحرمه فصل الخطاب، كيف لا وقد قال سبحانه: ﴿فَاعْتَبِروا يَا أُولِي الأبْصَارِ﴾؟ [الحشر:2]، وبمعرفة الباطن الخفي يتميز العالم عن الهاوي والأمي، قال ابن القصار في مقدمته: “إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتحن عباده، وأن يبتليهم فرق بين طرق العلم، فجعل منها ظاهرا جليا وباطنا خفيا، ليرتفع الذين أوتوا العلم، كما قال عز وجل: ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ [المجادلة: 11]…﴿وما يذكر إلا أولوا الألباب﴾[آل عمران: 7].”[1]
لكن الإيغال والإفراط في تأويل النصوص دون قيد أو شرط من شأنه أن يورد صاحبه المهالك ويذهب به كل مذهب، حتى ترى كل متزبب وهو حصرم يتقول على النص المقدس وبه يتحكم، مما جعل بعض العلماء يعزون سبب تشظي أمة الإسلام وتمزقها مزعا إلى التأويل، فهذا ابن رشد الحفيد يقول: “وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع، حتى تمزق الشرع كل ممزق، وبعد جدا عن موضعه الأول.”[2]
هذا المزلق حفز العلماء على سنّ ضوابط عاصمة من الهنات، ومانعة من الزلات، وأنا في ورقتي هذه اخترت أن أعرض لعالمين من أساطين علم التفسير وأصوله هما الإمام أحمد ابن تيمية من خلال مقدمته في أصول التفسير، والإمام الطاهر بن عاشور من خلال مقدمته في تفسيره التحرير والتنوير.
وقصدي من اختيار هذين الرجلين ـ أحدهما من القدامى والآخر من المحدثين ـ هو النظر إلى تطور حركة أصول التفسير مع كر الأزمنة ومر الدهور، حيث الإشكالية:
– هل فَضُل للمتأخرين ما يسهمون به في هذا الفن، أم تصدق عليهم مقولة: ما ترك الأقدمون للمتأخرين شيئا؟
– هل هذا العلم يسير وفق صورة خطية حيث يستفيد اللاحق من السابق فيحصل التراكم ويعلو البنيان؟
– هل تقدم الزمان من حيث ظهور أقضية جديدة وتطور العلوم التقنية والاجتماعية والسياسية يسهم في تطور علوم القرآن والتغيير في أصول تفسيره وتأويله نقصا وزيادة وتعديلا؟
وقد قسمت ورقتي إلى محورين خصصت الأول لأصول التفسير عند ابن تيمية، حتى إذا استوى على سوقه، عطفت عليه بالمحور الثاني متناولا فيه أصول التفسير عند ابن عاشور لأختمها بخاتمة تحوي أهم الخلاصات والنتائج.
المحور الأول: الجهاز التفسيري (أصول التفسير) لدى ابن تيمية[3]
يعرف ابن تيمية رحمه الله أصول التفسير في معرض حديثه عن الداعي لتطريز هذه المقدمة إذ يقول: “فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغَثِّ والسمين، والباطل الواضح والحق المبين.”[4]
يقسم ابن تيمية المتصدين للتفسير واختلافهم فيه إلى نوعين: “منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا.”[5]
وأما غير هذين المنهجين فباطل وغير مقبول أو على الأقل لا يعرف حكمه على وجه الجزم واليقين، قال: “وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.”[6] وقد مثل للمتوقف فيه بـــ”اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك.” واعتبره “مما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه.”[7]
وعليه، نقسم تبعا له هذا المحور إلى قسمين، نخصص الأول للمنهج الأثري حتى إذا انتجز خضنا في المنهج الاستدلالي ثانيا.
أولا: المنهج الأثري في تفسير القرآن
أ- تفسير القرآن بالقرآن[8]:
إيمانا من ابن تيمية أن قائل الكلام هو أعلم بمراده ومقصده من حديثه يؤكد أن ” أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِلَ في مكان فإنه قد فُسِّرَ في موضع آخر، وما اخْتُصِر من مكان فقد بُسِطَ في موضع آخر”[9]، ثم استدل لذلك بحديث معاذ رضي الله عنه المتداول بين المفسرين والأصوليين حيث تظهر بجلاء هرمية مصادر الاحتجاج والتشريع والمعرفة الإسلامية حيث الحكمة تقتضي “أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله r لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ” بم تحكم؟ ” قال: بكتاب الله…” (وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد.)[10]
ب- تفسير القرآن بالسنة:
بعد النظر في القرآن الكريم وطلب تفسير آيه من آيه باعتباره نسقا متكاملا يفسر بعضه بعضا، ولو كان من عند غير العليم الحكيم لوجد فيه المبطلون اختلافا كثيرا، إذا لم يجد المفسر طلبته صراحة فإنه ينتقل إلى المصدر الثاني من الشريعة ألا وهي السنة المطهرة الشريفة، قال ابن تيمية: “فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله r فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: 105] ، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: 64] ، ولهذا قال رسول الله r: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك.”[11]
وقد توقف ابن تيمية في هذه المسألة كثيرا ليرد شبهة عدم صلاحية المنقولات بسبب ضعف أو غياب الإسناد في المرويات الحديثية المتعلقة بتفسير القرآن الكريم فقال: ” ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير، والملاحم، والمغازي. ويروي: ليس لها أصل، أي إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومن بعدهم، وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب أبن عباس، كطاوس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب.”[12]
كما نافح عن حجية المراسيل رغم أن بعض المحدثين يتكلمون فيها بالضعف أو التقوية مشيرا إلى أن: “المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فان النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب.”[13]
ثم بين رحمه الله أنه من طريق العقل يمكن أن نثبت مشروعية الاحتجاج بالمرويات الحديثية أو التفسيرية فمثل لذلك بما يجري في واقع الناس: “فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطئا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقًا بلا قصد علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة؛ فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ، لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية ورَوِيٍّ فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعني مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون، وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بَدْر وأنها قبل أُحُد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة.”[14]
واعتبر شيخ الإسلام أن تواطؤ المخبرين من غير اتفاق أساس من أساسات هذا الدين، لذلك عرفت الأمة الإسلامية بأنها أمة الإسناد واشتهر فيها علم الجرح والتعديل حفاظا على الآثار وتنقية لها من الشوائب والدواخل: “وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.
ولهذا إذا روى الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي r من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نَقَلَتَه ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط؛ فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب، وابن عمر، وجابر، وأبي سعيد، وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله r، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبره باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس، ويقطع الطريق، ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة، والشام والبصرة…
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين، من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا؛ فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن ” خبر الواحد ” إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم.”[15]
وحذر ابن تيمية من المرويات الموضوعة كذا المصنفات في ذلك ومثل لذلك بنماذج من موضوعات الشيعة الإمامية: “والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: 7] أنه علي ﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ [الحاقة: 12] أذنك يا علي.”[16]
ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة:
وما دام الصحابة الكرام قد حازوا رضوان الله تعالى خالدا مسطرا في كتابه المجيد ونالوا الصحبة المتشربة والمعية المباشرة من النور الأول والمبيِّن الأعظم فقد صاروا أهلا لتحمل وأداء المرويات التفسيرية بكل ثقة وأمان، بل هم بعد معلمهم r أولى وأحق وأجدر من يفهم عن الله مراده ويفسره بين الأتباع، لذلك أكدّ ابن تيمية هذه الهرمية: ” وحينئذ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين؛ مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كُرَيْب، قال: أنبأنا جابر بن نوح، أنبأنا الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق؛ قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلمُ مكان أحد أعلمَ بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس، ابن عم رسول الله r وترجمان القرآن، ببركة دعاء رسول الله r له حيث قال: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل.”[17]
د- تفسير القرآن بأقوال التابعين:
ومعلوم أن جيل التابعين قد حظي بالمدح والثناء والتزكية من خلال الحديث الصحيح: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»[18] مما جعل ابن تيمية يهتبل بهذا الجيل ويزكي مروياته واجتهاداته التفسيرية خاصة إذا أطبقوا على قول وأجمعوا على تفسير: “إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر؛ فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح، عن مجاهد قال: عرضتُ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي، قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: مافي القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش؛ قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحْتَجْ أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب قال: حدثنا طَلْق بن غنام، عن عثمان المكي، عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله؛ ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جُبَيْر، وعِكْرِمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المُسَيَّب، وأبى العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك بن مُزاحم، وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك. “[19]
ثانيا: المنهج الاستدلالي في تفسير القرآن
بعد تبني ابن تيمية للمنهج الأثري ومنافحته عنه وبيان وجاهته وقوته، انتقل للحديث عن المنهج الاستدلالي ليبين عوره وهشاشته وكوْنَه من الزبد لا من الخاثر ومن الغث لا من السمين، فقال رحمه الله تعالى: “وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق، ووَكِيع، وعبد بن حُمَيد، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. ومثل تفسير الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وبَقِيّ بن مُخَلَّد، وأبي بكر ابن المنذر، وسفيان بن عيينة، وسُنَيْد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبي سعيد الأشج، وأبي عبد الله بن ماجه، وابن مردويه:
إحداهما: قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.
والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه والمخاطب به.
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.”[20]
ثم يسترسل شيخ الإسلام ليشنع على من يتقولون على القرآن ويتسورون حماه بغير علم ولا هدى ويقسمهم إلى صنفين ذاكرا بالتسمية بعض هؤلاء الفرق: “والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقًا فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج، والروافض، والجهمية والمعتزلة، والقدرية، والمرجئة، وغيرهم.”[21]
ومما يثرب به ابن تيمية على المتسورين حمى القرآن أنهم يسبقون التفسير بآرائهم ومعتقداتهم حتى إذا لم يسعهم اللفظ لووا عنقه وطوعوه ليصير مستساغا عندهم: “والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم.
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا، ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة…وأعجب من ذلك قول بعضهم {وَالتِّينِ} أبو بكر {وَالزَّيْتُونِ} عمر {وَطُورِ سِينِينَ} عثمان {وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} [التين: 1-3] علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص.
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.”[22]
وقد خلص رحمه الله إلى قاعدة تساير منهجه السلفي وتنسجم مع معتقده الملي وهي: “وفي الجملة من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله r، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.”[23]
ثم ختم ابن تيمية حديثه عن طائفة من المتصدين للتفسير ولا مسكة لهم من عقل ولا لغة ولا أصول وغيرها إنما يصدرون عن رأي مجرد ليبطل عملهم هذا ورميه بالحظر والحرمة ووعيد الله تبارك وتعالى وقد حشد لذلك الأدلة والنقول ليعضد مذهبه ويقوي حجته: “فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مُؤَمَّل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله r: «من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار». رواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، (2950).
وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي r وغيرهم، أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم: أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا، أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القَذَفَة كاذبين، فقال: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: 13] فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة، عن سليمان، عن عبد الله بن مُرَّة، عن أبي مَعْمَر، قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تُقلّني، وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ ! . وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: حدثنا محمود بن يزيد، عن العَوَّام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي؛ أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: 31] فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد، عن حميد، عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأبُّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر.
وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس؛ قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه.
وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتًا من الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ [عبس: 27- 30].
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة؛ أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكة؛ قال: سأل رجل ابن عباس عن: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: 5] فقال له ابن عباس فما: ﴿يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: 4] فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية، عن مهدي بن ميمون، عن الوليد بن مسلم، قال: جاء طَلْق بن حبيب إلى جُنْدُب بن عبد الله، فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحَرّج عليك إن كنت مُسْلِمًا لما قمتَ عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب؛ أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: “إنا لا نقول في القرآن شيئا”…وعن مسروق قال: اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن الله.
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف، محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه؛ لقوله تعالى: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187] ، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: «من سئل عن علم فكَتَمَه أُلْجِم يوم القيامة بلجام من نار».
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشَّار، حدثنَا مُؤَمَّل، حدثنا سفيان عن أبى الزِّنَاد، قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.”[24]
وقد نحى نحو ابن تيمية كثير من علماء الأثر محذرين من مغبة التأويل الفاسد، ومنهم صدر الدين الحنفي عندما رفع عقيرته: ” وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قُتِلَ عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل ،وصفين ، ومقتل الحسن ، والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج، واعتزلت المعتزلة، ورفضت الروافض، وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، إلا بالتأويل الفاسد ؟!”[25]
ظهر لنا إذن بجلاء أن التفسير عند ابن تيمية مبني أساسا على ثنائية التفسير بالمأثور والتفسير بالاستدلال، وأنه رحمه الله لا يطمئن ولا يستروح إلا للتفسير المنقول عن الأكابر علما وتقى وتزكية من الله تعالى ورسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى النظر في أصول التفسير عند محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله لنرى النفس التجديدي عنده في هذا الفن.
المحور الثاني: الجهاز التفسيري (أصول التفسير) لدى ابن عاشور[26]
جعل الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور لكتابه ” التحرير والتنوير” عشر مقدمات جعلها تبيانا لهديه ومنهجه في التفسير، وهي :
1- في التفسير والتأويل وكون التفسير علما.
2- في استمداد علم التفسير.
3- في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه.
4- فيما يحق أن يكون غرض المفسر.
5- في أسباب النزول.
6- في القراءات.
7- قصص القرآن.
8- في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها.
9- في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن، تعتبر مُرادها بها.
10- في إعجاز القرآن، مبتكرات القرآن، وعادات القرآن.
وسأسعى من خلال قراءتي لها أن أستجلي أهم مرتكزاته وقواعده التفسيرية ما يمكن اعتباره جديدا ومبتكرا، جمعتها في النقاط التالية:
أولا: معرفة مقاصد القرآن : اشترط ابن عاشور على المجتهد في فهم واستنطاق النص القرآني واستكناه أحكامه وحكمه ليكون أهلا لنقلها تعليما للناس وفصلا في منازعاتهم وإرواء لغليلهم في الفتوى والسؤال أن يرقى مرقى سنيا يستشرف من خلاله مواطأة مراد الله ومطابقة قصده، إيمانا منه بأهمية إدراك مقاصد الشريعة في فهم وتوجيه التفسير والحكم والقضاء والفتيا وقد كان رحمه الله فارسا في ميدان المقاصد وألف فيها كتابا وسمه بـ”مقاصد الشريعة الإسلامية”، على خطى سلفه في هذا: الإمام الشاطبي حين قال: “فإذا بلغ الإنسان مبلغا، فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي r في التعليم والفتيا، والحكم بما أراد الله.”[27]
وعدّ ابن عاشور – وهو يخاطب قارئيه – معرفة المقاصد ميزانا لمن يتطلع إلى” الإفصاح عن غاية المفسر من التفسير ، وعن معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبيانها حتى تستبين لكم غاية المفسرين من التفسير على اختلاف طرائقهم ، وحتى تعلموا عند مطالعة التفاسير مقادير اتصال ما تشتمل عليه ، بالغاية التي يرمي إليها المفسر ، فتزنوا بذلك مقدار ما أوفى به من المقصد ، ومقدار ما تجاوزه ، ثم ينعطف القول إلى التفرقة بين من يفسر القرآن بما يخرج عن الأغراض المرادة منه ، وبين من يفصل معانيه تفصيلا ، ثم ينعطف القول إلى نموذج مما استخرجه العلماء من مستنبطات القرآن في كثير من العلوم .”[28]
ولا يحملن نزول القرآن بلسان عربي البعضَ على اعتباره قاصرا على العرب مكانا وزمانا بل إن مقاصده وقيمه ومثله العليا تؤهله إلى صلوحيته لكل زمان ومكان، وهنا اجتهد ابن عاشور في استقصاء هذه المقاصد حتى حصرها بحسب وسعه، فقال رحمه الله: ” أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها فلنلم بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي ثمانية أمور :
1- إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح. وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق، لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهما.
2- تهذيب الأخلاق قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ سورة القلم:4، وفسرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه r فقالت: « كان خلقه القرآن».
3- التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ سورة النساء:105، ولقد جمع القرآن جميع الأحكام جمعا كليا في الغالب، وجزئيا في المهم.
4- سياسة الأمة والقصد منه صلاح أحوال الأمة وحفظ نظامها بقوله: ﴿وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ سورة الأنفال:46، وقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ سورة الشورى:38.
5- القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، وللتحذير من مساويهم، قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القُرآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ﴾ سورة يوسف:3.
6- التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها، وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار، وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضالين وفي دعوته إلى النظر ، ثم نوه بشأن الحكمة فقال: ﴿يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴾ سورة البقرة:269.
7- المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، ترغيبا وترهيبا.
8- الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول r.
فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن ، أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم ، أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى ، مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء ، أو لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل ، فلا جرم كان رائد المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله ، ويعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ ، وللتنزيل اصطلاح وعادات…”[29]
ثانيا: معرفة لسان العرب ومعهودهم في التخاطب: اشترط ابن عاشور إلى جانب غيره من والمفسرين[30]والأصوليين والنحاة[31] الرسوخ في معرفة اللغة العربية باعتبارها مرقاة – كما وصفها الغزالي- للوصول إلى مراد الله، “فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريّانا من النحو واللغة”[32]، “وقد اختار الله تعالى أن يكون اللسان العربي مظهرا لوحيه، ومستودعا لمراده، وأن يكون العرب هم المتلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمها : منها كون لسانهم أفصح الألسن وأسهلها انتشارا ، وأكثرها تحملا للمعاني مع إيجاز لفظه ، ولتكون الأمة المتلقية للتشريع والناشرة له أمة قد سلمت من أفن الرأي عند المجادلة ، ولم تقعد بها عن النهوض أغلال التكالب على الرفاهية ، ولا عن تلقي الكمال الحقيقي.”[33]
“إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم، لمن ليس بعربي بالسليقة، ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي: متن اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان.
ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم ، ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين ، قال في الكشاف : ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها ، وما وقع به التحدي سليما من القادح ، فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل ، ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية، وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم علم دلائل الإعجاز، قال في الكشاف: “علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن برز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق ، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علما البيان والمعاني.”[34]
فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، إلى حد جعل الناظر يزيد فهمه في الدين طردا وعكسا بقدر تحققه باللسان العربي، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية، فهو مبتدئ في فهم الشريعة أو متوسطا فمتوسط في فهم الشريعة، “فالحاصل أنه لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب.”[35]
لكن هذا الأمر إذا فهم على غير قصده ولم يستو على سوقه مغالاة وتجافيا، قد يدفع بعض الأصوليين إلى اعتبار الشريعة أمية كما جنح إلى ذلك الشاطبي، وكما فعل ابن تيمية إذ قصر فهم القرآن على السلف فقط، لا مدخل لغيرهم فيه، فيكونوا بذلك قد حجروا واسعا وضيقوا رحبا وفي ذلك “تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد”[36]، مما جعل ابن عاشور ينبري إلى رد هذه الشبهة من ستة وجوه :
الأول: أن ما بنوه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهذا باطل لما قدمناه، قال تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءُ الغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾.
الثاني: أن القرآن معجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس في عصور انتشار العلوم في الأمة.
الثالث: أن القرآن لا تنقضي عجائبه. والعجيب أن ابن تيمية استشهد بهذا الأثر في مقدمته (ص43).
الرابع: أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار المتكاثرة.
الخامس: أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوما لديهم فما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وتحجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
السادس: أن السلف قد بينوا وفصلوا في علوم عُنُوا بها، ولا يمنعنا ذلك أن نقّفى على آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية، حيث عدّ لبيان علاقة العلوم بالقرآن حسب رأيه في أربع مراتب:
الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم، وتهذيب الأخلاق والفقه والتشريع والاعتقاد وأصول العربية والبلاغة.
الثانية: علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيأة وخواص المخلوقات.
الثالثة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق.
الرابعة: علوم لا علاقة لها به إما لبطلانها كالزجر والعيافة والميثيولوجيا، وإما لأنها لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافي.
ثالثا: مراعاة التكامل بين ظاهر النص وباطنه: من الجوانب المهمة التي عالجها ابن عاشور في قضية الظاهر والباطن تحديد طبيعة العلاقة الواجب قيامها بين الظاهر والباطن، لأنه وجد هذه العلاقة عند الباطنية علاقة تعارض وتدابر، فقرر أن العلاقة الشرعية اللازمة بينهما هي علاقة تكامل وتعاضد، وقد ناقش أقوال من أبطل التأويل، من المتوقفين عند حدود ما يقوله اللفظ، الرافضين صرف معناه إلى غير ما يدل عليه ظاهريا ولو بدليل (الاتجاه الظاهري)، مبينا خطورة هذا الاتجاه على معرفة مقاصد الشريعة وعدم صلاحيتها لمواكبة ما استجد في كل عصر ومصر، وأقوال الذين يدعون أن مقصد الشارع ليس في ظواهر النصوص ولا يفهم منها، وإنما المقصود أمر آخر وراءه، ويطرد هذا في جميع الشريعة، حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشريعة (الاتجاه الباطني) محذرا من هذا المسلك أيضا. وقد خلص إلى أن التأمين الأمثل لتأويل النص الشرعي عموما والنص القرآني خصوصا للقول بالباطن، “وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربية، ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل، ولا يكون تكلفا بينا ولا خروجا عن المعنى الأصلي حتى لا يكون في ذلك كتفاسير الباطنية.”[37]
رابعا: في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها: يثرب ابن عاشور على من يسوّون بين ألفاظ القرآن ومعانيه، معتبرا ذلك لا يليق ببلغاء الناس بله برب الناس الحكيم العليم، “فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاني من المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم . وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقا بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ، في أقل ما يمكن من المقدار ، بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها التي هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات، ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جميع نواحي الهدى ، فمعتاد البلغاء إيداع المتكلم معنى يدعوه إليه غرض كلامه وترك غيره، والقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج السامعون إلى علمه وكل ما له حظ في البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة في البلاغة إذا كان المعنى الأعلى مقصودا وكان ما هو أدنى منه مرادا معه لا مرادا دونه سواء كانت دلالة التركيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ حد التأويل.”[38]
وطرق المفسر للقرآن كما يراها ابن عاشور ثلاث:
1- “إما الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب – وهذا هو الأصل- مع بيانه وإيضاحه.
2-وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام ولا يجافيها الاستعمال، وهي من خصائص اللغة العربية، ككون التأكيد يدل على إنكار المخاطب أو تردده. كما أن يفسر ما حكاه الله تعالى في قصة موسى مع الخضر بكثير من آداب المعلم والمتعلم كما فعل الغزالي في كتاب الإحياء.
3-وإما أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى، أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم، أو لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه لا على أنها مما هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع. كما يفسر أحد قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ فيذكر تقسيم علوم الحكمة ومنافعها مدخلا ذلك تحت قوله: ﴿خَيْرًا كَثِيرًا ﴾. كذلك أن نأخذ من قوله تعالى: ﴿كَيْلاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ سورة الحشر: 7 تفاصيل من علم الاقتصاد السياسي وتوزيع الثروة العامة على أن ذلك تومئ إليه الآية إيماء. وشرط كون ذلك مقبولا أن يسلك فيه مسلك الإيجاز فلا يجلب إلا الخلاصة من ذلك العلم ولا يصير الاستطراد كالغرض المقصود له.
وللعلماء في سلوك هذه الطريقة الثالثة على الإجمال آراء: فأما جماعة منهم فيرون من الحسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلاتها وبين المعاني القرآنية، ويرون القرآن مشيرا إلى كثير منها.
ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبنى معانيه على فهم طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق، وكل ما كان من الحقيقة في علم من العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه.”[39]
خامسا: مراعاة السياق: يدعو ابن عاشور إلى اعتبار السياق بأنواعه والانتصار به ترجيحا وتغليبا عند تعارض الأفهام وتزاحم الآراء، فمثال اعتبار السياق اللغوي قوله:”… لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها ولكن نزلت في أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما بعدها ، فإن قبلها…”[40]، واعتبر السياق مانعا من التقول على الآيات والغلط فيها حيث قال: “فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن…إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها”[41] وفي غير اللغوي حاليا ومقاميا اشترط معرفة أسباب التنزيل الصحيحة[42]وأفرد لها المقدمة الخامسة كلها.”[43]
سادسا: تفسير النص لا استعماله والتسور عليه: سعى ابن عاشور إلى تأسيس نظرية للتفسير تدعو إلى استدرار كنوز النص واستكناه للمعاني المتعددة فيه وليس التسلط عليه بخلفيات إيديولوجية وتعصبات مِلّية تقويلا وافتراء، قال رحمه الله:” فلا نجاوز هذا المقام ما لم ننبهكم إلى حال طائفة التزمت تفسير القرآن بما يوافق هواها، وصرفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها بما سموه الباطن، وزعموا أن القرآن إنما نزل متضمنا لكنايات ورموز عن أغراض، وأصل هؤلاء طائفة من غلاة الشيعة، عرفوا عند أهل العلم بالباطنية فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم به، وهم يعرفون عند المؤرخين بالإسماعيلية لأنهم ينسبون مذهبهم إلى جعفر بن إسماعيل الصادق، ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه بالوصاية، ويرون أن لا بد للمسلمين من إمام هدى من آل البيت هو الذي يقيم الدين ، ويبين مراد الله.”[44]
وأكد التحذير من هذا المزلق في تفسير قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ يشير إلى ما اختلقه المشركون وأهل الضلال من رسوم العبادات ونسبة أشياء لدين الله ما أمر الله بها . وخصه بالعطف مع أنه بعض السوء والفحشاء لاشتماله على أكبر الكبائر وهو الشرك والافتراء على الله. ومفعول تعلمون محذوف وهو ضمير عائد إلى ما وهو رابط الصلة، ومعنى ما لا تعلمون: لا تعلمون أنه من عند الله بقرينة قوله على الله أي لا تعلمون أنه يرضيه ويأمر به، وطريق معرفة رضا الله وأمره هو الرجوع إلى الوحي وإلى ما يتفرع عنه من القياس وأدلة الشريعة المستقراة من أدلتها. ولذلك قال الأصوليون: يجوز للمجتهد أن يقول فيما أداه إليه اجتهاده بطريق القياس: إنه دين الله ولا يجوز أن يقول قاله الله.”[45]
سابعا: استمداد علم التفسير من علوم أخرى: حيث يتوقف المفسر المجتهد في استدرار معاني الآيات من ألفاظها وتراكيبها واقتناص فوائدها وحكمها على علوم وأدوات بدونها يكون صنيعه ضربا من المجازفة والعبث وربما التنطع والافتئات، “فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد، من المجموع الملتئم من علم العربية (وقد أتينا عليها سابقا) وعلم الآثار، ومن أخبار العرب، وأصول الفقه قيل وعلم الكلام وعلم القراءات”[46]:
-“أما الآثار: فالمعني بها، ما نقل عن النبي r، من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجمال، وذلك شيء قليل ، قال ابن عطية عن عائشة : ما كان رسول الله يفسر من القرآن إلا آيات معدودات علمه إياهن جبريل، قال معناه في مغيبات القرآن وتفسير مجمله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف، قلت: أو كان تفسيرا لا توقيف فيه.
وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى، إذ لا يكون إلا عن مستند كإجماعهم على أن المراد من الأخت – في آية الكلالة الأولى – هي الأخت للأم، وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة، وكذلك المعلومات بالضرورة كلها ككون الصلاة مرادا منها الهيئة المخصوصة دون الدعاء، والزكاة المال المخصوص المدفوع.
– وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها ، وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار على المعنى ، فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب، لأنها إن كانت مشهورة ، فلا جرم أنها تكون حجة لغوية ، وإن كانت شاذة ، فحجتها لا من حيث الرواية ، لأنها لا تكون صحيحة الرواية ، ولكن من حيث أن قارئها ما قرأ بها إلا استنادا لاستعمال عربي صحيح ، إذ لا يكون القارئ معتدا به إلا إذا عرفت سلامة عربيته.
– وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم. وإنما خصصتها بالذكر تنبيها لمن يتوهم أن الاشتغال بها من اللغو فهي يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في سوقها، لأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار.
– وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير ، ولكنهم يذكرون أحكام الأوامر والنواهي والعموم وهي من أصول الفقه ، فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير ، وذلك من جهتين…
واعلم أن استمداد علم التفسير، من هذه المواد، لا ينافي كونه رأس العلوم الإسلامية كما تقدم، لأن كونه رأس العلوم الإسلامية، معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال، فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية، فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه أتم من الإجمال.”[47]
عاشرا: عدم الاقتصار على التفسير بالمأثور وبيان صحة التفسير بالرأي: يستفتح ابن عاشور المقدمة الثالثة بشكل حواري مجيبا على سائل مفترض: “إن قلت : أتراك بما عددت من علوم التفسير تثبت أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يستند إلى مأثور عن النبي rولا عن أصحابه ، وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم حظا كافيا وذوقا ينفتح له بهما من معاني القرآن ما ينفتح عليه ، أن يفسر من آي القرآن بما لم يؤثر عن هؤلاء، فيفسر بمعان تقتضيها العلوم التي يستمد منها علم التفسير ، وكيف حال التحذير الواقع في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار . والحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي rقال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وكيف محمل ما روي من تحاشي بعض السلف عن التفسير بغير توقيف؟ فقد روي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن تفسير الأب في قوله وفاكهة وأبا فقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي. ويروى عن سعيد بن المسيب والشعبي إحجامهما عن ذلك، قلت: أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه، وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله. وهل يتحقق قول علمائنا إن القرآن لا تنقضي عجائبه إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات قليلة. وقد قالت عائشة : ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات معدودات علمه جبريل إياهن.”[48]
إذن، وعلى خلاف ما ذهب إليه ابن تيمية في الاستمساك بما أثر عن النبي r أو الصحابة أو التابعين من تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة التي جاءت مبينة لكتاب الله مصداقا لقوله تعالى :﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾، ينافح ابن عاشور عن التفسير بالرأي رادا عليهم بقوله: “أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا يعدو ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها ولم يضبطوا مرادهم من المأثور عمن يؤثر، فإن أرادوا به ما روي عن النبي rمن تفسير بعض آيات إن كان مرويا بسند مقبول من صحيح أو حسن، فإذا التزموا هذا الظن بهم فقد ضيقوا سعة معاني القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه، وناقضوا أنفسهم فيما دونوه من التفاسير، وغلطوا سلفهم فيما تأولوه، إذ لا ملجأ لهم من الاعتراف بأن أئمة المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن النبي r، وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات كثيرة، ولم يشترط عليهم أن يرووا له ما بلغهم في تفسيرها عن النبي r، وإن أرادوا بالمأثور ما روي عن النبي وعن الصحابة خاصة، وهو ما يظهر من صنيع السيوطي في تفسيره ” الدر المنثور”، لم يتسع ذلك المضيق إلا قليلا، ولم يغن عن أهل التفسير فتيلا، لأن أكثر الصحابة لا يؤثر عنهم في التفسير إلا شيء قليل سوى ما يروى عن علي بن أبي طالب على ما فيه من صحيح وضعيف وموضوع، وقد ثبت عنه أنه قال : ما عندي مما ليس في كتاب الله شيء إلا فهما يؤتيه الله.”[49]
خاتمة: معالم الوصل والفصل
بعد استعراضنا لأهم معالم الجهازين الـتفسيريين عند الرجلين العلمين الجهبذين رحمهما الله وأجزل لهما المثوبة، نبسط بإيجاز بعض ملامح المشاكلة والمشاكسة بينهما:
وأبدأ بالحيز المشترك بينهما:
1- إحالتهما على مقصد صاحب النص، فكلاهما يؤكد على ضرورة معرفة مقاصد المتكلم عز سلطانه حتى يتسنى للمفسر معرفة كلامه وحمله على أحسن المحامل وطرح كل ما يخدش في صفحة التنزيه والتقديس اللائق به تمجد وتبارك وخاصة فيما له علاقة بالمتشابهات.
2- كلاهما يعطي اهتماما بالغا للتفسير المأثور والمنقول نقلا صحيحا بعيدا عن الضعف أو الوضع، على تفاوت بينهما.
3- تأكيدهما معا على تفسير النص، لا التسلط عليه بالتقويل والافتئات تبعا للهوى والتعصب.
4- كلاهما يدعو إلى الضلاعة في العربية ومراعاة السياق لغويا وحاليا ومقاميا باعتبار أسباب النزول وأثرها في توجيه الفهم وترجيح الأقوال.
5- اهتمامها بمنهج الاستقراء وإفادته للقطع، فقد أستفاد هذا المنهج ابن عاشور من شيخ المقاصد الشاطبي وألف في ذلك مؤكدا عليه في كتابه “مقاصد الشريعة”، وكذلك الشأن عند ابن تيمية إذ يقول في مقدمته: “وجمع عبارات السلف في هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.”[50]
5- الاهتمام بالخطاب القرآني في كليته ورفض تعضيته باعتبار القرآن كالصورة الواحدة، كما ألمح لذلك ابن القصار المالكي: “فذلك كله كالآية الواحدة فلا يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه، وإذا لم يجز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر في الكلام المتصل إلى أن ينتهي، فننظر هل يتبعه استثناء أم لا؟”[51]
ومن نقط التباين بينهما:
1- اختلافهما في صحة التفسير بالرأي: ففي الوقت الذي لا يطمئن فيه ابن تيمية إلى التفسير بالاستدلال بالرأي بل يحرّم ما كان منه مجردا، يرى ابن عاشور أن الاقتصار على ما وصلنا من تفسير مأثور – وهو قليل – تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد والحكم على الشريعة تبعا بعدم صلاحيتها وأهليتها للحكم والتوجيه بين الناس في الأزمنة المتعاقبة والأمكنة المتعددة.
ولعل موقف ابن تيمية راجع إلى ما يشير إليه علماء النفس وعلماء الاجتماع إلى أن الظروف النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والسجالات العقدية والمذهبية التي ينشأ فيها الإنسان تؤثر على أفكاره وتوجه اختياراته، وهذا ظهر جليا في ابن تيمية فقد عاش في جو مشحون متوتر وسط صراعات فكرية ودينية بلغت حد إشهار السلاح واستئصال المخالف وتفشي البدع والمنكرات وتناسل الملل والنحل وكل يستند إلى القرآن بإعمال آلة التأويل ولي أعناق الآيات مما جعله يسعى إلى قطع الطريق عنهم بإبطال كل ما لم يؤثر عن القرون الثلاثة الأولى من السلف الصالح.
في حين عاش ابن عاشور في جو يطبعه التنافس العلمي والتقدم التكنولوجي وانتشار مد الإلحاد القادم من الغرب الذي يسخر من الدين ويزعم عدم أهليته لتسيير شؤون الدنيا ويرميه بالماضوية والجمود، فكان من الطبيعي أن ينبري ابن عاشور إلى بيان سعة القرآن الكريم ورحابة أفكاره وفيض معانيه وبالتالي عدم الاكتفاء بالمأثور.
2- إنكار المجاز من ابن تيمية وتبنيه من ابن عاشور: وهذا فرع عن النقطة السابقة فإن ابن تيمية يستهجن توظيف المجاز ويعتبره مبتدعا من القول لم يظهر باعتباره قسيما للحقيقة إلا بعد انصرام أجيال السلف الأولى، قال رحمه الله: “وبكل حالٍ فهذا التقسيمُ – أي تقسيمَ الألفاظ إلى حقيقةٍ ومجاز – هو اصطلاحٌ حادثٌ بعدَ انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلَّم به أحدٌ مِن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانٍ، ولا أحدٌ مِن الأئمة المشهورين في العِلم، كمالكٍ والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلَّم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.”[52]، في حين ينوه ابن عاشور بتوظيف المجاز ويثرب على من يتعاطى التفسير وهو في علمي المعاني والبديع راجل، واستظهر بكلام عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، في آخر فصل المجاز الحكمي: “ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم، أن يتوهموا ألباب الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها أي على الحقيقة ، فيفسدوا المعنى بذلك ، ويبطلوا الغرض ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغة وبمكان الشرف، وناهيك بهم إذا أخذوا في ذكر الوجوه ، وجعلوا يكثرون في غير طائل ، هنالك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه ، وزند ضلالة قد قدحوا به.”[53]
3- إذا كان النص القرآني لا يحمل إلا معنى واحدا – أو معان قليلة محصورة – بما هو مأثور عن السلف الصالح لا يستحب الاستزادة على ذلك خشية الوقوع في المحذور المحظور، فإن التفسير عند ابن عاشور من حيث وفرة المعاني وغزارتها وسط بين حدّي العدمية والفوضوية، بين الظاهرية والباطنية، معين لا ينضب ولا يشبع منه، فمن حصره فإنما ضيّق من سعة رحمة الله و وقتّر من بحر علمه سبحانه وقزّم من فيض نواله وكرمه، وقد أعجبتني مقالة السيميائي المغربي سعيد بنكراد في هذا الصدد إذ يقول: “إنّ التعدد الدلالي الذي يحكم تعيين العالم هو القاعدة، أمّا وحدانية المعنى فاستثناء عرضي، أو إحالة على أكثر المناطق ضحالة في الذات الإنسانية، أو على وجود موحش يشكو من خصاص في الدفء الإنساني.”[54]
4- اهتمام ابن عاشور بالجديد وعدم التصاقه فقط بالقديم (المأثور) حتى أنه أفرد المقدمة العاشرة للحديث عن مبتكرات القرآن ويرى في كل معنى مبتكرا – تقبله الآية ومقاصد القرآن واللفظ العربي – فتحا ونصرا، بخلاف ابن تيمية الذي يتوجس خيفة من كل جديد.
هذا ما جاد به الكريم الوهاب في عقد المقارنة بين زوج من أساطين العلم ورجالاته العظام، أجدني متصاغرا أجثو على الركب وأنا أفتش في ملفاتهما العلمية طالبا العذر منهما فيما بدا من التقصير أو التسور على حماهما مستمنحا المولى عزو جل المغفرة والرضوان. والصلاة والسلام على خير الأنام والحمد لله رب العالمين.
لائحة المصادر والمراجع
– ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، تحقيق محمود محمد محمود نصار، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، طبعة 1988.
– ابن تيمية، أحمد، كتاب الإيمان ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط5، سنة 1996م
– ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، بدون تاريخ.
– ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط1، 1998م.
– الطبري، ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المعارف، ط بدون تاريخ.
– الحنفي، صدر الدين محمد، شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة السادسة،1400هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
– الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات تحقيق عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، سنة 2004م.
– الجويني، عبد الملك، البرهان في أصول الفقه، ، كلية الشريعة، جامعة قطر، ط1، 1399هـ.
ــــ ابن القصار البغدادي المالكي، علي بن عمر، مقدمة في أصول الفقه ، تحقيق مصطفى مخدوم، دار المعلمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1999م.
– صوصي، مولاي عمر، “أسباب النزول وأثرها في توجيه التفسير”، مطبعة رحاب، الدار البيضاء، ط1، 2017م.
– بنكراد، سعيد ، مقال محكم بعنوان: السميائيات وتأويل النص الديني، موقع مؤمنون بلا حدود، بتاريخ 16 مارس 2016.
لتحميل جميع أعداد (مجلة المرقاة المحكمة) بنسخة Word + pdf :
https://drive.google.com/drive/folders/1ZDoZNZFySzrdmILoMtn-pZ0no9Lbh7VU?usp=sharing
[1]. ابن القصار البغدادي المالكي، علي بن عمر، مقدمة في أصول الفقه، تحقيق مصطفى مخدوم، دار المعلمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1999م، ص 134.
[2] ـ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط1، 1998م، ص150.
[3] – هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني (661 هـ – 728هـ/1263م – 1328م) المشهور باسم ابن تيمية. هو فقيه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد منتسب إلى المذهب الحنبلي. وهو أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الثاني من القرن السابع والثلث الأول من القرن الثامن الهجري. نشأ ابن تيمية حنبلي المذهب وأخذ الفقه الحنبلي وأصوله عن أبيه وجده، كما كان من الأئمة المجتهدة في المذهب، فقد أفتى في العديد من المسائل على خلاف معتمد الحنابلة لما يراه موافقًا للدليل من الكتاب والسُنة ثم على آراء الصحابة وآثار السلف. توفي ابن تيمية في 20 ذو القعدة/22 ذو القعدة سنة 728 هـ في حبسه في قلعة دمشق وقد بلغ من العمر 67 سنة.
[4] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، تحقيق محمود محمد محمود نصار، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، طبعة 1988، ص 43.
[5] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص68.
[6] – المرجع السابق، ص43.
[7] – المرجع السابق، ص68.
[8] – قلتُ: وهذا الصنف من التفسير ليس بالهين بل يحتاج من صاحبه إلى دربة ومران، وسأجلي الصعوبة بأمثلة: أبدأ بمثال واضح وهو قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[يونس:62]، مفهوم الولاية نأخذه من لاحق الآية وهو قوله: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾[يونس:63].
[9] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص93.
[10] – المرجع السابق، ص95.
[11] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص93 و94.
[12] – المرجع السابق، ص70.
[13] – المرجع السابق، ص72.
[14] – المرجع السابق، ص73.
[15] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص77.
[16] – المرجع السابق، ص81.
[17] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص96.
[18] – صحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، رقم الحديث: 533.
[19] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص100.
[20] – المرجع السابق، ص83.
[21] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص85.
[22] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص87.
[23] – المرجع السابق، ص91.
[24] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص107.
[25] – الحنفي، صدر الدين محمد، شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة السادسة،1400هـ، المكتب الإسلامي، بيروت. ص204.
[26] – ابن عاشور هو: العلامة المفسر محمد الطَّاهر بن محمد بن محمد الطَّاهر بن عاشور، ولد في تونس سنة (1296) هـ ، الموافق (1879) م، وهو من أسرة علمية عريقة، برز في عدد من العلوم ونبغ فيها ، كعلم الشريعة واللغة والأدب، وكان متقنا للُّغة الفرنسية ، وعضواَ مراسَلاً في مجمع اللغة العربية في دمشق والقاهرة ، تولى مناصب علمية وإدارية بارزة كالتدريس، والقضاء، والإفتاء، وتم تعيينه شيخاً لجامع الزيتونة .ألف عشرات الكتب في التفسي، والحديث، والأصول، واللغة، وغيرها من العلو، منها تفسيره المسمَّى : ” التحرير والتنوير”، و” مقاصد الشريعة “، و” كشف المغطا من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ “، و” النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح “، وغيرها من الكتب النافعة، وتوفي في تونس سنة (1394) هـ ، الموافق (1973) م، عن عمر يناهز الـ (98) عاماً .
[27] – الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة مصر، بدون تاريخ، ج5، ص43.
[28] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، بدون تاريخ، ج1، ص 18.
[29] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 39 إلى 42 بتصرف حذف.
[30] – قال شيخ المفسرين “الطبري” مستندا إلى كلام العرب في بيان معنى الاستواء مثلا: “الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: …” (جامع البيان، ج1، ص276ـ277.)
[31] – استظهر ابن جني لترجيح مذهبه بكلام العرب، فقال: “إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه، ولم تقسه في غيره، وذلك نحو قول الله تعالى: ﴿استحوذ عليهم الشيطان﴾، فهذا ليس بقياس لكنه لا بد من قبوله، لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم. ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره، ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم، ولا في استباع: استبيع.”(الخصائص لابن جني: تعارض السماع والقياس: باب في تعارض السماع والقياس)
[32] – الجويني، عبد المالك، البرهان في أصول الفقه، كلية الشريعة، جامعة قطر، ط1، 1399هـ، ج1، ص 169.
[33] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص39.
[34] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 18و19.
[35] – المرجع السابق، ج5، ص 57.
[36] – المرجع السابق، ج1، ص7.
[37] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص44.
[38] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 93.
[39] – المرجع السابق، ج1، 42
[40] – المرجع السابق، ج1، ص49.
[41] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص97.
[42] – ينظر كتابي “أسباب النزول وأثرها في توجيه التفسير” للتوسع، مطبعة رحاب، الدار البيضاء، ط1، 2017م.
[43] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص من 46 إلى 50.
[44] – المرجع السابق، ج1، ص33.
[45] – المرجع السابق، ج2، ص 105.
[46] – المرجع السابق، ج1، ص18.
[47] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص27.
[48] – ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص28.
[49] – المرجع السابق، ج1، ص32.
[50] – ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص 66.
[51] ــــ ابن القصار المالكي مقدمة في أصول الفقه، ط1، 1999م، ص199ــ 200.
[52] – ابن تيمية، أحمد، كتاب الإيمان، المكتب الإسلامي، بيروت، ط5، سنة 1996م، ص73
[53] – ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، ج1، ص 20.
[54] – بنكراد، سعيد ، مقال محكم بعنوان: السميائيات وتأويل النص الديني، موقع مؤمنون بلا حدود، بتاريخ 16 مارس 2016.