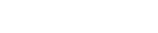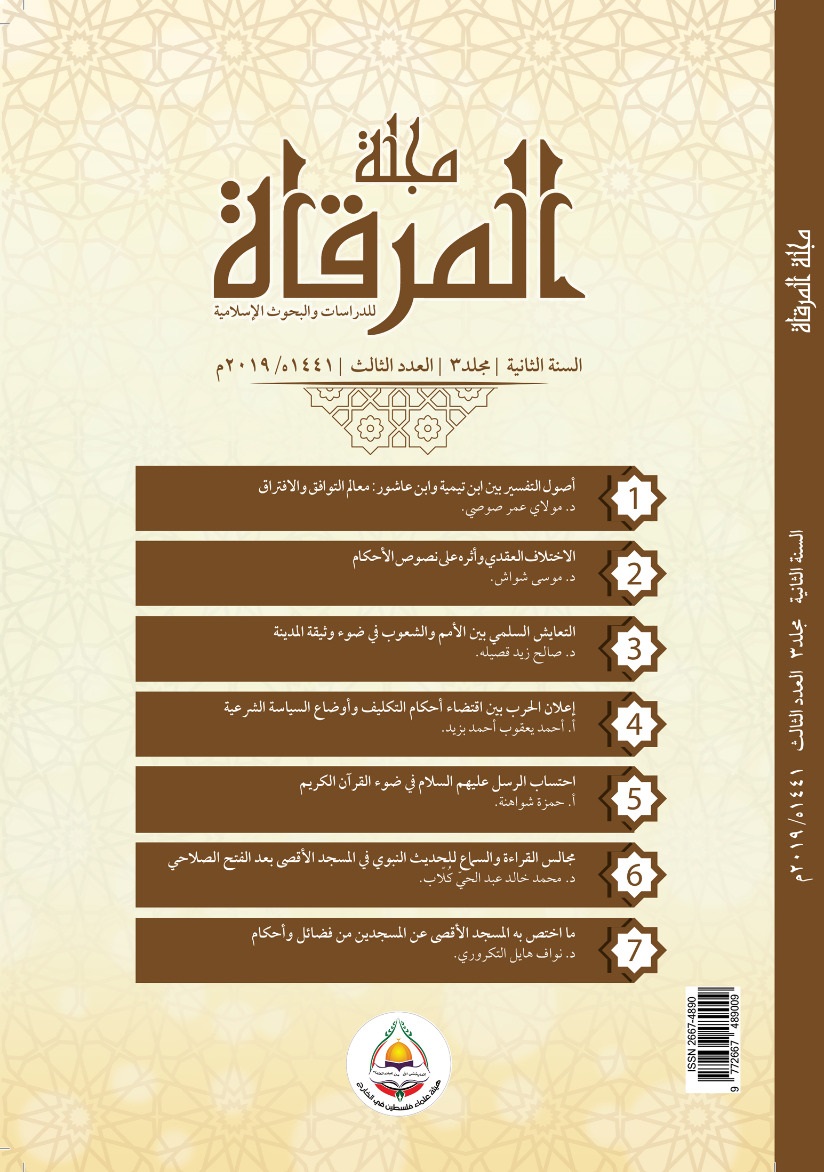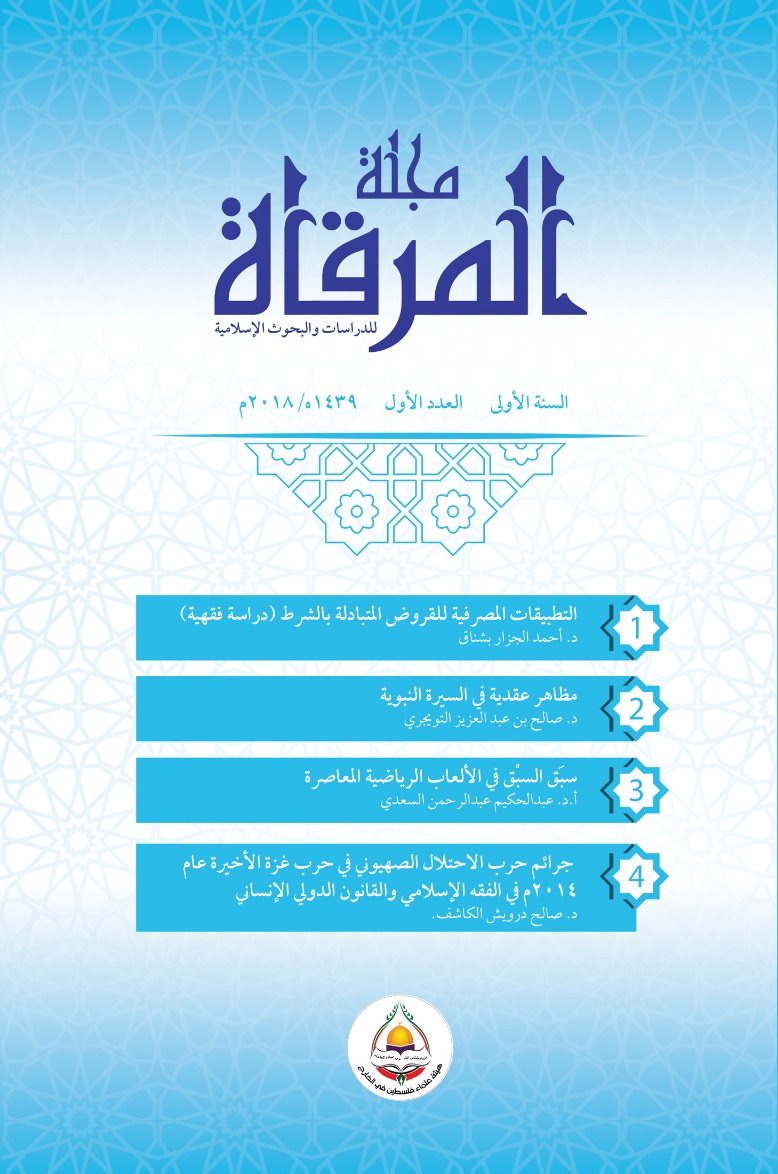خاص هيئة علماء فلسطين
“دراسة فقهية”
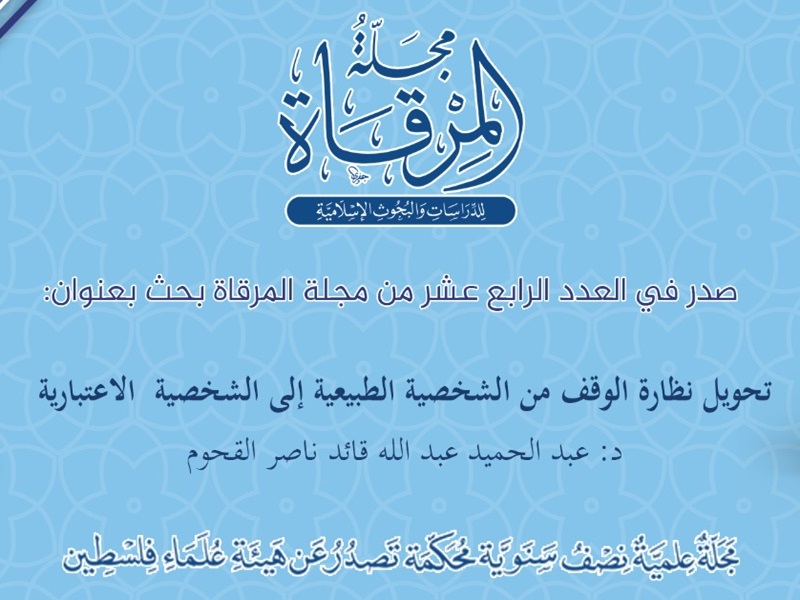
د. عبد الحميد عبد الله قائد ناصر القحوم[1]
الملخص
يسعى البحث إلى تأصيل مشروعية انتقال إدارة الوقف والتصرف فيها من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية مراعاة للمصلحة في ظل تطورات وسائل الإدارة، أو الوصاية أو الكفالة، أو غيرها من الأحكام المستندة إلى العرف، ويقترح حلولا شرعية لبعض المشاكل المتعلقة بنظارة الوقف، حسب ما تقتضيه مصلحة الوقف، ويكشف عن أهمية الشخصية الاعتبارية لإدارة الأوقاف وأنها بديل ناجح، ويبيّن شروط تحويل نظارة الأوقاف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية والحكمة منها، وختم البحث بأهم النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الوقف – نظارة الوقف – الشخصية الطبيعية – الشخصية الاعتبارية
Abstract
This research seeks to establish the legitimacy of transferring the management and disposal of endowments from a natural entity to a legal entity, taking into account the public interest in light of developments in management methods, guardianship, sponsorship, or other customary rulings. It proposes legal solutions to some problems related to endowment management, as required by the endowment’s interests. It reveals the importance of legal personality for endowment management and its potential as a successful alternative. It also clarifies the conditions for transferring endowment management from a natural entity to a legal entity and the rationale behind it. The research concludes with the most important findings and recommendations.
Keywords: Endowment – Endowment Management – Natural Personality – Legal Personality
مقدمة
الحمدُ لله الوليّ فلا وليَّ من دونه ولا واق، الغني فلا تنفد خزائنه على كثرة الإنفاق، يحلم على من عصى وينتقم بما لا يحصى ولا يكلف ما لا يطاق، أحمده وله الحمد وحده على الاستحقاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من ذاق طعم الإيمان فوجده حلو المذاق، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ففتح به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً وآذاناً صمًا ليس للحق إليها استطراق، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بالعشيّ والإشراق وسلم تسليمًا:
أما بعد: يُعدّ الوقف معلمًا بارزًا من معالم الدين الإسلامي، ورافدًا من روافد البذل والإنفاق، وأثره جلي في تلاحم الأمة، وسد النقص أو الخلل في الحياة الاجتماعية، فكان درعًا متينًا يحافظ على هويّة الأمة، ومانعًا من الانحراف، وذلك بإقامة المشاريع الدعوية والتعلمية، أو تقديم المرافق الخدمية كدور الأيتام، ومراكز التأهيل، فظهر في أجمل صورة للتكافل الإنساني الذي اختصت به هذه الأمة.
ولا ريب أن الوقف كغيره يحتاج إلى رعاية وتعهد، بالإنماء والاستثمار، ليدوم نفعه، ويحصل مقصوده، فجعلت الرعاية له من النُّظّار أمرًا في غاية الأهمية؛ لما يترتب عليها من آثار شرعية ونظامية، فتنضبط التصرفات فيه، أو الالتزامات تجاهه؛ لذا فإن من الضرورة ضبط أمر النظارة فيه سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية، بل إن الضبط في الشخصية الاعتبارية لعين الوقف وريعه أكثر من الطبيعية، مما جعل من الضرورة دراسة تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الاعتبارية، لا سيما مع فساد الزمان، وتعرض الأوقاف للتلاعب؛ لبيان حكمها الوضعي، مع بيان الحكم والمآلات من تحويلها، في بحث أسميته: “تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية، دراسة فقهية”، فالله نسأل التوفيق والسداد.
أهمية الموضوع: تتمثل الأهمية العلمية لهذا الموضوع فيما يلي:
1- الإسهام في توفير دراسة شرعية تتعلق بالتصرف بإدارة الوقف حسب المصلحة، وخصوصًا في عصر تطورت فيه وسائل الإدارة، أو الوصاية أو الكفالة، أو غيرها من الأحكام المستندة إلى العرف.
2- إيجاد حل شرعي للكثير من المشاكل المتعلقة بنظارة الوقف، حسب ما تقتضيه مصلحة الوقف، بحمايته واستمراره، واستثماره.
3- ضرورة دراسة صلاحية الشخصية الاعتبارية لإدارة الأوقاف لكونها أمراً مهماً نتيجة للتقدم والتطور العلمي والإداري والصناعي والتجاري، وأنها بديل في التعامل عن الشخصية الطبيعية.
أسباب اختيار الموضوع: تتمثل أسباب اختيار الموضوع بما يلي:
1- إن الموضوع لم يحظَ بدراسة فقهية توضح أحكامه وتبين شروطه، ومآلاته، فكان سببًا لجمعها ولمّ شتاتها من كتب الفقهاء.
2- الإسهام في بيان أن الأحكام المتعلقة بالأوقاف متعلقة بالمصلحة، فما كان فيه مصلحة للوقف والموقوف عليهم، دعت إليه الشريعة، وما كان فيه مفسدة تركته الشريعة، فارتباط الأحكام الوضعية للأوقاف بالمصلحة وجودًا وعدمًا.
مشكلة الدراسة: تكمن إشكالية الدراسة فيما يلي:
1- ما الفرق بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في نظارة الوقف؟
2- ما الحكم الوضعي لتحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية؟
3- ما شروط تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية؟
4- ما الحكمة من تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية؟
الدراسات السابقة: حسب ما اطلعت عليه من الكتب وكذلك ما بحثت في الشبكة العنكبوتية، لم أجد من البحوث أو الرسائل العلمية من قام بدراسة موضوع (تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية، دراسة فقهية)، دارسة خاصة مستقلة، أما ما وجدته من مواضيع وأبحاث علمية ورسائل جامعية فقد تناولت جوانب من الدراسة، أوردها مرتبة حسب تاريخ النشر، وهي كما يلي:
الدراسة الأولى: الشخصية الحكمية للوقف، عبد الرحمن بن معلا اللويحق، شبكة الألوكة، الطبعة بدون، والتاريخ بدون.
هدفت الدراسة: إلى بيان معنى الشخصية الحكمية للوقف، وحالة الشخصية الحكمية للوقف، والعلاقة بين الوقف والشخصية الحكمية، وهي تختلف عن دراستي التي هي تحويل النظارة للوقف من الشخصية الطبيعية إلى الاعتبارية.
الدراسة الثانية: الشخصية الاعتبارية للوقف، وأثرها في حمايته، الخيرو عبد القادر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد (02)، عام: (2012م).
هدفت الدراسة: إلى دراسة الشخصية الاعتبارية للوقف ببيان تعريفها، وتحديد نطاقها، ثم الطبيعية القانونية للشخصية المعنوية، وأثرها في توفير الحماية للوقف، وهي تختلف عن تحويل نظارة الوقف من شخصية طبيعية إلى اعتبارية.
الدراسة الثالثة: إسهامات الوقف في التنمية بالنظر إلى الشخصية الاعتبارية، قاشي علال، مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحيى فارس المدية، المجلد: (03)، العدد: (01)، سنة: (2019م).
هدفت الدراسة: إلى بيان أن الوقف ذو شخصية اعتبارية أصلاً، فقد بيّن ذلك من الناحية الفقهية والقانونية، وهي تختلف عن دراستي التي مضمونها تحويل النظارة للوقف من الشخصية الطبيعية على الاعتبارية.
الدراسة الرابعة: تدخل القضاء في تصرفات ناظر الوقف، عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر اليمني، مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، الرياض، الطبعة الأولى، 2020م.
هدفت الدراسة: إلى بيان معنى الوقف، والناظر، والقضاء، والقضايا الفقهية المتعلقة بوظائف النظار، وتعيين الناظر وعزله، وهذه الدراسة تختلف عن دراستي المختصة بتحويل النظارة من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية.
فمما سبق يتبين أن اختلاف الدراسات السابقة عن دراستي المتخصصة بمسألة تحويل النظارة من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية جعل هذا الموضوع محل اهتمام ودراسة.
منهج الدراسة: اقتضت دراسة هذا الموضوع الاعتماد على المنهج الاستقرائي الوصفي، وذلك باستقراء وتتبع جزئيات المسألة، بالدراسة والتحليل لوظيفة الناظر وما أوجه الاتفاق أو الافتراق بين نظارة الشخصية الطبيعية والاعتبارية، وما حكم تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية، ما شروطها، والحكمة منها، فسلك الباحث في هذا الموضوع المنهجية الآتية:
1- جمع الدراسة من مظانها عن طريق الاستقراء.
2- إيراد ما يمكن أن يكون دليلًا يستند عليه لتحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية.
3- التركيز على موضوع البحث بإيراد أهم مسائله من غير استطراد.
4- العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص لنصوص العلماء.
تضمين الخاتمة أهم النتائج، التي توصل إليها الباحث.
خطة الدراسة: تتكون هذه الدراسة من مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة، وذلك حسب الخطة الآتية:
فالمقدمة فيها أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته.
المبحث التمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث.
المبحث الأول: مفهوم الشخصية الطبيعية والاعتبارية وأهم الفروق بينهما.
المبحث الثاني: نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية.
المبحث الثالث: حكم تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية.
المبحث الرابع: شروط تحويل نظارة الأوقاف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية والحكمة منها.
وخاتمة، فيها أهم النتائج والتوصيات.
المبحث التمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث
المطلب الأول: تعريف التحويل في اللغة وفي الاصطلاح.
تعريف التحويل في اللغة: قال ابن فارس ¬: “الحاء والواو واللام أصل واحد، وهو تحرك في دور”[2]، ومنه الحول أي العام لأنه يحول أي يدور، فحَوّل الشيء نقله من موضع إلى آخر، أو نقله من شيء إلى آخر، فالتحويل يراد به هنا التحريك بالنقل من مكان واثباته في آخر[3].
تعريف التحويل في الاصطلاح: لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي، فالتحويل: عبارة عن تبديل ذات إلى ذات أخرى[4] مثل تحويل التراب إلى الطين.
المطلب الثاني: تعريف النِّظَارة في اللغة وفي الاصطلاح.
تعريف النِّظَارة في اللغة: هي الفراسة والحذق وهي حرفة النَّاظر[5]، والناظر هو المتولي إدارة أمر، فيقال ناظر المدرسة، وناظر الضيعة، وكان يطلق على الوزير فيقال ناظر المعارف ونحوه، وجمعه نظار[6].
تعريف النِّظَارة في الاصطلاح: هي إدارة محلية تشرف على الأوقاف[7].
أو أنها: الولاية على الوقف بما يحقق الحظ فيه، من حفظه، وحفظ ريعه، وتنفيذ شرط واقفه[8].
المطلب الثالث: تعريف الوقف في اللغة وفي الاصطلاح.
تعريف الوقف في اللغة: قال ابن فارس: “وقف: أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه”[9]، فالوقف يطلق ويراد به إما الحبس، أو المنع، فأما الحبس مصدر من قولك: وقفت الشيء وقفًا، أي حبسته. ومنه وقفت الأرض أو الدابة أي جعلتها محبوسة على ما وقفت عليه ليس لأحد تغييرها ولا التصرف فيها، وأما بمعنى المنع؛ فلأن الواقف يمنع التصرف في الموقوف؛ فإن مقتضى المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلاف الإعطاء[10].
تعريف الوقف في الاصطلاح: عرف الحنفية الوقف بأنه: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة[11].
وعرفه المالكية بأنه: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا[12].
وعرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود[13].
وعرفه الحنابلة بأنه: تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة[14]، أو هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر، ولسبيل المنفعة تقربًا إلى الله تعالى[15].
المطلب الرابع: تعريف الشخصية في اللغة وفي الاصطلاح.
تعريف الشخصية في اللغة: قال ابن فارس رحمه الله: “الشين والخاء والصاد أصل واحد يدل على ارتفاع في شيء. من ذلك الشخص، وهو سواد الإنسان إذا سما لك من بعد”[16]، ومنه الشخصية: وهي صفات تميز الشخص من غيره، ويقال فلان ذو شخصية قوية ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل[17].
تعريف الشخصية في الاصطلاح: الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات[18].
المطلب الخامس: تعريف الطبيعية في اللغة وفي الاصطلاح.
تعريف الطبيعية في اللغة: قال ابن فارس رحمه الله: “الطاء والباء والعين أصل صحيح، وهو مثل على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندها، يقال: طبعت على الشيء طابعًا. ثم يقال على هذا: طبع الإنسان وسجيته”[19]، فيكون معنى الطبيعية هنا هي السجية التي جبل عليها الإنسان[20]، أو ما يُولد مع الإنسان من صفات، وعلى ما هو مجبول عليه[21].
تعريف الطبيعية في الاصطلاح: لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي فالطبيعية هي: سلوك مكتسب أو موروث يميّز فردًا عن آخر[22]، أو هي محاكة الطَّبيعة من غير تكلُّف ولا تصنُّع[23].
المطلب السادس: تعريف الاعتبارية في اللغة وفي الاصطلاح.
تعريف الاعتبارية في اللغة: قال ابن فارس: “العين والباء والراء أصل صحيح واحد يدل على النفوذ والمضي في الشيء”[24]، ومنه العابر: الناظر في الشيء، والمعتبر: المستدل بالشيء على الشيء[25].
تعريف الاعتبارية في الاصطلاح: هي التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرًا[26].
المبحث الأول: مفهوم الشخصية الطبيعية والاعتبارية وأهم الفروق بينهما
المطلب الأول: مفهوم الشخصية الطبيعية والاعتبارية.
الشخصية الطبيعية: هي مجموعة من الأوصاف التي إذا توفرت في شخص جعلته صالحًا لإثبات الالتزامات سواء كانت حقوقًا أو واجبات، وتبدأ بولادة الإنسان، فإن ولد ميتًا فلا تثبت له هذه الشخصية، وتنقضي بزوال الحياة[27].
الشخصية الاعتبارية: هي صلاحية كائن جماعي لثبوت الالتزامات سواء أكانت له أم عليه، أو هي صفة يمنحها التشريع لمجموع من الأشخاص أو الأموال قامت لغرض معين، بمقتضاه يكون أهلا لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق[28].
أو هو وصف يقوم بالشركة، أو المؤسسة، يجعلها أهلاً للإلزام والالتزام في الحقوق والواجبات المالية[29].
المطلب الثاني: أنواع الشخصية الاعتبارية.
تتنوع الشخصية الاعتبارية حسب أنشطتها إلى نوعين:
الأول: الشخصية الاعتبارية العامة: وهي الهيئات العامة كمؤسسات الدولة ومرافقها العامة، كالجامعات والمستشفيات، مما هو عام.
الثاني: الشخصية الاعتبارية الخاصة: وهي الهيئات التي تتكون من أفراد لتحقيق غرض خاص سواءً اقتصر نفعه على الأفراد الذين كوَّنوها، أو كان نفها عامًا، كالجمعيات الخيرية، أو الشركات التجارية[30].
المطلب الثالث: الفرق بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية.
تفترق الشخصية الطبيعية عن الاعتبارية بأمور، من أهمها: [31]
- تتوقف الشخصية الاعتبارية على إقرار نظام، بخلاف الطبيعية التي تقوم على وجود حسي لشخص ما.
- عدم موت الشخصية الاعتبارية كالطبيعية بل من سماتها الدوام، فلا تزول بزوال الشخص الممثل لها، بخلاف الشخصية الطبيعية.
- الأهلية في الشخصية الاعتبارية محددة ومقيدة بالنظام، بخلاف الطبيعية التي هي مطلقة ولا تنقص إلا بعوارض الأهلية سواء كانت سماوية أو مكتسبة.
- تَنْحَلُّ الشخصية الاعتبارية عند زوال الشرائط، أو العوامل التي أوجدتها، بينما تنحلُّ الشخصية الطبيعية بالموت.
- لا يمكن معاقبة الشخصية الاعتبارية بالعقوبات البدنية كالضرب، أو الحبس، أو القتل، بخلاف الشخصية الطبيعية.
المبحث الثاني: نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية
المطلب الأول: أقسام النظارة على الأوقاف
أولًا: أقسام النظارة باعتبار الصفة: فباعتبار الصفة التي تثبت بها النظارة تنقسم إلى قسمين:
- نظارة أصلية: وهي ما ثبتت للناظر ابتداءً من غير أن يستفيدها من أخر.
- نظارة فرعية: وهي ما ثبتت للناظر بواسطة شخص آخر[32].
ثانيًا: أقسام النظارة باعتبار عموم النظر في الوقف: وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين:
- نظارة عامة: وهي النظر في عموم الوقف.
- نظارة خاصة: وهي النظر في جزء أو أمر خاص من أمور الوقف[33].
المطلب الثاني: وظيفة ناظر الوقف حال كونه شخصية طبيعية[34].
تتمثل تصرفات الناظر في الإجراءات والأعمال أو التدابير التي يقوم عليها الوقف، ومن هذه الأعمال ما يلي:
الأول: إقامة الوقف، وعمارته، وتحصيل غلته: قال ابن النجار رحمه الله: “ووظيفته حفظ وقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق، ونحوه”[35].
الثاني: استثمار الوقف، وحسن استغلاله: أي إدارته بطريقة تدر ريعًا يستفيد منه كلٌ من الوقف والموقوف عليهم، قال الطرابلسي رحمه الله: “ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف، والغبطة؛ لأن الولاية مقيدة به”[36].
الثالث: صرف ريع الوقف، وعائداته: على الناظر أن يتعرف على أولويات الحقوق المالية للوقف، وصرفها حسب شروط الوقف، وحسب مصالحه، كالعمل على إصلاح الوقف لما فيه بقاء عينه والمحافظة عليه، أو دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف، أو قضاء الديون المتعلقة بالأوقاف، أو التعويضات الناتجة عن الوقف، أو مستحقات القائمين عليه[37].
الرابع: تنفيذ شروط الواقف: قال ابن عابدين رحمه الله: “شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به، فيجب عليه خدمة وظيفته أو تركها لمن يعمل، وإلا أثم، لا سيما فيما يلزم بتركها تعطيل الكل”[38].
الخامس: المحافظة على حقوق الوقف: والمحافظة على حقوق الوقف ومقاصده تكون بالمخاصمة أمام المحاكم لصالح الوقف، أو تضمين المتعدي على الوقف، أو أخذ الرهن أو إبراء ذمة الوقف من الالتزامات المالية[39].
السادس: تنفيذ الالتزامات العقدية للوقف: وهي إجراء العقود، كالبيع والشراء، أو الرهن، أو الإجارة للوقف، أو تنفيذ الاقرارات كسداد الدين[40].
المطلب الثالث: وظيفة مجلس نظارة الوقف حال كونه شخصية اعتبارية
تتمثل تصرفات مجلس نظارة الوقف في الإجراءات والأعمال أو التدابير التي تحافظ على الوقف وترعى مصالحه، ومن هذه الأعمال ما يلي[41]:
الأول: إقامة الوقف، ورعايته: بتقديم ما يحتاجه أصل الوقف من رعاية، أو صيانة، أو إصلاح.
الثاني: تقدير الحاجة في مصارف الوقف: فلهم تقدير الحاجة أو المصلحة في مصارف الوقف، بتقديم المناسب في أمر الصرف، أو تقديم الأكثر فائدة، أو الأدوم نفعًا.
الثالث: تقدير الحاجة في مقدار الصرف: بإعداد الميزانيات، والتقارير السنوية، شاملة الإيرادات والمصروفات، مع دراسة لجدواها واعتمادها إذ تحققت المصلحة.
الرابع: تمثيل الوقف أمام الجهات الحكومية: أي اختيار نواب الوقف أمام الجهات الحكومية كالقضاء والجهات الرسمية، للدفاع عنه، والمطالبة بالحقوق الخاصة به.
الخامس: إعداد اللوائح الخاصة بالوقف: كاللوائح المالية، والإدارية وتعديلها حسب المصلحة.
السادس: البحث عن طرق تنمية الوقف: كبيعه، أو نقله، أو الشراء له حسب مصلحة الوقف.
السابع: ضوابط الإشراف على الوقف: كوضع تنظيمات أو ضوابط الإدارة للوقف بما يحقق استمرار نفعه في العاجل والآجل.
المطلب الرابع: افتراق نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية.
تفترق تصرفات نظار الوقف حال كونهم أشخاصًا اعتباريين عن كونهم أشخاصًا طبيعيين، بما يلي[42]:
الأول: عدم تأثير المجلس في الشخصية الاعتبارية بعزل أي عضو جُرِحَ في عدالته، أو خُوِّن في أمانته، وتوليه غيره بما يحقق المصلحة سواء من أقرابه، أو غيرهم.
الثاني: تنفيذ الأعمال أو تقدير المصروفات إنما تكون بقرار الأغلبية، وهذا يبعث على الطمأنينة لسلامة التصرف في الوقف، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأكثر خبرة، أو الأقدم عملًا.
المطلب الخامس: العناصر الضرورية للشخصية الاعتبارية للوقف.
لابد من توفر عناصر ضرورية لقيام الشخصية الاعتبارية للوقف، من أهمها:
الأول: العنصر الموضوعي: هو الجماعة الذين يسند إليهم الإدارة لأموال الوقف، والنظارة عليه.
الثاني: العنصر الشكلي: وهو حصول الاعتراف النظامي لهذه المجموعة بإدارة الوقف كي تنفذ المهام الموكلة إليها أمام القضاء، والمؤسسات العامة[43].
المطلب السادس: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف
يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف نتائج عدة من أهمها:
الأولى: الذمة المالية المستقلة: فمال الوقف، وما يلحق به من التزامات خاص به، لا بذمة غيره.
الثانية: ثبوت أهلية وجوب للوقف: فالشخصية الاعتبارية أوجبت له الأهلية المدنية التي تكسبه الحقوق، وتتيح له استعمالها في حدود الشرع.
الثالثة: ثبوت أهلية الأداء للوقف: فالشخصية الاعتبارية أوجبت الحق في التصرفات الشرعية، أي من غير توقف على إجازة غيره[44].
المبحث الثالث: حكم تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية
المطلب الأول: الحكم الوضعي لتحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية.
لم يتناول الفقهاء القدماء والمعاصرين مسألة تحويل إدارة الوقف من الإدارة الفردية إلى الإدارة المؤسسية، وما ذكروه من نصوص يستفاد منها صحة إدارة الأوقاف إدارة اعتبارية، وصحة تحويل إدارة الوقف ونظارته من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية، وذلك كما يلي:
أولاً: أقوال الفقهاء في صحة إدارة الوقف من الشخصية الاعتبارية.
ذهب بعض الشافعية والحنابلة والفقهاء المعاصرين إلى صحة نظارة الوقف وإدارته من قبل الشخصية الاعتبارية، وفيما يلي بيانها:
قال المنهاجي الأسيوطي: “النوع الثاني: فيما يتعلق بوظيفة القضاء من التواقيع والتسجيلات وتفويض الأنظار والتداريس، والنظر على الأوقاف الجارية تحت نظر الحكم العزيز، ونصب الأمناء والقوام على الأيتام الداخلين تحت حجر المشرع الشريف وغير ذلك من التعلقات التي هي منوطة بحكام الشريعة المطهرة”[45]. ففي هذا القول بيان أن الأوقاف الجارية تحت نظر الحكم له تنصيب من يقوم بوظيفتها.
وقال المرداوي رحمه الله: “إذا كان الوقف على جهة لا تنحصر، كالفقراء والمساكين، أو على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك، فالنظر للحاكم، وجهًا واحدا”[46]. ومعلوم أن الحاكم شخصية اعتبارية إذ لا بد له من توكيل من يدير الوقف.
وجاء في مدونة أحكام الوقف الفقهية ما نصه: “فالولاية على الوقف تكون للدولة، وهي شخصية اعتبارية فتمارسها من خلال من تستنيبه لذلك، وهذا النائب كما أنه يجوز أن يكون شخصًا طبيعيًا يجوز كذلك أن يكون مؤسسة متخصصة في إدارة الأوقاف ذات شخصية اعتبارية”[47].
ثانيًا: تقديم الأصلح لإدارة الوقف كما هو ظاهر من فقه الأولويات عند الفقهاء.
وذهب الحنفية إلى الندب في تقديم الأصلح في نظارة الوقف كما قال الفقهاء الحنفية ذلك منهم، قال ابن مازه البخاري الحنفي رحمه الله: “فالأعلم بأمر الوقف أولى، ولو كان أحدهما أميناً ورعاً وصالحاً، والآخر أعلم بأمر الوقف فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال يؤمن خيانته”[48].
وقال ابن عابدين رحمه الله: “فالأعلم بأمر الوقف أولى ولو كان أحدهما أكثر ورعًا وصلاحًا والآخر أوفر علمًا بأمور الوقف فالأوفر علمًا أولى بعد أن يكون بحال تؤمن خيانته وغائلته”[49].
وقال داماد أفندي رحمه الله: “فالأعلم بأمر الوقف أولى، وأفتى بعض المتأخرين بالاشتراك بينهما إذا لم يوجد صفة الترجيح في إحداهما لأن أفعل التفضيل ينتظم بالواحد والمتعدد أفضل”[50].
ثالثًا: أقوال الفقهاء في صحة تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعة على الشخصية الاعتبارية
ذهب الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الاعتبارية وفيما يلي أقوال الأئمة في المسألة.
أقوال أئمة الحنفية في المسألة:
قال الخصاف رحمه الله: “فإن كان غير مأمون على هذا الوقف يخاف أن يتلفه أو يحدث فيه حدثًا يكون فيه اتلافه، يخرجه القاضي من يده”[51]، وقال أيضًا: “فإن ترك عمارته فلم يعمره وفي يده من غلته ما يمكنه أن يعمره، يجبره القاضي على عمارته، فإن فعل وإلا أخرجه من يده”[52].
قال ابن عابدين رحمه الله: “عن الخصاف أن له عزله أو إدخال غيره معه”[53].
أقوال أئمة الشافعية في المسألة:
قال الخطيب الشربيني من الشافعية: وإن لم يشرطه لأحد فالنظر للقاضي على المذهب؛ لأن له النظر العام فكان أولى بالنظر فيه، ولأن الملك في الوقف لله تعالى[54].
أقوال أئمة الحنابلة في المسألة:
قال ابن تيمية رحمه الله: “وللحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يشرع، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود، ومن ثبت فسقه أو أضر في تصرفه مخالفا للشراء الصحيح عالما بتحريفه فإما أن ينعزل أو يعزل، أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور”[55]. وبهذا القول قال ابن مفلح[56]، والمرداوي[57] رحمهم الله.
وقال بدر البعلي رحمه الله: “فإن الواجبَ إذا لم يستقِمْ أن يُستبدَلَ به ناظرٌ غيرُه يقومُ بالواجبِ، أو يُضَمَّ إليه أمينٌ”[58].
المطلب الثاني: أدلة صحة تحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية
فمما سبق من ذكر نصوص الفقهاء بصحة إدارة الوقف من شخصية اعتبارية، وتقديم الأصلح والأنفع للوقف، وصحة تحويل إدارته إدارة اعتبارية، فإن الأدلة على صحة تحويل نظارة الوقف إلى الشخصية الاعتبارية ما يلي:
الدليل الأول: قياس تحويل نظارة الوقف إلى الشخصية الاعتبارية على بيع الوقف إذا تعطلت منافعه أو تم الاستغناء عنه، بجامع المصلحة للوقف، فالعلماء مجمعون على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغني عنه[59].
الدليل الثاني: عمل الصحابة لما هو أنفع للوقف من إبدال أو استبدال، قال ابن قدامة رحمه الله: “ولنا ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد، لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة، أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعًا”[60].
الدليل الثالث: أن الحاجة في الوقت الحاضر إلى نظارة الشخصية الاعتبارية ملحّة للأسباب الآتية:
- أن الوقف أصبح صناديق استثمارية ومشاريع تنموية، والتي تحتاج إلى تنمية موارده بالدخول في مشاريع استثمارية، وهذه المشاريع يغلب عليها المخاطر فتفتقر إلى رعاية وإدارة وضمانات، مما جعل الحاجة للشخصية الاعتبارية ماسة لمصلحة الوقف.
- أن الأوقاف أصبحت جماعية، سواء الواقف، أو الموقوف عليهم، مما جعل الرعاية السليمة لا تكون إلا بالشخصية الاعتبارية.
- المعاملات العامة للوقف كمخاطبة الدوائر والمؤسسات الاجتماعية والمالية، العامة والخاصة، بطلب المساهمة في الأوقاف أو صرف فوائده، يحّتم أن تكون إدارة الوقف شخصية اعتبارية.
- أن أملاكًا في العالم الإسلامي تستدعي تسجيلها بأسماء مؤسسات وقفية، كالمراكز الإسلامية، والمكتبات، والمعاهد، لأن إضافتها للشخصية الطبيعية قد يعرضها للضياع[61].
الدليل الرابع: حاجة الوقف إلى تخطيط بعيد المدى يراعى فيها المصالح والأولويات، خاصة في الإيرادات والمصروفات، وإلى تطوير الوسائل الإدارية والتنفيذية يستدعي أن تكون النظارة للوقف شخصية اعتبارية[62].
الدليل الخامس: أن الوقف ملك لله، وما كان ملكًا لله كان الحاكم مخولًا بالتصرف فيه، وللحاكم توكيل من يراه مناسبًا لإدارته، وهذا معنى الشخصية الاعتبارية[63].
الدليل السادس: عدم المانع الشرعي من إدارة الشخصية الاعتبارية للأوقاف، سواءً من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو القياس[64].
الدليل السابع: تحقق المقصد والغاية من نظارة الوقف، بإدارة الشخصية الاعتبارية، والإدارة الاعتبارية مبنية على أساس المحافظة على الوقف واستمراره وتطوره[65].
الدليل الثامن: تمتع الوقف بالشخصية الاعتبارية، وذلك لأن الوقف يؤدي وظيفته دون الرجوع إلى الواقف في كل مرة، أو حتى بعد موت الواقف، فإن هذه الاستقلالية تجعل من الوقف شخصية اعتبارية[66]، فكان الأولى في نظارته أن تكون شخصية اعتبارية كذلك.
المبحث الرابع: شروط تحويل نظارة الأوقاف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية والحكمة منها.
المطلب الأول: شروط تحويل النظارة من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية.
يشترط لتحويل النظارة إلى الشخصية الاعتبارية شروط عدة من أهمها:
- أن يتوافق التحويل مع مقاصد الشرع وحِكَمه، قال ابن تيمية: “والشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى الله تعالى”[67].
- أن يوجد مسوغ معتبر لتحويل النظارة إلى الشخصية الاعتبارية، كتحقق مصلحة راجحة، أو كمال منفعة، إذ يدخل تحتها إزالة الضرر أو الفساد عن الوقف[68].
- ألا يفوت التحويل الغرض[69] الذي من أجله أنشأ الوقف[70].
المطلب الثاني: الحكمة من تحويل النظارة من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية
إن في تحويل إدارة الوقف إلى الشخصية الاعتبارية حِكَمًا ومَآلات، من أهمها:
الأولى: المحافظة على الأوقاف؛ لأنها أصبحت من المصالح العامة.
الثانية: حسن استثمار الوقف بما يعود نفعه على العين الموقوفة، أو الموقوف عليهم، بزيادة العائدات، أو حسن تدبير المال القائم[71].
الثالثة: تلبية حاجة الوقف بالإدارة الحديثة التي تمثل حسن التصرف، وتمثيل الوقف في المؤسسات الخارجية وما يمكن أن تعجز عنه الشخصية الطبيعية، إذ من المسلم به وجود مشروعات اقتصادية تستدعي تضافر الجماعات بجهودها وأموالها، فتتجاوز قدرة الأفراد على انفراد[72].
خاتمة
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على المبعوث بالملة العصماء، والشريعة السمحاء، وبعد الوصول إلى نهاية هذا البحث نختم بأهم النتائج، والتوصيات، وهي كما يلي:
أولًا: النتائج:
- يقصد بتحويل نظارة الوقف من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الاعتبارية هو أن يُؤخذ الوقف من الناظر الفرد، ويعطى إلى مؤسسة متخصصة لإدارة الأوقاف.
- تقوم نظارة الأوقاف على أساس درء المفاسد، ودفع الأضرار عن الموقوف في الحال أو المآل.
- إن أهم ما تتميز به الشخصية الاعتبارية في إدارة الأوقاف أنها تقوم على نظام، كما أنها لا تنحل أو تزول بعوارض سماوية كالجنون والموت، إنما تنحل عند زوال الشرائط أو العوامل التي أوجدتها.
- لا تختلف وظيفة ناظر الوقف من كونه شخصية حقيقية أو اعتبارية، بل إن المحافظة على الوقف وحسن استغلاله تكون من الشخصية الاعتبارية أكثر من الشخصية الطبيعية، فيكون من مصلحة الوقف أن تكون إدارته من قبل شخصية اعتبارية.
- يترتب على ثبوت التصرف للشخصية الاعتبارية للأوقاف ما يثبت للشخصية الطبيعية، من حقوق وواجبات، مما يجعل تقديم الأصلح في إدارة الوقف حسب ما تقتضه المصلحة هو المعتبر في بيان الحكم الوضعي لنظارة الوقف.
- عدم تناول الخلاف الفقهي لفقهاء الإسلام في القديم دلالة على عدّ الوقف شخصية اعتبارية، ودلالة أخرى على إمكانية تقديم إدارته من قبل شخصية اعتبارية، فالمنظور إليه هو المقصد، والمصلحة المرجوة من الوقف.
- يشترط لتحويل نظارة الوقف القائمة من شخصية طبيعية إلى شخصية اعتبارية أن يتوافق هذا التحويل مع مقاصد الشرع وحكمه، وأن يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، كما أنه لا يفوت الغرض الذي من أجله أنشأ الوقف.
ثانيًا: أهم التوصيات:
- تأسيس مؤسسات وقفية تابعة للهيئة العامة للأوقاف للقيام بأعمال النظارة والإدارة والاستثمار، وتطبيق المعايير المالية كالشفافية والإفصاح والحوكمة.
- فتح المجال للمؤسسات الوقفية لحماية أعيان الوقف والدفاع عنه أمام تجاوزات القائمين عليه من النظار وغيرهم.
والحمد لله رب العالمين أولاً وأخيرًا، وصلى الله علي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المراجع والمصادر
- الأسيوطي، شمس الدّين مُحَمَّد بن أَحْمد المنهاجي “جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود”، حققها وَخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني، (دَار الْكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ – 1996م).
- الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، “أسنى المطالب في شرح روض الطالب”، (دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ).
- الأوقاف الكويتية، الأمانة العامة، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”، (الطبعة: الأولى، 1439هـ – 2017م).
- البعلي، محمد بن علي بن أحمد بن عمر، “مختصر الفتاوى المصرية”، المحقق: د. عبد العزيز العيدان، د. أنس عادل اليتامى، (ركائز للنشر والتوزيع، الكويت، توزيع دار أطلس، الرياض، الطبعة: الأولى، 1440ه – 2019م).
- البلدحي، ابن مودود الموصلي، “الاختيار لتعليل المختار”، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، (مطبعة الحلبي – القاهرة وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها، تاريخ النشر: 1356ه-1937م).
- البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح، “دقائق أولي النهى لشرح المنتهى”، (عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1993م).
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، “الفتاوى الكبرى”، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1408ه- 1987م).
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، “مجموع الفتاوى”، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م).
- الجديع، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب، “تيسير علم أصول الفقه”، (مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997م).
- الجرجاني، علي بن محمد “التعريفات” ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، (دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: الأولى 1403ه-1983م).
- الجلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، “ملتقى الأبحر”.
- آل حاضر، منى علي سعيد، “ولاية الشخصية الاعتبارية على أموال القاصرين في النظام السعودي، دراسة استقرائية”، (مجلة بحوث كلية الآداب).
- الحجاوي، موسى بن أحمد، “الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل”، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، (دار المعرفة بيروت – لبنان).
- ابن حجر الهيتمي، ابن حجر، “تحفة المحتاج في شرح المنهاج”، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، (المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: 1357ه-1983م).
- الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني، “الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار”، المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م).
- الحميري، نشوان بن سعيد “شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم” تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري – مطهر بن علي الإرياني – د يوسف محمد عبد الله، (دار الفكر المعاصر، بيروت – لبنان، دار الفكر، دمشق – سورية).
- الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمرو، “أحكام الوقف”، (ديوان عموم الأوقاف المصرية، الطبعة الأولى).
- الخيرو عبد القادر، “الشخصية الاعتبارية للوقف، وأثرها في حمايته”، (مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد: 02، عام: 2012م).
- داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، “مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر”، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ).
- الدبيان، دبيان بن محمد، “المعاملات المالية أصالة ومعاصرة”، (مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1432هـ).
- الدلالعة، موفق محمد عبده، “ضبط عمل ناظر الوقف في الفقه الإسلامي”، (مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، المجلد السابع والثلاثون، ديسمبر 2019م).
- الدمياطي، أبو بكر، “عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين”، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1418هـ – 1997م).
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، “مختار الصحاح”، المحقق: يوسف الشيخ محمد، (المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ/ 1999م).
- الرامينى، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، “الفروع وتصحيح الفروع”، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424هـ – 2003م).
- رضا، أحمد، “معجم متن اللغة”، (دار مكتبة الحياة، بيروت، عام النشر: 1377 – 1380ه).
- الزبيدي، محمد بن محمد “تاج العروس من جواهر القاموس” تحقيق: مجموعة من المحققين، (دار الهداية).
- الزرقا، مصطفى بن أحمد، “أحكام الوقف”، (دار عمار، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 1997م).
- الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج”، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415ه- 1994م).
- الشهراني، حسين معلوي، “الشخصية الاعتبارية والطبيعية والفرق بينهما”، (مجلة البحوث والدراسات الشرعية، العدد العاشر، رجب 1424ه).
- الطرابلسي، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي، “الإسعاف في أحكام الأوقاف”، (طبع بمطبعة هندية بشارع المهدى بالأزبكية بمصر المحمية، الطبعة: الثانية، 1320هـ – 1902م).
- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، “رد المحتار”، (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية 1386 هـ = 1966 م).
- عبد الله، عبد العزيز، “معلمة الفقه المالكي”، (دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1403 هـ – 1983م).
- ابن عرفة، محمد بن محمد، “المختصر الفقهي”، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، (مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، 1435هـ – 2014م).
- علال، قاشي، “إسهامات الوقف في التنمية بالنظر إلى الشخصية الاعتبارية”، (مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحيى فارس المدية، المجلد: (03)، العدد: (01)، سنة: (2019م).
- عمر، أحمد مختار “معجم اللُّغة العربية المعاصرة” (عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429ه).
- القحطاني، أسامة بين سعيد، وأخرون، “موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي”، (دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1433هـ – 2012م): (8/184).
- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، “المغني”، (مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، 1388ه – 1968م).
- القزويني، أحمد بن فارس “معجم مقاييس اللغة” حقيق: عبد السلام محمد هارون، (دار الفكر، 1399ه- 1979م).
- الكجراتي، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي، “مجمع بحار الأنوار”، (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 1387هـ – 1967م).
- الكفوي، أبو البقاء، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش – محمد المصري، (مؤسسة الرسالة – بيروت).
- اللاحم، عبد الكريم بن محمد، “شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب”، (دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1431 هـ – 2010 م).
- اللويحق، عبد الرحمن بن معلا، “الشخصية الحكمية للوقف في الفقه الاسلامي”، (شبكة الألوكة، الطبعة بدون، والتاريخ بدون).
- ابن مَازَةَ، محمود بن أحمد بن عبد العزيز، “المحيط البرهاني في الفقه النعماني”، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، (دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ – 2004م).
- المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي – الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، (هجر للطباعة والنشر، القاهرة – مصر، الطبعة: الأولى، 1415ه).
- مركز استثمار المستقبل، “حقوق وواجبات ناظر الوقف”، (مركز استثمار المستقبل، الرياض).
- مصطفى، إبراهيم، وآخرون، “المعجم الوسيط”، (دار الدعوة).
- مصيلحي، عبد الفتاح بن محمد، “جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد”، (دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع – المنصورة، مصر، الطبعة: الأولى، 1443هـ – 2022م).
- الملياني، عبد الله عوض، “مسؤولية ناظر الوقف، دراسة تأصيلية مقارنة”، (مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، الطبعة الأولى، 2017م).
- المناوي، عبد الرؤوف بن زين العابدين، “التوقيف على مهمات التعاريف” (عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الأولى، 1410ه).
- ابن منظور، محمد بن مكرم، “لسان العرب” (دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414ه).
- ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، “منتهى الإرادات”، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1999م).
- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، “البحر الرائق شرح كنز الدقائق”، (دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية – بدون تاريخ).
- النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، “كنز الدقائق”، المحقق: أ. د. سائد بكداش، (دار البشائر الإسلامية، دار السراج، الطبعة: الأولى، 1432ه – 2011م).
- ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، “شرح فتح القدير”، (شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 1389هـ – 1970م).
- اليمني، عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر، “تدخل القضاء في تصرفات ناظر الوقف”، (مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، الرياض، الطبعة الأولى، 2020م).
***********************************************
************
لتحميل العدد 14 أو أي بحث ضمنه:
——————–
لقراءة جميع الأعداد مع تفاصيل الأبحاث ضمنها:
——————-
لتحميل جميع الأعداد المنشورة من (مجلة المرقاة المحكمة) بنسخة pdf:
[1] جامعة المدينة العالمية، ماليزيا الإيميل: alqohami2015@gmail. com
[2] القزويني، أحمد بن فارس “معجم مقاييس اللغة” حقيق: عبد السلام محمد هارون، (دار الفكر، 1399ه- 1979م): (2/121).
[3] الحميري، نشوان بن سعيد “شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم” تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري – مطهر بن علي الإرياني – د يوسف محمد عبد الله، (دار الفكر المعاصر، بيروت – لبنان، دار الفكر، دمشق – سورية): (3/1635)، عمر، أحمد مختار “معجم اللُّغة العربية المعاصرة” (عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429ه): (1/587).
[4] الكفوي، أبو البقاء، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش – محمد المصري، (مؤسسة الرسالة – بيروت): (ص: 294).
[5] ينظر: مصطفى، إبراهيم، وآخرون، “المعجم الوسيط”، (دار الدعوة): (2/932).
[6] ينظر: رضا، أحمد، “معجم متن اللغة”، (دار مكتبة الحياة، بيروت، عام النشر: 1377 – 1380هـ): (5/490)، مصطفى، وآخرون، “المعجم الوسيط”: (2/932).
[7] ينظر: عبد الله، عبد العزيز، “معلمة الفقه المالكي”، (دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1403 هـ – 1983م): (ص324).
[8] ينظر: الأوقاف الكويتية، الأمانة العامة، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”، (الطبعة: الأولى، 1439هـ – 2017م): (2/324).
[9] القزويني: “مقاييس اللغة”: (6/135).
[10] ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، “لسان العرب” (دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414ه): (9/359-360)، الزبيدي، محمد بن محمد “تاج العروس من جواهر القاموس” تحقيق: مجموعة من المحققين، (دار الهداية): (24/469-470).
[11] ينظر: البلدحي، ابن مودود الموصلي، “الاختيار لتعليل المختار”، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، (مطبعة الحلبي – القاهرة وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها، تاريخ النشر: 1356ه-1937م): (3/40)؛ النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، “كنز الدقائق”، المحقق: أ. د. سائد بكداش، (دار البشائر الإسلامية، دار السراج، الطبعة: الأولى، 1432ه – 2011م): (ص: 403)، الجلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، “ملتقى الأبحر”: (ص: 567).
[12] ينظر: ابن عرفة، محمد بن محمد، “المختصر الفقهي”، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، (مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، 1435هـ – 2014م): (8/429).
[13] ينظر: الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، “أسنى المطالب في شرح روض الطالب”، (دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ): (2/457)، ابن حجر الهيتمي، ابن حجر، “تحفة المحتاج في شرح المنهاج”، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، (المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: 1357ه-1983م): (6/235)، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج”، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415ه- 1994م): (3/522)، الدمياطي، أبو بكر، “عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين”، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1418هـ – 1997م): (3/186).
[14] ينظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، “المغني”، (مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، 1388ه – 1968م): (6/3).
[15] ينظر: المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي – الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، (هجر للطباعة والنشر، القاهرة – مصر، الطبعة: الأولى، 1415ه): (16/362)، الحجاوي، موسى بن أحمد، “الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل”، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، (دار المعرفة بيروت – لبنان): (3/2)، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح، “دقائق أولي النهى لشرح المنتهى”، (عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1993م): (2/397).
[16] ينظر: القزويني: “مقاييس اللغة”: (3/254).
[17] مصطفى، وآخرون، “المعجم الوسيط”: (1/475).
[18] ينظر: مصيلحي، عبد الفتاح بن محمد، “جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد”، (دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع – المنصورة، مصر، الطبعة: الأولى، 1443ه – 2022م): (1/364)، الجديع، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب، “تيسير علم أصول الفقه”، (مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997م): (ص84).
[19] ينظر: القزويني: “مقاييس اللغة”: (3/ 438).
[20] ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، “مختار الصحاح”، المحقق: يوسف الشيخ محمد، (المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ/ 1999م): (ص: 188)
[21] ينظر: عمر، “معجم اللُّغة العربية المعاصرة”: (2/ 1385).
[22] ينظر: عمر، “معجم اللُّغة العربية المعاصرة”: (2/ 1385).
[23] ينظر: المرجع السابق: (2/ 1386).
[24] القزويني: “مقاييس اللغة”: (4/207).
[25] الكجراتي، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي، “مجمع بحار الأنوار”، (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 1387هـ – 1967م): (3/507).
[26] ينظر: الجرجاني، علي بن محمد “التعريفات” ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، (دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: الأولى 1403ه-1983م): (ص196)، المناوي، عبد الرؤوف بن زين العابدين، “التوقيف على مهمات التعاريف” (عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الأولى، 1410ه): (ص294).
[27] الأوقاف الكويتية، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”: (2/590).
[28] ينظر: الخيرو عبد القادر، “الشخصية الاعتبارية للوقف، وأثرها في حمايته”، (مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد: 02، عام: 2012م): (ص: 94).
[29] ينظر: الدبيان، دبيان بن محمد، “المعاملات المالية أصالة ومعاصرة”، (مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1432هـ): (13/115).
[30] ينظر: آل حاضر، منى علي سعيد، “ولاية الشخصية الاعتبارية على أموال القاصرين في النظام السعودي، دراسة استقرائية”، (مجلة بحوث كلية الآداب): (ص: 750).
[31] الشهراني، حسين معلوي، “الشخصية الاعتبارية والطبيعية والفرق بينهما”، (مجلة البحوث والدراسات الشرعية، العدد العاشر، رجب 1424ه): (ص: 69-7).
[32] ينظر: اليمني، عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر، “تدخل القضاء في تصرفات ناظر الوقف”، (مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، الرياض، الطبعة الأولى، 2020م): (ص: 85).
[33] ينظر: اليمني، “تدخل القضاء في تصرفات ناظر الوقف”: (ص: 85).
[34] الملياني، عبد الله عوض، “مسؤولية ناظر الوقف، دراسة تأصيلية مقارنة”، (مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، الطبعة الأولى، 2017م): (ص: 60).
[35] ينظر: ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، “منتهى الإرادات”، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1999م): (3/363).
[36] ينظر: الطرابلسي، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي، “الإسعاف في أحكام الأوقاف”، (طبع بمطبعة هندية بشارع المهدى بالأزبكية بمصر المحمية، الطبعة: الثانية، 1320هـ – 1902م): (ص56).
[37] ينظر: الأوقاف الكويتية، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”: (2/410) وما بعدها.
[38] ينظر: الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني، “الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار”، المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1423ه- 2002م): (ص379).
[39] ينظر: الأوقاف الكويتية، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”: (2/456) وما بعدها.
[40] ينظر: الملياني، “مسؤولية ناظر الوقف”: (81-83).
[41] ينظر: مركز استثمار المستقبل، “حقوق وواجبات ناظر الوقف”، (مركز استثمار المستقبل، الرياض): (ص: 13).
[42] ينظر: مركز استثمار المستقبل، “حقوق وواجبات ناظر الوقف”: (ص: 13).
[43] الأوقاف الكويتية، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”: (2/597).
[44] ينظر: الأوقاف الكويتية، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”: (1/344).
[45] ينظر: الأسيوطي، شمس الدّين مُحَمَّد بن أَحْمد المنهاجي “جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود”، حققها وَخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني، (دَار الْكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ – 1996م): (2/294).
[46] ينظر: الرامينى، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، “الفروع وتصحيح الفروع”، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424هـ – 2003م): (7/345)؛ المرداوي، “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”: (16/447)
[47] الأوقاف الكويتية، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”: (2/596).
[48] ينظر: ابن مَازَةَ، محمود بن أحمد بن عبد العزيز، “المحيط البرهاني في الفقه النعماني”، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، (دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ – 2004م): (6/135).
[49] ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، “البحر الرائق شرح كنز الدقائق”، (دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية – بدون تاريخ): (5/250).
[50] داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، “مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر”، (دار إحياء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ): (1/735).
[51] الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمرو، “أحكام الوقف”، (ديوان عموم الأوقاف المصرية، الطبعة الأولى): (ص: 202).
[52] الخصاف، “أحكام الوقف”: (ص: 202).
[53] ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، “رد المحتار”، (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية 1386 هـ = 1966 م): (4/380)
[54] ينظر: الشربيني، “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج”: (3/552)
[55] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، “الفتاوى الكبرى”، (دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1408ه- 1987م): (5/427).
[56] ينظر: الرامينى، “الفروع وتصحيح الفروع”: (7/349).
[57] ينظر: المرداوي، “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”: (16/450).
[58] البعلي، محمد بن علي بن أحمد بن عمر، “مختصر الفتاوى المصرية”، المحقق: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، (ركائز للنشر والتوزيع، الكويت، توزيع دار أطلس، الرياض، الطبعة: الأولى، 1440هـ – 2019م): (2/150).
[59] ينظر: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، “شرح فتح القدير”، (شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 1389هـ – 1970م): (6/221)، الأوقاف الكويتية، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”: (2/154)، القحطاني، أسامة بين سعيد، وآخرون، “موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي”، (دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1433هـ – 2012م): (8/184).
[60] ينظر: ابن قدامة، “المُغني”: (6/29).
[61] ينظر: اللويحق، عبد الرحمن بن معلا، “الشخصية الحكمية للوقف في الفقه الاسلامي”، (شبكة الألوكة، الطبعة بدون، والتاريخ بدون): (ص: 28).
[62] ينظر: اللويحق، “الشخصية الحكمية للوقف في الفقه الاسلامي”،: (ص: 28).
[63] ينظر: اللاحم، عبد الكريم بن محمد، “شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب”، (دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1431 هـ – 2010 م): (ص502)
[64] علال، قاشي، “إسهامات الوقف في التنمية بالنظر إلى الشخصية الاعتبارية”، (مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحيى فارس المدية، المجلد: (03)، العدد: (01)، سنة: (2019م): (ص: 58).
[65] علال، “إسهامات الوقف في التنمية بالنظر إلى الشخصية الاعتبارية”: (ص: 58).
[66] علال، “إسهامات الوقف في التنمية بالنظر إلى الشخصية الاعتبارية”: (ص: 52).
[67] ينظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، “مجموع الفتاوى”، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م: (31/60).
[68] ينظر: ابن تيمية، “مجموع الفتاوى”: (31/224)، المرداوي، “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”: (16/524).
[69] لما كان الوقف دعامة أساسية من دعائم النهضة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المسلمة، فإن أهداف الوقف في الشريعة الإسلامية يتمثل فيما يلي: الأهداف الدينية: تتمثل الأهداف الدينية بما يلي: 1- حصول الأجر والثواب من الله إذ بالوقف يكون حفر الآبار لسقي الناس، ومساعدة المحتاجين، وغيرها من الأمور التي يراد بها وجه الله. 2- استمرار الثواب للواقف وهو ما يعرف بالصدقة الجارية. الأهداف الاجتماعية: تتمثل الأهداف الاجتماعية بما يلي: 1- استقرار المجتمعات المسلمة، والتواصل بين أفرادها بحيث يحصل بينهم الوئام، والترابط. 2- صلة رحم بين الناس لا تنقطع. الأهداف الاقتصادية: تتمثل الأهداف الاقتصادية بما يلي: 1- القضاء على الفقر باعتباره مصدر دخل مستمر للأعمال الخيرية، كبذل ريع الوقف على القائمين على دور العبادات والمراكز العلمية، والدعوية. 2-الحفاظ على الثروة من التآكل، مع ضمان تنمية الأموال في المجالات المختلفة. ينظر: الدلالعة، موفق محمد عبده، “ضبط عمل ناظر الوقف في الفقه الإسلامي”، (مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، المجلد السابع والثلاثون، ديسمبر 2019م): (ص: 2246-2247).
[70] ينظر: ابن تيمية، “مجموع الفتاوى”: (31/224)، المرداوي، “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”: (16/524).
[71] ينظر: الزرقا، مصطفى بن أحمد، “أحكام الوقف”، (دار عمار، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 1997م): (ص: 142).
[72] ينظر: الأوقاف الكويتية، “مدونة أحكام الوقف الفقهية”: (2/596)