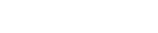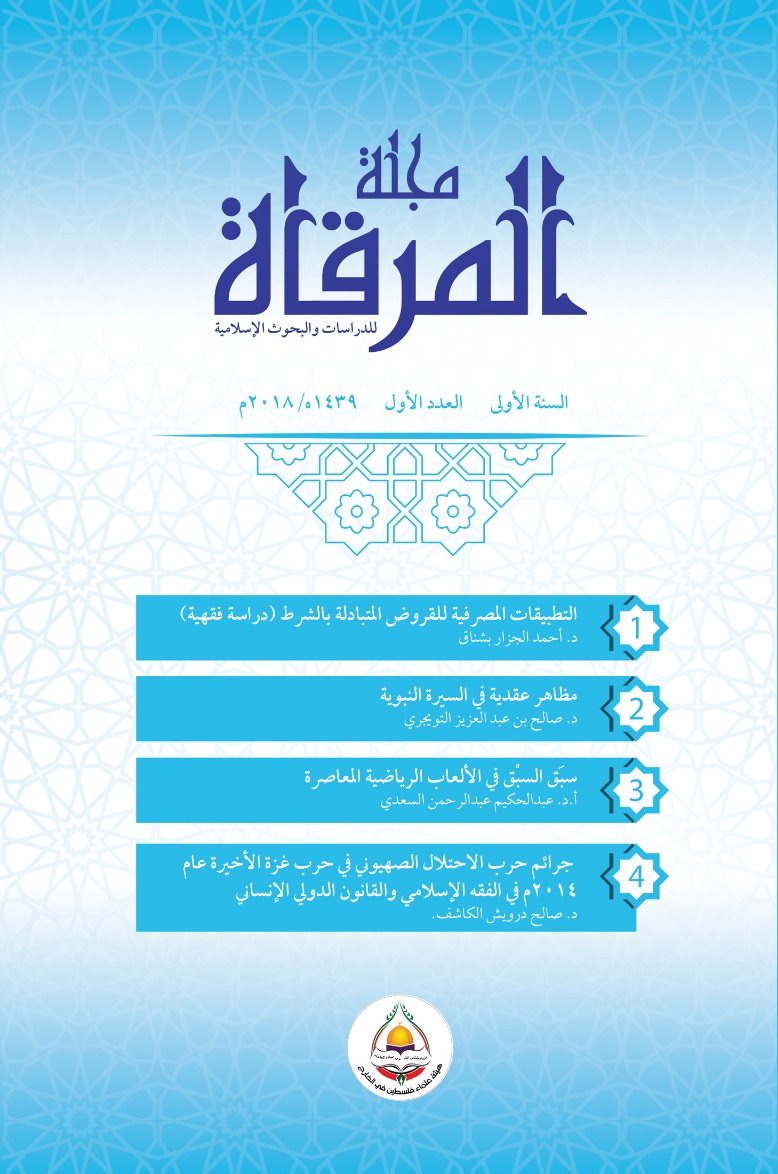خاص هيئة علماء فلسطين
“باب البيوع المنهي عنها نموذجًا”
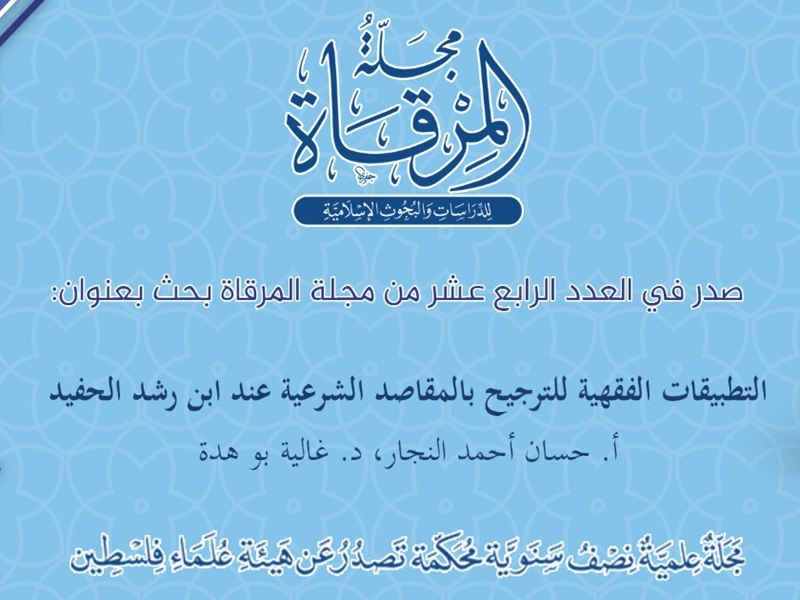
إعداد الباحثين[1] : حسان أحمد النجار، وغالية بو هدة
ملخص البحث
هذه الدراسة محاولة للوقوف على المقاصد الشرعية التي رجح بها ابن رشد الحفيد بين الأحكام في باب البيوع المنهي عنها، في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وآلية توظيفه للمقاصد في الترجيح بين الأحكام.
وقد تناول الباحثان فيها أولًا دراسة نظريته ببيان مفهوم المقاصد عند ابن رشد الحفيد والألفاظ ذات الصلة بالمقاصد، ومدى اهتمامه بها في فقهه، وموقفه من تعليل الأحكام، ثم دراسة تطبيقية تحليلية لمجموعة من المسائل المتعلقة بالبيوع المنهي عنها في الشريعة، ودراستها دراسة تحليلية، والوقوف على ترجيحات الإمام ابن رشد المقاصدية، وكيفية توظيفه للمقاصد في الترجيح بين الأحكام.
Research summary
This study is an attempt to find out the legal objectives with which Ibn Rushd al-Hafid gave weight to the rulings in the chapter on forbidden sales, in his book The Beginning of the Mujtahid and the End of the Muqtasid, and the mechanism of his employment of the objectives in weighing the rulings.
The two researchers first dealt with a theoretical study by explaining the concept of objectives according to Ibn Rushd al-Hafid and the terms related to objectives, the extent of his interest in them in his jurisprudence, and his position on the explanation of rulings. Then an applied and analytical study of a group of issues related to sales forbidden in Sharia, studying them analytically, and examining Imam Ibn Rushd’s preferences for objectives, and how he employed objectives in weighing between rulings.
مقدمة
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ليكون للعالمين نذيرا، وأرسل رسوله هاديا وبشيرا، نحمده ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:
إن النظر في المقاصد الشرعية والمآلات من أهم ما يجب أن يراعيه المجتهد عند استنباط الأحكام، حيث إن علم المقاصد هو البوابة الواسعة لفهم الواقع المعاصر؛ لتنزيل الأحكام وفق المستجدات، ولا شك أن للسادة المالكية إسهاماً كبيراً في هذا المجال؛ ولهذا حظي كثير من علمائهم بدراسات عديدة في عصرنا الحالي؛ مما شهد انتعاشًا في الدراسات المقاصدية، ومن هؤلاء إمامنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفيلسوف الشهير بالحفيد، المولود بقرطبة سنة(520ه/1126م)، ولا عجب فقد تولى أبوه وجده منصب قاضي القضاة ثم أصبح هو قاضياً للقضاة من بعدهم، وقد أُثِر عنه أنه سوّد في التصنيف والتأليف نحواً من عشرة آلاف ورقة، حيث كان شيخنا ميالاً للفلسفة والأمور الحِكَمية، فضلاً عن اهتمامه بالطب، مع حظه الوافر من الفقه والفتوى والأدب والإعراب وحفظه للشعر، فكان من أشهر فلاسفة العرب والمسلمين، حيث أضاف لبنة كبيرة في بناء الحضارة الأوروبية، حتى توفي سنة (595ه) بمراكش[2]، ولعل من أبرز وأهم الكتب التي وَرَّثها ابن رشد لمن بعده هو كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كثير النفع للمبتدئ، وخير معين للمجتهد، له مكانة عظيمة عند الفقهاء والعلماء في ميدان الفقه المقارن، لعلمهم أنه يحمل في طياته كثيراً من الفنون والعلوم، وما يخفيه محيطه الزاخر من نفائس وعيون، فكانت الدراسات التي تناولته بالبحث دليلاً على سمو مكانته مما جعلته مرجعاً مهماً في الفقه وأصوله، ولابن رشد آثار مقاصدية عظيمة ومتفرقة لم تحظَ بالاهتمام كثيرًا، خصوصًا في باب المعاملات.
ومن هنا تأتي هذه الدراسة بعنوان التطبيقات الفقهية للترجيح بالمقاصد الشرعية عند ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المجتهد “باب البيوع المنهي عنها نموذجًا”، لتبرز إسهامات ابن رشد الحفيد التي قام بها في مجال علم المقاصد، وتبين نظرته المقاصدية، وفلسفته في الترجيح المقاصدي في النهي عن بعض البيوع في الشريعة الإسلامية.
أهداف البحث
تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها:
- بيان مكانة ابن رشد الحفيد في الفكر الإسلامي.
- توضيح معنى المقاصد عند ابن رشد الحفيد، ومدى اهتمامه بالمقاصد في فقهه، وموقفه من تعليل الأحكام.
- إبراز المقاصد الشرعية التي رجح ابن رشد بين الأحكام الفقهية بناء عليها، وإبراز معالم ذلك في الترجيح، في البيوع المنهي عنها.
أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث في النقاط الآتية:
- إبراز إسهامات ابن رشد التي قام بها في ميدان المقاصد الشرعية، من خلال الوقوف على المقاصد التي رجح بناء عليها.
- إن آراء القاضي ابن رشد الحفيد وترجيحاته المقاصدية ستبين لنا المنهج المقاصدي العميق الذي كان يرجح بناء عليه.
- آراء القاضي ابن رشد الحفيد تبين لنا كيفية توظيف المقاصد الشرعية للترجيح بين الأحكام في النوازل والمستجدات.
خطة البحث:
لقد جعلنا هذا البحث مكونًا من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وقسمناه على النحو الآتي:
المقدمة: وتشمل: التقديم السابق، وطبيعة الموضوع، وأهميته وأهدافه.
المبحث الأول: تعريف المقاصد عند الإمام ابن رشد الحفيد، والألفاظ ذات الصلة التي استخدمها، ومدى اهتمامه بها في فقهه وترجيحه، وموقفه من تعليل الأحكام.
المبحث الثاني: تطبيقات فقهية على الترجيح بالمقاصد الشرعية عند ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد “باب البيوع المنهي عنها”.
الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج.
المبحث الأول: تعريف المقاصد عند الإمام ابن رشد الحفيد، والألفاظ ذات الصلة التي استخدمها، ومدى اهتمامه بها في فقهه وترجيحه، وموقفه من تعليل الأحكام.
المطلب الأول: معنى المقاصد عند ابن رشد الحفيد
أورد ابن رشد الحفيد في كتابه عبارات توضح لنا فهمه للمقاصد الشرعية، سأعرضها، ثم أبين تعريفه ومفهومه للمقاصد.
1- قال ابن رشد “وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحقّ، والعمل الحق، والعلم الحق هو معرفة الله عز وجل، وسائر الموجودات على ما هي عليه، وبخاصة الشريفة منها، ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي، والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة، وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء..”[3]
2- وقال أيضًا: “فمن حرّفها بتأويل لا يكون ظاهرًا بنفسه، أو أظهر منها للجميع، فقد أبطل حِكمتها، وأبطَلَ فعلها المقصود في إفادة السعادة الإنسانيّة”[4]
3- وقال: “إن الشرائع ضرورية لسعادة الإنسان، وضرورية في وجود الفضائل الخلقية والفضائل النظريّة والصنائع العملية، فالإنسان لا حياة له في هذه الدار إلا بالصنائع العملية، ولا حياة له في هذه الدار ولا في الدار الآخرة إلا بالفضائل النظرية، وأنه ولا واحد من هذين يتم ولا يبلغ إلا بالفضائل الخلقيّة، التي تكون بمعرفة الله وتعظيمه بالعبادات المشروعة”[5]
فالظاهر أن ابن رشد أسّس فهمه للمقاصد بناء على فضائل السعادة، وليس على مفهوم المصلحة الذي اعتمد عليه أكثر العلماء في مفهومهم للمقاصد، ويرجع سبب ذلك لتأثر ابن رشد بالفلسفة الأخلاقية الأرسطية، بل إنه يُعدّ من الداعين للتوفيق بين الشريعة والفلسفة.
فمفهوم ابن رشد رحمه الله للمقاصد إيجابي، فهو يوجِّه إلى فعل كل خير ونافع، والابتعاد عن كل فعل فيه ضرر أو شر للإنسان، وعليه فإنه يمكن تعريف مقاصد الشريعة عند ابن رشد بأنها: التحلي بالفضائل النظرية والعمليّة التي يريدها الله تعالى من الناس؛ لتحصيل التقوى، التي توصلنا للسعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد التي استعملها ابن رشد الحفيد
استخدم ابن رشد مصطلحات وتعبيرات مختلفة، يُطلقها ويريد بها مفهوم المقاصد، من أبرزها: الحكمة والعلة والمعنى والمصلحة.
1- الحكمة: وهي المقصود من تشريع الحكم[6]، ويطلقها الأصوليون، على معنيين، الأول: المعنى المقصود من شرع الحكم، أي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، والثاني: المعنى المناسب لتشريع الحكم، أي الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علة[7].
والعلاقة بين الحكمة والمقاصد أنها كلمات مترادفة، حتى إن بعض المقاصديين يطلقون أحيانًا لفظ الحكمة على المقصد الجزئي، كقولهم حكمة النهي عن بيع المعدوم نفي الضرر والجهالة عن المشتري، وقد يطلقون الحكمة على المقصد الكلّي، كقولهم الحكمة من إرسال الرسل وتشريع الشرائع هي عبادة الله وحده، واجتناب الطاغوت[8].
وابن رشد يكثر من استخدام لفظ الحكمة، ويريد به الغاية من تشريع الحكم، وفهم ابن رشد للحكمة يدخل في مضمون تعريف الأصوليين للحكمة بأنها المقصود من تشريع الأحكام.
ومثال ذلك قوله: ” في مسألة خيار المجلس: “ووجه الترجيح أن يُقاسَ بين ظاهر هذا اللفظ والقياس؛ فيغلّب الأقوى، والحكمة في ذلك هي لموضع الندم”[9]، فالحكمة هنا بمعنى المصلحة.
2- العلة: وهي الوصف المؤثر في الحكم بوضع الشارع[10]، ويطلقها الأصوليون، ويقصدون بها ثلاثة معان، الأول: ما يترتّب على الفعل من ضرر أو نفع، والثاني: ما يترتب على تشريع الحكم من مصلحة ودفع مفسدة، والثالث: الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة العباد.
والعلاقة بين العلة والمقاصد هي أن العلة سبب الحكم، والوسيلة التي تؤدي إليه، وتكون المقاصد حكمة الحكم، والمصالح المترتبة على انبنائه على علته، وفي ذلك يقول الشاطبي: “وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر والإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي”[11].
فالعلة كانت تستخدم كمصطلح المقصد عند العلماء، وقد استخدمها ابن رشد كذلك، ومثاله قول ابن رشد في مقاصد تحريم ربا النّقود: “وأما الدينار والدرهم، فعلّة المنع فيها أظهر؛ إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح، وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضروريّة”[12]، وابن رشد هنا يقصد بالعلة السبب أي سبب المنع.
3- المعنى: وله معان اصطلاحيّة كثيرة بحسب ما يضاف إليه، وما يربطنا بموضوعنا هو تعريفه بأنه الحكمة المقصودة من الحكم[13]، والعلماء يعرِّفون المقاصد بأنها المعاني، كتعريف ابن عاشور للمقاصد بأنها المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عند ملاحظتها”[14]، فالعلماء يطلقون لفظ المعاني ويريدون به المقاصد الشرعية، وابن رشد سار على دربهم، ومن ذلك قوله في مسألة هل يجزئ المسافر صومه عند عدم أخذه برخصة السفر: “إن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له؛ وذلك لمكان رفع المشقة عنه، وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة”[15]، ويريد ابن رشد بالمعنى هنا أي المقصد.
4- المصلحة: تعددت تعريفات الأصوليون للمصلحة، لكن المعنى المتعارف عليه للمصلحة عندهم هو الذي يُعبَّر عنه بالحكمة أو المقصود المترتب على الحكم، مثل حفظ النفس المترتّب على مشروعية القصاص[16].
إنّ صلَة المصلحة بالمقاصد أنّ المصالح الشرعية هي نفسها مقاصد الشارع الحكيم ومراده؛ لأن المشرع قصد قيام المكلف بها من خلال الأحكام الشرعية، فهي مقاصد للشارع، ومصالح للمكلف في وقت واحد؛ إلا أنّ نفع هذه المصالح يعود إلى المكلف وحده، كما أن المصالح غير الشرعية ليست من المقاصد في شيء؛ لأن المقاصد تأباها، وكذلك الأدلّة الشرعية تردّها”[17].
وفقيهنا ابن رشد سار على درب من سبقه من العلماء، في استخدام المصلحة للدلالة على المقاصد الشرعية، ومثاله قول ابن رشد: “فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة؛ فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل، وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تُقتَل الجماعة بالواحد لتذرّع الناس إلى القتل بأن يتعمّدوا قتل الواحد بالجماعة”[18]، يتضح هنا أن ابن رشد أطلق لفظ المصلحة وأراد المقصد.
المطلب الثالث: مدى اهتمام ابن رشد بالمقاصد في فقهه
على الرغم من اشتهار ابن رشد بالحكمة والفلسفة؛ إلا أنه قد غلَب على منهجه الفقهي الميل الشديد إلى اعتماد النقل والأثر، والبُعد عن إحداث قول جديدٍ لم يُسبَق إليه، لكن أَثريّته تطبّعتْ بطابع مقاصديٍّ واضح، ونظرٍ مصلحيٍّ بارز، والتفاتٍ إلى غايات الأفعال ومآلاتها، دون جمود على المباني والظواهر، بحيث يمتلك ابن رشد رؤية مقاصديّة كليّة تنسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية، تستند إلى ثقافة فلسفيّة موسوعيّة، وهذا ما جعله يبحث عن الأهداف والحِكَم التي أرادها الشارع الحكيم.
وقد اتجهت نظرة ابن رشد في المقاصد إلى الإنسان بوصفه نواة الإصلاح الأولى، وحتى يكون مصدر خيرٍ لأمّته، فهو يرى أنّ الأحكام الشرعية جاءت لصلاح الإنسانيّة جمعاء، ولا يتأتّى ذلك إلا بصلاح الفرد، الذي بصلاحه يصلح المجتمع، وتتحقق خلافة الله في الأرض.
فابن رشد قد سبق الآخرين في هذه النظرة الأخلاقيّة الفلسفيّة للمقاصد، فهو لم ينطلق من إصلاح الواقع، ولكنه انطلق من إصلاح الإنسان الذي يصنع الواقع، وفي هذا النظر عمقٌ فلسفيٌّ بديع، وهو النظر الذي يتفق مع أحدث الآراء الإصلاحية المعاصرة[19]، فهو يرى أنّ المشرع الحكيم جاء ليُصلح الإنسان، عن طريق الأخلاق الفاضلة والفضائل الحسنة، التي هي دعائم الحياة، ولا تستقيم الحياة إلا بها، ولا تفسد إلا بالابتعاد عنها، وقد تطبّعتْ معظم ترجيحات ابن رشد وأقواله بالطابع المقاصدي المصلحي.
المطلب الرابع: موقف ابن رشد من تعليل الأحكام
معلومٌ أنّ الأحكام الشرعية تدور بين التعبد والتعليل، فيقولون هذا حكمٌ تعبّدي أي غير معقول المعنى، وهذا الحكم معلّل أي له علة وغرض معين إما بالتصريح به في النص الشرعي، أو يدركه الفقيه بالاستنباط؛ ويكون معلّلًا بما يتضمنه ويجلبه من مصالح، وبما يدفعه من مفاسد.
وابن رشد لم يخرج عن هذا التقسيم كثيرًا، وفي غالب الأحيان يقوم بذلك على سبيل النقل والحكاية لأقوال الفقهاء، ولعلّ ما تميّز به ابن رشد أنه لم يقصر تعليل الأحكام ومعقوليتها على المعاملات، بل أمضى نظره التعليلي في أحكام العبادات كما المعاملات، مُنبِّهًا على حكمتها والغرض منها، وهذا مما يُحمد لابن رشد[20]، فلا فرق عنده بين العبادات والمعاملات، ودائمًا ما ينتصر لمبدأ معقولية الأحكام الشرعية بإطلاق، مُعتبرًا التفريق عجزًا يلجأ إليه الفقيه عند فقره، حيث يقول: “وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم، فتأمّل ذلك”[21]، فضلاً عن أن ابن رشد يرى بأن الشريعة الإسلامية كلها جاءت لتحقيق أربعة أهداف ومقاصد تربوية عظيمة، سمّاها فضائل، وهي فضيلة العفة، وفضيلة العدل، وفضيلة الشجاعة، وفضيلة السخاء، وقد جاءت العبادات والمعاملات لتثبيت هذه المقاصد والفضائل داخل المجتمع وحمايتها.
ومن أمثلة ذلك في العبادات اختلاف الفقهاء في باب الزكاة في مسألة دفع القيمة في الزكاة، هل يجوز دفع القيمة بناء على التّعليل، كما هو مذهب أبو حنيفة، أم يلزم الوقف عند النصوص والإخراج من جنس المال تعبُّدًا، كما هو مذهب مالكٌ والشافعي؟[22]
ونرى بأنه إذا كانت أحكام العبادات تخضع للتعليل، فإن ما سواها من أحكام المعاملات يكاد يكون كلّه معَلّلًا بالأولى، وابن رشد يُؤيّد ويُثبت كون المعقولية والتعليل المصلحي أمراً سائداً في كل مجالات الشريعة، بل إنه يرى أن هذا هو الأصل المعَوَّل عليه، إلا إذا تعذّر على الفقيه استنتاجه وإدراكه، “كما أن القول بتعليل الأحكام سيؤدي إلى القول بأن الشريعة الإسلامية مبنية على مصالح العباد، وعندئذٍ لا بد من الأخذ بالمصالح في المسائل التي لا نصَّ فيه، وفق الضوابط والأصول الشرعية”[23].
فالتعليل يمثّل أساس القول بالمقاصد؛ فلا يمكن القول بوجود مقاصد إلا مع القول بأن أحكام الشرع معلّلة؛ ولهذا افتتح الإمام الشاطبي الجزء المخصص للمقاصد في كتابه الموافقات بالحديث عن مسألة تعليل الأحكام، قاطعًا بجريان التعليل في جميع تفاصيل الشريعة الإسلامية[24].
المبحث الثاني: تطبيقات فقهية على الترجيح بالمقاصد الشرعية عند ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد “باب البيوع المنهي عنها”.
المطلب الأول: بيع الثِّمار قبل بدوّ الصَّلاح[25]
بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تُخلَق أو بعد خَلْقِها، ثم إذا خُلِقتْ فلا يخلو أن تكون بعد الصِّرام أو قبله، ثم إذا كان قبل الصِّرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعده، وكلّ واحدٍ من هذين لا يخلو أن يكون بيعًا مطلقًا، أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع[26].
فأما بيعها قبل أنْ تُخلَق، فالعلماء مُجمِعون على عدم جوازه، عُدّ إنه من بيع ما لمْ يُخلَق، ومِن بيع السّنين والمعاومة المنهي عنه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ ، والمُزابَنةِ ، والمخابرةِ ، والمعاوَمةِ وبيعِ السِّنينَ[27]»[28]، وأمّا بيع الثِّمار بعد الصِّرامِ[29] فالكل مُجمعٌ على جوازه[30]، وأمَّا بيعها بعد أن تُخلَق، فأكثر العلماء على جوازه، على ما سنفصّله الآن، وعلى قول الجمهور بجواز بيعها قبل الصِّرام، فإن ذلك لا يخلو من أن تكون قبل الزّهو أو بعده، وبيعها ــ والحالة هذه ــ لا يخلو أن يكون بيعًا مطلقًا أو بشرط القطع، أو بشرط التبقية على ما ذكره العلماء، فأمّا بيعها قبل زهوّها فقد اتّفق العلماء على جوازه بشرط القطع[31]؛ لأن المعنى من النهي عن بيع الثمار حتى تزهو ويبدو صلاحها، هو خوف ما يصيب الثمار من الجائحة[32] قبل أن تَطيب، وبشرط القطع ينتفي هذا المعنى، وبه ينتفي الغرر أيضًا[33].
كما اتّفق العلماء أيضًا على عدم جواز بيعها بشرط التبقية؛ بسبب تعرضها للجوائح، التي تطرأ في الأكثر على الثّمار قبل أن تزهو أو يبدو صلاحها[34].
والبيع قبل الزّهو إذا ورد مطلقًا: هل يُحمَل على القطع، وهو الجائز المتّفق عليه، أم يُحمَل على التبقية المتفق على منعها؟
فالقاضي ابن رشد الحفيد يرى جواز بيع الثمار قبل الزهو إذا وَرَدَ البيع مطلقًا، ويُحمَل الإطلاق فيه على القطع، وهو الجائز، خلافًا لمذهب السّادة المالكيّة.
حيث قال رحمه الله: “فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين: الأول في جواز بيعها قبل أن يبدو صلاحها وتزهو، والثاني في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء، أو بمطلق العقد، وخلافهم في الموضع الأول أقوى من خلافهم في الثاني، أعني: في شرط القطع وإن أزهى، وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب؛ لأنه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين[35]، ولأنَّ ذلك أيضًا مروي عن عمر بن الخطاب، وابن الزبير.
أقوال العلماء في المسألة: اختلف العلماء في بيع الثمار قبل بدو الصَّلاح مطلقًا على قولين:
القول الأول: وبه قال الحنفية[36]، وهو قول ضعيفٌ عند المالكيّة[37]، وإليه ذهب ابن رشد الحفيد، حيث قالوا بجواز بيع الثِّمار قبل بدوّ صلاحها مطلقًا، ويَلزم المبتاع فيه القطع.
القول الثاني: وهو قول الجمهور، من المالكيّة[38]، والشافعية[39]، والحنابلة[40]، والإمام الليث والثوري[41]، حيث قالوا بعدم جواز بيع الثمار مطلقًا قبل بدوّ الصّلاح.
سبب الخلاف:
تردّد ورود البيع المطلق بهذه الصورة بين اقتضاء القطع؛ فيصير العقد المطلق كالذي شُرِطَ فيه القطع، وبين التبقية، فيصير كالذي شُرِطت فيه التبقية، فمن كان عنده حَمْل الإطلاق على القطع، أو أنَّ من شرط البيع تسليم المبيع، قال بجواز البيع قبل بدو صلاحها مطلقًا، ويلزم المشتري فيه قطع الثمار، ولا يجوز إبقائها على أصول البائع، ومن كان عنده أنّ الإطلاق محمولٌ على التبقية في هذه الصورة، أو أنّ النهي يتناوله بعمومه، قال بعدم جواز البيع[42].
الأدلّة:
أولًا: أدلة القول الأول، حيث استدلوا بأدلة، منها:
1- حديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن بَاعَ نَخلًا قَد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ»[43].
وجه الدلالة: إن المشرِّع الحكيم لَمّا جَعل الثَّمرةَ للمبتاع بالشّرط، دلّ على جواز بيعه مطلقًا؛ لأنه لم يقيّد دخولها في العقد عند اشتراط المشتري، بزهوها أو بدوّ صلاحها[44]
2- أن القطع شرط في بيع الثمرة؛ لما في التبقية إلى بدو زهوها وبدو صلاحها من الغرر، وعدم أمن الآفة أو العاهة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأَيْتَ إذا منَع اللهُ الثَّمرةَ بمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟»[45]، وباشتراط القطع لا يُتوقَّع حصول غرر، أو آفةٍ، أو عاهة.
ثانيًا: أدلة القول الثاني، حيث استدلوا بأدلة، منها:
1- حديث ابن عمر رضي الله عنهم «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يبدوَ صلاحُها نَهى البائعَ والمشتري»[46].
وجه الدلالة: إن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَّق الحكم بغايةٍ، وهذا يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدها، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن بيعِ الثّمر قبل بدوّ صلاحها، فتناول البيع المطلق، وغيره، ولَمَّا تبيّن أنّ النهي كان لمعنىً وسبب: وهو خوف ما يصيب الثمار غالبًا من الجائحة قبل أن تزهو؛ وجب حمل النهي على البيع المطلق، وبشرط التبقية[47].
وَرُدَّ عليه بأن هذا الحديث متروك الظاهر؛ وذلك لجواز البيع بشرط القطع، ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل الإدراك، ومزهية قبل الزهو، وإذا أُلزِم المبتاع قطع الثمرة في البيع المطلق، لم يكن ثَمّة غررٌ يُتوقع حصوله، أو آفة يُتوهم نزولها، فوجب القول بالجواز[48]
2- إنّ الإطلاق محمولٌ على العادة، والعادة في البيع المطلق تقتضي التبقية، للحديث السابق، فوجب حمل الإطلاق على التبقية الممنوعة[49]
الراجح:
بعد النظر في الأدلة التي استدل بها الفريقان نرى أن ما ذهب إليه الفريق الأول، بجواز بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها إذا ورد البيع مطلقًا، ومن غير شرطِ القطعِ أو التبقية، ويلزم المشتري القطع في الحال، وهو ما ذهب إليه القاضي ابن رشد الحفيد، هو القول الراجح؛ وذلك للأسباب الآتية:
1- لقوة ما استدلوا به، وسلامة أدلّتهم من الاعتراضات.
2- القول بالجواز جمعٌ بين الأحاديث الواردة، وإعمال الأدلة بالجمع بينها أولى من إهمالها، والجمع هنا ممكن، وذلك بإلزام المشتري بالقطع في الحال.
3- النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها نهيٌ لغيره، وهو الخوف ممّا يصيب الثمار المتبقية غالبًا من الهلاك؛ فاقتضى ذلك تصحيح العقد، بإلزام المشتري القطع حالًا.
وبعد النظر في رأي القاضي ابن رشد الحفيد، وترجيحه في هذه المسألة، جواز بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها إذا ورد البيع مطلقًا، من غير شرطِ القطعِ أو التبقية، ويلزم المشتري القطع في الحال، فإن فقيهنا ابن رشد قد ذهب إلى ترجيحه من باب المقاصد الشرعيّة، وقد برز هذا في نصِّ كلامِه، حيث أفاد بأن قول الكوفيون ــ الذين خالفوا الجمهورــ والذي يقول بجواز بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه إذا ورد البيع مطلقًا هو القول الأقرب؛ لأنه من باب الجمع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها، وليس من حكمة الشريعة الإسلامية تحريم هذا البيع لأجل ضررٍ، يُتوهّم أو يُتوقع حصوله مستقبَلًا، المتمثِّل في الخوف ممّا قد يصيب الثمر من الجائحة أو الهلاك، ومن القواعد الكلية المقررة شرعًا أنَّ الضرر يزال[50]، وتحريم مثل هذا البيع فيه ضررٌ على الناس، لأنه لو ألزم المشتري فيه بالقطع، سيكون الغرر فيها يسيراً، وقد تكون الحاجة ماسة إليها، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة الغرّاء مبنيٌّة على أنَّ المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضَتْها حاجة راجحة أُبيح المحرّم، فكيف لو كانت المفسدة منتفية[51]، وذلك بإلزام المشتري قطع الثمر حالًا، كما أنّ المفسدة إذا عارضَتْها المصلحة الرّاجحة، قُدِّمتْ عليها[52]، فيترجح القول بجواز بيع الثمار قبل زهوها وبدوّ صلاحها إذا ورد البيع مطلقًا من غير شرطٍ، ويلزم المشتري أو المبتاع القطع حالًا؛ وهذا من باب إعمال الأدلة الواردة، وتحقيق مصالح المكلفين، ورفع الحرج والضرر عنهم، ودفع المفاسد وجلب المصالح، ولا شك أن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، دفع المفاسد عن المكلفين، وجلب المصالح لهم، بل إن الشريعة كلها قائمة على دفع المفاسد وجلب المصالح، ولعل ابن رشد الحفيد قد لحظ هذا المقصد، ورجح بناء عليه، وتبعًا له، والله تعالى أعلم وأحكم.
المطلب الثاني: المقصد الشرعي من النَّهي عن تَلَقِّي الرُّكبان للبيع
إنَّ بيع تلقِّي الرُّكبان من البيوع المنهيّ عنها من أجل الضرر أو الغبن، والقاضي ابن رشد الحفيد ــ رحمه الله ــ يرى أن مقصد النهي عن تلقي الرُّكبان للبيع، إنّما هو لأجلِ البائع لِئلّا يَغبنه المتلقِّي؛ لأنه يجهل سعر البلد، وإذا وقعَ البيع، فربُّ السلعة بالخيار، إن شاء أنفذ البيع، وإن شاء ردّه، خلافًا لمذهبه المالكي.
حيث يقول القاضي ابن رشد: (وأما الشافعي فقال بأن المقصود من النهي إنما هو لأجل البائع؛ لِئَلّا يغبنه المتلقِّي؛ لجهل البائع بسعر البلد، وكان يقول: إذا وقع فربُّ السلعة بالخيار، إن شاء أنفذ البيع أو رده، ومذهب الشافعيّ هو نصٌّ في حديث أبي هريرة الثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «لا تلَقَّوا الأجلابَ فمن تلقَّى منْهُ شيئًا فاشترى فصاحبُهُ بالخيارِ إذا أتى السُّوقَ»[53])[54]
تحرير محلّ النزاع:
أولًا: اتفق العلماء على أنّ المتلقِّي للرُّكبان آثم، لأنَّه ارتكب منهيًا عنه؛ بنصِّ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أنه نهى تلقي الجلب»[55]، كما اتفقوا كذلك على أنه إذا حصل ذلك، فالبيع صحيح، ولا يبطل البيع؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فمن تلقَّى منْهُ شيئًا فاشترى فصاحبُهُ بالخيارِ إذا أتى السُّوقَ »[56]، فالشارع الحكيم جعل الخيار في ذلك البيع للبائع، إذا دخل السوق، والخيار لا يكون إلا في بيعٍ صحيح؛ لأنه لو كان فاسدًا لأُجبر البائع والمشتري على فسخه، فلما أَثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للبائع؛ ثبتت صحة البيع، حتى مع ورد نهي التلقي.
ثانيًا: اختلفوا في المقصد المفهوم من النهي في الحديث، هل هو لأجلِ مصلحة البائع، لإزالة الضرر الواقع عليه ممّن يخدعه بالتلقِّي، أم لأجلِ الإرفاق بأهل البلد؛ لكيلا ينفرد المتلقِّي برخص السلعة.
أقوال العلماء: اختلفوا على قولين:
القول الأول: وهو قول عند الحنفية[57]، وبه قال الشافعية[58]، والحنابلة في قول[59]، وهو قول القاضي ابن رشد الحفيد، حيث قالوا بأن المقصد من النهي إنما لأجل البائع، حتى لا يغبنه المتلقِّي؛ فيشتري منه بأرخص من سعر البلد؛ لأن البائع يجهل سعر البلد.
القول الثاني: وهو قول الحنفية[60]، والسادة المالكية[61]، والحنابلة[62]، حيث قالوا بأن المقصد من النهي إنما لأجل أهل البلد؛ حتى لا ينفرد المتلقِّي برخص السلعة دون أهل الأسواق.
الأدلة:
أولًا: أدلة القول الأول: استدلّوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا تلَقَّوا الأجلابَ فمن تلقَّى منْهُ شيئًا فاشترى فصاحبُهُ بالخيارِ إذا أتى السُّوقَ»[63].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جَعل الخيار للبائع إذا أتى السوق، إن شاء أنفذه، وإن شاء رده، فدلّ ذلك على أن النهي لأجل مصلحة البائع ومنفعته، وإزالة الضرر عنه ممّن يخدعه[64]
ثانيًا: أدلة القول الثاني: استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَلَقَّوا السِّلع حتّى يُهْبَط بهَا إِلى السُّوق»[65].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نهى عن تلقِّي الركبان، وجعل منتهى النهي هو أن تبلغ السلع الأسواق، فهذا إشعارٌ منه عليه الصلاة والسلام على أن المعنى في النهي، إنما لأجل مصلحة الناس ومنفعتهم[66].
الراجح:
وبعد النظر في أدلة الفريقين واستدلالاتهم، فإننا نرى أن الأدلة الواردة في النهي عن تلقي الركبان قوية، واستدلالاتها أيضًا تحتمل أن يكون المقصد من النهي لأجل مصلحة البائع حتى لا يغبنه المشتري؛ لأنه يجهل سعر سوق البلد، وتحتمل أن يكون مقصد النهي لأجل أهل البلد؛ حتى لا ينفرد المتلقِّي برخص السلعة دون أهل الأسواق؛ لكن الفيصل في ذلك هو السُّنة، فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخيار في يد البائع إذا أتى السوق، وفي هذا إشارة إلى أنَّ الوصف المناسِب لشرع الحكم، إنما لأجل مصلحة البائع، ومنفعته، ودفع الضرر الواقع عليه ممّن يخدعه بالتلقِّي؛ وعليه فإن القول الأول هو الأولى، وهو ما رجّحه القاضي ابن رشد الحفيد، والله تعالى أعلم.
فالقاضي ابن رشد الحفيد رأى بأن مقصد النهي عن تلقي الركبان إنما لأجل مصلحة البائع؛ لأنه لا يعرف سعر أهل البلد؛ فيغبنه المتلقِّي، مما يدفع المتلقِّي لأن يشتري البضاعة بأقل من قيمتها الحقيقية، عمّا هي عليها في الأسواق؛ فيوقع الضرر بالبائع بخداعه بسعر البضاعة، لأنه يجهل سعر أهل البلد، فيبيعه البضاعة بثمن أقل من قيمتها، فالمشرِّع الحكيم أعطاه الخيار هنا، إن شاء أنفذ البيع، وإن شاء رده؛ لأجل الغبن والضرر الواقع عليه، ومعلومٌ أن الشريعة جاءت لرفع الضرر والحرج والغبن والمشقة عن المكلفين، وهذا من أعظم مقاصدها، فابن رشد أعمل نظره المقاصدي، فتبيّن له أن المقصد من النهي عن تلقي الركبان، إنما هو لمصلحة البائع، خلافًا لمذهبه المالكي الذي يرى بأن مقصد النهي إنما لأجل مصلحة أهل البلد، ولكننا إذا أعملنا النظر المقاصدي المصلحي، فيمكننا أن نقول بأن مقصد المشرع الحكيم من البيوع حماية البائع والمشتري بشكل عام، واستقرار العقود على الوجه الصحيح لها؛ وعليه يمكن القول بأن مقصد الشريعة في النهي عن تلقي الركبان لأجل البائع والمشتري معًا، أي لأجل البائع الوارِد، ولأجل أهل المدينة معًا، وابن رشد نظر من هذا الباب؛ لكنه التفت واعتبر الخيار الذي أعطاه النبي للبائع، في الإمضاء أو الرد، فقال بأن النهي لأجل مصلحة البائع، والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث: إرشاد الحاضر للبادي عن سعر السوق
يرى القاضي ابن رشد الحفيد، أنه يجب على الحضري أن يُرشد البدويّ إلى ما فيه حظّه، وأن يخبره بسعر السُّوق، والنهي من باب غبن البدويّ؛ لأنه يرِدُ والسِّعر مجهولٌ لديه، وهو بالخيار إذا غبنه المشتري، خلافًا للمذهب المالكي.
قال ابن رشد: “والذين منعوه: اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل الحضر، لأنّ الأشياء عند أهل البادية أَيْسَر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أَرْخَص، بل أكثر ما يكون مجانًا عندهم أي بغير ثمن، فكأنهم رأَوا أنه يكره أن يَنصح الحضري للبدوي، وهذا مناقضٌ لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة”[67]
ثم بيَّن ابن رشد علة ذلك النهي فقال: “والأشبه أن النهي من باب غبن البدويّ؛ لأنه يَرِد والسعر مجهولٌ عنده، إلا أن تثبت هذه الزيادة[68]، ويكون على هذا معنى النهي في الحديث عن تلقي الركبان على ما تأوّله الإمام الشافعيّ، وجاء في الحديث الثابت، وهو أنه وإذا وقع فربّ السلعة بالخيار: إن شاء أنفذ البيع، وإن شاء ردّه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم «لا تتلقّوا الجَلبَ فمن تَلَقَّى مِنْه شَيئًا فاشْتَراه، فصاحِبُه بِالخيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ»”[69]
أقوال العلماء في المسألة: اختلفوا على قولين:
القول الأول: وهو قول السادة الحنفية[70]، والشافعية في الأصحّ[71]، والحنابلة[72]، وهو ما ذهب إليه ابن رشد الحفيد، حيث قالوا بأن البدوي إذا استشار الحضري واستنصحه فيما فيه حظه، فإنه يجب عليه إرشاده ونصحه.
القول الثاني: وهو قول المالكية[73]، والشافعية في وجه[74]، حيث قالوا بأنه يكره أن يرشد الحضري البدوي، وأن يخبره سعر السوق.
الأدلة:
أولًا: أدلة القول الأول: استدلوا بما يأتي:
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَة»[75].
2- ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُوا الناسَ يُصيبُ بعضُهمْ من بعضٍ، فإذا استَنْصحَ أحدُكمْ أخَاهُ فلْينصحْهُ»[76]
وجه الدلالة: وجوب النُّصح للمسلمين بما دلّ عليه الحديثان، والبدويّ من عامة المسلمين، فيجب إرشاده ونصحه إلى ما فيه حظّه، وأن يُخبَر بسعر السوق أيضًا[77].
ثانيًا: أدلة القول الثاني: واستدلوا بما يأتي:
1- حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزقُ الله بعضُهمْ من بعضٍ»[78]
ووجه الدلالة: أن إرشاد البادي إلى ما فيه حظّه، وإخباره بسعر السوق، فيه تضييق بما وسّعه الله على المسلمين، وارتكاب محظورٍ؛ لأنه لم يذرهم يصيب بعضهم من بعض، فدل على كراهته[79].
وَرُدَّ عليه بأن في الحديث زيادة تفرد أبو داود بروايتها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «دَعُوا الناسَ يَرزقُ الله بعضُهمْ من بعضٍ»[80]، وهي رواية ضعيفة.
وأُجيب عنه بأن هذه الزيادة عند الإمام مسلم، فدل على ثبوتها[81].
2- إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم «نهَى أنْ يَبيعَ حاضرٌ لبادٍ»[82]، والنهي يقتضي الفساد، أي: فساد البيع، فمن أشار إليه أو أخبره بالسعر فكأنّما باع له، وارتكب منهيًا.
ويُرَدُّ عليهم بأن الإشارة ليست بيعًا، ولا في معنى البيع؛ لعدم ترتُّب أحكام البيع عليها[83].
الراجح:
وبعد النظر في أدلة الفريقين وأوجه استدلالاتها، فإننا نرى بأن ما ذهب إليه الفريق الأول، ومعهم ابن رشد الحفيد، هو القول الراجح وهو: وجوب إرشاد الحاضر للبادي، وإخباره بسعر السوق، وذلك إذا استنصح؛ للأسباب الآتية:
1- قوة ما استدلوا به، وسلامة أدلتهم من الاعتراض.
2- أن القول بعدم إرشاد الحاضر للبادي، وعدم إخباره بسعر السوق، مُخالفٌ ومناقضٌ لما قَرَّرتْه الشريعة السمحة وقواعدها العامة، من أنَّ الدين النصيحة[84].
والناظر لترجيح ابن رشد الحفيد يُدرك أن ابن رشد قد أعمل في ترجيحه الجانب المقاصدي، والفكر المصلحي، حيث رجَّح ــ رحمه الله ــ وجوب إرشاد الحاضر للبادي إذا استنصح، ووجوب إخباره بسعر السوق، وذلك حتى لا يُغبَن المشتري البادي، لأنه يُقدِم على السوق والسعر مجهول عنده، وهذا واضح في نص كلام ابن رشد عندما قال: “والأشبه أنه من باب غبن البدويّ؛ لأنه يرد على السوق والسعر مجهول عنده”[85]، ولا شك أن عدم إرشاده وإخباره بسعر السوق فيه ضررٌ يقع عليه، والشريعة جاءت لرفع الضرر والغبن عن الناس، ثم القول بوجوب إرشاده، وإخباره بسعر السوق، يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية العامة، ومقاصدها السَّمحة، كوجوب النصح لمن استنصح من المسلمين؛ وذلك حتى لا يقع الناس في حرج أو مشقّةٍ، ولهذا يرى ابن رشد أيضًا أنّ المشتري بالخيار إذا غبنه البائع، إن شاء ردّ المبيع وأخذ ثمنه، وإن شاء أمضى، وهذا ينسجم مع روح الشريعة ومقاصدها العادلة، المتمثلة في استقرار معاملات الناس على وجهها الصحيح، مع عدم غبن أيٍ من البائع أو المشتري للآخر، وذلك لما قد يحصل من نزاعٍ بين البائع والمشتري إذا تبين لأحدهم أنه مغبون، أو قد فاتت عليه مصلحة كان بإمكانه أن يحققها.
وبناء على كل ما سبق: فإن بيع الحاضر للبادي من البيوع المنهيّ عنها لأجل الضرر والغبن، وترجيح ابن رشد في هذه المسألة كان ترجيحًا مقاصديًا واضحًا، ويمكننا أن نقول بأنّ ابن رشد استند في ترجيحه على عدد من القواعد المقاصدية، وقواعد الشريعة العامة، كقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الدين النصيحة، وقواعد رفع الحرج عامة، مع أنه خالف في ترجيحه مذهبه المالكي، مما يدل على أن ابن رشد لا يتعصّب لمذهبه المالكي، ويرجِّج بما يظهر عنده أنَّه الحقّ.
المطلب الرابع: الردّ بالعيب في العقود التي يتعاقبها الاسترجاع
هذه الأحكام أدرجها القاضي ابن رشد الحفيد، ضمن العيوب الحادثة عند المشتري في البيع المطلق، والقاضي ابن رشد الحفيد يرى أنَّ العقودَ التي يتعاقبها الاسترجاع، كعقد الرَّهن وعقد الإجارة، لا يمنع ذلك من الردّ بالعيبِ، إذا رجع إليه المبيع.
قال ابن رشد: “وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع، كالرّهن، والإجارة، فاختلف أصحاب مالك، فقال ابن القاسم: لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع، وقال أشهب: إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانًا بعيدًا، كان له الردّ بالعيب، وقول ابن القاسم أَوْلى”[86].
تحرير محل النزاع:
الرد بالعيب محلّ اتفاق بين العلماء في الجملة[87]، وقد اشترط العلماء للرد بالعيب شروطًا[88]:
1- ألّا يكونَ العيبُ حادثًا، وأن يكون أقدم من التَّعاقد.
2- ألّا يعلمَ المشتري بوجود العيبِ عند العقدِ والقبض.
3- عدم اشتراط البراءة عن العيبِ في المعقودِ عليه.
الأدلة:
يستدلّ على ثبوت الردّ بالعيب، بما يلي:
1- إجماع العلماء على ثبوت الردّ بالعيب[89]، ومستند إجماع العلماء هو الاستقراء التام من النُّصوص الشرعيَّة، القاضية بتحريم الغشّ في البيع، والخيانة فيه، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من إيجاب العدل والمساواة، والبيان والصدق، والأمانة في العقود، واجتناب الغبن والغرر والجهالة، وإزالة الضرر، ورفع الحرج والمشقّة، ومن هذه النُّصوص قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:29]، ولا شك أن كتمان العيوب في العقود، وإخفائها وعدم بيانها، من الباطل، والذي يُرَدّ به المبيع.
2- العرف والعادة، حيث قام العرف السّليم على ثبوت الردّ بالعيب في المبيع، لأن من مقتضَى العرف، وما اعتاد الناس عليه سلامة المعقود عليه “المبيع”، من العيوب النادرة والطارئة، كما أن الناس قد تعارفت على أن وجودها يوجِب ردّ المبيع.
ولا شك أنَّ ثبوت الردّ بالعيب يحقّق مقاصد الشريعة الإسلامية، من إزالة الضرر عن المشتري، إذا تبيّن أن هناك عيباً في المبيع، ويرفع الحرج عنه، كما يحقق مقاصد الشريعة العليا، المتمثلة في تحقيق العدل والمساواة، ونبذ الخيانة، وكلّ أمرٍ من شأنه أن يوقع العداوة بين المتعاقدين، وهذا ما قام عليه العرف بين الناس، وجرت عادة الناس عليه، استنادً للقواعد المقاصدية: المعروف عرفًا كالمشروط شرطً، والعادة محكمة، وغيرها، فالقول بردِّ المبيع في العقود التي يتعاقبها الاسترجاع قولٌ حكيم، يحقّق مقاصد الشريعة الإسلامية الغرّاء، وتستقيم به معاملات الناس ومصالحهم، وهذا ما رجّحه القاضي ابن رشد الحفيد رحمه الله وطيّب ثراه، وهو ما نراه راجحًا، والله تعالى أعلم وأحكم.
وبالنظر لهذه المسائل السابقة: نرى أن ابن رشد قد أعمل فيها الفكر المقاصدي المصلحي، واستندت ترجيحاته إلى قواعد مقاصدية عظيمة من أهمها: قاعدة البيوع المنهي عنها إنما تكون من أجل الضرر والغبن، وهذه أم القواعد المقاصدية في النهي عن تلك البيوع عنده، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة دين الله يسر، وقاعدة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة الدين النصيحة.
الخاتمة:
اشتمل هذا البحث على عدد من النتائج والتوصيات، على النحو الآتي:
أولًا: نتائج البحث:
- إن مفهوم المقاصد عند ابن رشد هي: التحلِّي بالفضائل النظرية والعمليّة التي يريدها الله تعالى من الناس؛ لتحصيل التقوى، التي توصلنا للسعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة.
- إن القاضي ابن رشد الحفيد يرى أنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لتحقّق أربعة مقاصد أساسية، سمّاها فضائل، وهي فضيلة العفّة، وفضيلة العدل، وفضيلة السخاء، وفضيلة الشجاعة.
- يتنازع القاضي ابن رشد مؤثران في فهمه للمقاصد: المؤثّر الفلسفي، والمتمثّل بمقصد الشريعة الإسلامية العام في تحصيل فضائل السعادة، أي الأخلاق الفاضلة التي تجلب السعادة للإنسان، وهي الغالب عنده في الفهم، والمؤثّر الشرعي، وهو الذي يردّه لدائرة الشريعة، فيتكلم بلغة المصلحة الشرعية، ويصرّح أن الشريعة مبنية على رعايتها للمكلفين.
- يعبر القاضي ابن رشد عن مقاصد الشريعة الإسلامية بألفاظ وتعبيرات مختلفة، وهي: الحكمة، والعلّة، والمصلحة، والمعنى.
- إن القاضي ابن رشد الحفيد قد بنى مذهبه في الترجيح المقاصدي، على قواعد مقاصدية عدة، تبيّنتْ لي أثناء دراستي لآرائه الفقهية، في البيوع المنهي عنها، وهي: قاعدة البيوع المنهي عنها تكون من أجل الضرر والغبن، وهي عمدة القواعد المقاصدية في البيوع المنهي عنها عنده، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة دين الله يسر، وقاعدة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة الدين النصيحة.
- إن القاضي ابن رشد ينتصر لمبدأ معقولية الأحكام الشرعية بإطلاق، فيذهب إلى تعليل أحكام الله تعالى في بابي العبادات والمعاملات على حدٍّ سواء، ويؤيِّد كون التَّعليل والمعقوليَّة والمصلحيَّة، أمرٌ سائد في جميع مجالات الشريعة الغراء، بل إن هذا هو الأصل عنده؛ إلا إذا تعذّر على الفقيه، أو عجز عن إثباته.
- استطاع القاضي ابن رشد إعادة ربط الأحكام الشرعية بمنظومة القيم والأخلاق، والمبادئ الإنسانية، مما جعله يتجاوز النظرات الجزئية القاصرة لبعض الأحكام والنصوص، ويُحكم الصلة الوثيقة بين الفقه الإسلامي والأخلاق.
ثانيًا: أهم التوصيات:
- يوصي الباحث طلبة العلم الاهتمام بدراسة مقاصد الشريعة الإسلامية، دراسة تحليلية تطبيقية، كما فعل ابن رشد في كتابه، حتى لا تبقى القواعد المقاصدية تُحلِّق في سماء التَّنظير، إذ لا يصح تشريع الأحكام دون الالتفات لمقاصد الشريعة الإسلامية، وتلك المعاني التشريعية التي أرادها الله تعالى من المكلفين.
- يوصي الباحث طلبة العلم بدراسة البعد الأخلاقي، والقيمي للفقه الإسلامي، وربط الأحكام الشرعية بالأخلاق والنوايا، الأمر الذي يجعل الفقه الإسلامي مواكبًا لتطورات الحياة، بحيث يكون للفقه الدور الأكبر في ضبط وحماية النظام الأخلاقي والقيمي للمسلمين، وبهذا يرجع للفقه مكانته وقوته، في ظل العالم الحديث.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم
- الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، القاهرة: دار ابن عفان، ط1، 1417ه/1997م.
- ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية، حمادي العبادي، دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر، ط1، 2013.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد. القاهرة: دار الحديث للطباعة والنشر، 1325ه/2004م.
- المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد، أحمد الريسوني، ورقة بحثية مقدمة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في يوم دراسي حول العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد، 1998م.
- الفكر المقاصدي عند ابن رشد، د. الشيماء السيد محمود علي، المنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط1، 1443ه/2022م.
- اختيارات ابن رشد الحفيد الفقهية في بداية المجتهد، أحمد بن الأمين العمراني، بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1432ه/2011م.
- سنن ابن ماجه، أبو عبد الله ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، بيروت: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430ه/2009م.
- الموطأ، الإمام مالك بن أنس، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث، 1406ه/1985م.
- صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دمشق: دار ابن كثير، ط1، 1423ه/2002م.
- الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، تحقيق: مشهور آل سلمان. القاهرة: دار ابن عفان، ط1، 1417ه/1997م.
- مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر ابن عاشور، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، 1427ه/2006م.
- قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة، عبد الرحمن الكيلاني، دمشق: دار الفكر، ط1، 1421ه/2000م.
- الاجتهاد المقاصدي: حجيته وضوابطه ومجالاته، نور الدين الخادمي، سلسلة دورية تصدر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر: كتاب الأمة، ط1، 1419ه.
- فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ابن رشد الحفيد، تقديم: ألبير نادر. بيروت: دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، ط2.
- تعليل الأحكام، محمد شلبي، مصر: مطبعة الأزهر، 1947م.
- المحصول في علم الأصول، الرازي، تحقيق: طه العلواني. الرياض: ط: جامعة الإمام محمد بن سعود، ط1، 1400ه.
- الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، تحقيق: د. سيد الجميلي. لبنان: دار الكتاب العربي، ط1، 1404ه.
- الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي، محمد عاشوري، رسالة ماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 2007/2008م.
- علم المقاصد الشريعة، نور الدين الخادمي،الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1421ه/2001م.
- المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1423ه.
- المغني، ابن قدامة المقدسي، الرياض: دار عالم الكتب، ط3، 1417ه/1996م.
- كشاف القناع، البهوتي، بيروت: دار الفكر، 1402ه/1996م.
- روضة الطالبين، النووي، بيروت: طبعة المكتب الإسلامي، ط2، 1405ه.
- شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي. الدمام: دار ابن الجوزي، ط3، 1423ه/2002م
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415ه.
- المسالك شرح موطأ مالك، أبو بكر بن العربي، تحقيق: محمد السليمان وآخرون. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1428ه/2007م.
*********************************************
لتحميل العدد 14 أو أي بحث ضمنه:
——————–
لقراءة جميع الأعداد مع تفاصيل الأبحاث ضمنها:
——————-
لتحميل جميع الأعداد المنشورة من (مجلة المرقاة المحكمة) بنسخة pdf:
[1] حسان أحمد عبدالله النجار: طالب دكتوراه، وباحث في مجلس الاجتهاد الفقهي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ غزة ـ فلسطين، د. غالية بو هدة: أستاذ الفقه وأصوله في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.
[2] حمادي العبادي، ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية (دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر، ط1، 2013م)، ص9.
[3] ابن رشد، فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تقديم: ألبير نادر، (بيروت: دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، ط2)، ص49،50.
[4] المصدر نفسه، ص56.
[5] ابن رشد، تهافت التهافت، تحقيق: موريس بويج، (بيروت: دار المشرق، ط2، 1987م)، ص581.
[6] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، (بيروت: المكتب الإسلامي)، ج3، ص224.
[7] محمد شلبي، تعليل الأحكام، (مصر: مطبعة الأزهر، 1947م)، ص136. ينظر: عبد العزيز الربيعة، السبب عند الأصوليين، (الرياض: ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1980م)، ج2، ص16.
[8] المصدر نفسه، ص22.
[9] المصدر نفسه، ج3، ص189.
[10] الرازي، المحصول في علم الأصول، تحقيق: طه العلواني، (الرياض: ط: جامعة الإمام محمد بن سعود، ط1، 1400ه)، ج5، ص190.
[11] الشاطبي، الموافقات، ج1، ص216.
[12] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: فريد الجندي (القاهرة: دار الحديث،1425ه/2004م)، ج3، ص152.
[13] قطب سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مراجعة: محمد قلعجي، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 2000م)، ص424.
[14] ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص49.
[15] ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص58.
[16] ينظر: زين الدين العبد نور، رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة والاستحسان، (السعودية، دار إحياء التراث، ط1، 2004م)، ص26.
[17] ينظر: الخادمي، نور الدين، علم المقاصد الشرعية، ص23.
[18] ابن رشد، بداية المجتهد، ج4، ص182.
[19] ينظر: العبيدي، حمادي، ابن رشد وعلوم الشريعة، ص104.
[20] ينظر: الريسوني، أحمد، المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد، ورقة بحثية مقدمة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ضمن ندوة العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد، منشورات المعهد العالمي للفكر الاسلامي، الطبعة الأولى، 1998م، ص28.
[21] ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص91.
[22] المصدر نفسه، ص736.
[23] د. الشيماء السيد علي، الفكر المقاصدي عند ابن رشد، (المنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط1، 1443ه/2022م)، ص114.
[24] ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص4، ص5.
[25] وهو من البيوع المنهيّ عنها من جِهة الجهل الذي سببه الغرر، ويوجد الغرر في المبيعات من قِبَل الجهل على أوجه: الأول، من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو الجهل بوصف المبيع، أو قدره، أو أجله، والثاني، من جهة الجهل بوجوده، أو تعذّر القدرة عليه بسبب تعذّر التّسليم، والثالث، من جهة الجهل بسلامته أو بقائه. ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص166.
[26] المصدر نفسه، ج3، ص168.
[27] بيع السنين أن يبيع ثمر الشّجر أو النّخلة لعام أو عامين فأكثر، وبيع المعاومة أن يبيع ثمر الشّجر أعوامًا. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422ه/2001م)، ج2، ص1023، ج3، ص608.
[28] الإمام مسلم، صحيح مسلم،كتاب البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، ص666، ح1536.
[29] الصُّرامُ، من الصّرم وهو القطع، وهو قطع الثمرة واجتناؤها من النَّخلة. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج3، ص48.
[30] الزيلعي، تبيين الحقائق، ج4، ص295.
[31] المصدر نفسه، ج4، ص295. ابن رشد، بداية المجتهد، ج3، ص168.
[32] الجائحة، هي ما تصيبُ الثَّمر من الآفات والعاهات السماويَّة؛ فتُهلكها كلّها أو بعضها. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج1، ص834.
[33] ابن رشد، بداية المجتهد، ج3، ص168.
[34] الزيلعي، تبيين الحقائق، ج4، ص495. محمد بن علي الحصفكي الحنفي، الدر المختار، ج5، ص399. ابن رشد، بداية المجتهد، ج3، ص168.
[35] الحديث الأول: ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يبدوَ صلاحُها نَهى البائعَ والمشتري» متفق عليه. ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ص380، ح2194، واللفظ له. ينظر: الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، ص660، ح1034. والحديث الثاني: هو ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، أن صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بَاعَ نَخلًا قَدْ أبّرتْ فَثَمَرتها للبائع، إلّا أَن يَشْتَرطَ المُبتَاع»، متفق عليه، واللفظ لهما. ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب: إذا باع نخلًا قد أبرت، ص482، ح2716. ينظر: الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب: مَنْ باع نخلًا عليها ثمر، ص664، ح1543.
[36] الزيلعي، تبيين الحقائق، ج4، ص495. محمد بن علي الحصفكي الحنفيّ، الدر المختار، ج5، ص399.
[37] الباجي، المنتقى، ج4، ص218.
[38] القاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة، ج2، ص39.
[39] الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص88،99.
[40] ابن قدامة، المغني، ج6، ص148.
[41] ابن رشد، بداية المجتهد، ج3، 168، 169.
[42] المصدر نفسه، ج3، ص169.
[43] المصدر نفسه، ج3، ص169.
[44] الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص367.
[45] متفق عليه. ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، ص381، ح2198، واللفظ له. مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح، ص675، ح1555.
[46] متفق عليه، تقدم.
[47] ابن رشد، بداية المجتهد، ج3، ص169.
[48] الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص367.
[49] الباجي، المنتقى، ج4، ص219.
[50] الإمام السيوطي، الأشباه والنظائر، ص173.
[51] ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج6، ص459.
[52] المصدر نفسه، ج6، ص459.
[53] الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، ص656، ح1519.
[54] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص183،184.
[55] الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، ص656، ح1519
[56] المصدر نفسه، ص656، ح1519.
[57] الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص149.
[58] النووي، روضة الطالبين، ج3، ص413.
[59] ابن قدامة، المغني، ج8، ص403.
[60] ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، ج6، ص478.
[61] المواق المالكي، التاج والاكليل، ج5، ص195.
[62] ابن قدامة، المغني، ج6، ص312،313.
[63] أخرجه مسلم، تقدم تخريجه.
[64] ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج4، ص684. ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص183. البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص211.
[65] الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان، ص376، ح2165.
[66] الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص149. المواق المالكي، التاج والاكليل، ج5، ص195.
[67] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص184.
[68] رواية عن جابر رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يبع حاضر لبادٍ، دَعُوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». ينظر: الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، ص656، ح1522.
[69] الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، ص656، ح1519.
[70] الإمام الطّحاوي، شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1399ه)، ج4، ص11.
[71] النووي، روضة الطالبين، ج3، 414.
[72] ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، (بيروت: المكتب الاسلامي، 1400ه)، ج4، ص47.
[73] ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من لمعاني والأسانيد، ج18، ص197.
[74] زكريا الأنصاري، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ومعه حاشية الشربيني، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه/1998م)، ج9، ص24.
[75] الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان أنّ الدين النصيحة، ص51، ح55، عن تميم الداري.
[76] الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعُوا الناسَ يُصيبُ بعضُهمْ من بعضٍ» ج3، ص418، ح15029. قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح الجامع، ج2، ص385.
[77] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص184.
[78] مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، ص656، ح1522.
[79] ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، ج18، ص197. النووي، روضة الطالبين، ج3، ص414.
[80] مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، ص656، ح1522.
[81] المصدر نفسه، ص656، ح1522.
[82] المواق المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج7، ص45.
[83] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج4، ص435.
[84] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص184.
[85] المصدر نفسه، ج3، ص184.
[86] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص197.
[87] ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص394. جلال الدين بن شاش، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، (بيروت: دار الغرب الاسلامي، ط1، 1415ه/1995م)، ج2، ص679ــ680. الشيرازي، المهذب، ج2، ص85. ابن قدامة، المغني، ج6، ص226. ابن حزم، المحلّى، ج11، ص413.
[88] ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص548. الشيرازي، المهذب، ج2، ص84.
[89] الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص394. جلال الدين بن شاش، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، (بيروت: دار الغرب الاسلامي، ط1، 1415ه/1995م)، ج2، ص679ــ680. الشيرازي، المهذب، ج2، ص85. ابن قدامة، المغني، ج6، ص226. ابن حزم، المحلّى، ج11، ص413.