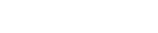بقلم: د. شاكر مصطفى
ذات يوم من صيف 1969 كنت في المكتبة الشرقية في بيروت، أختار بعض الكتب الفرنسية حين وقع لي كتاب صغير من مائتي صفحة، اسمه الإسلام والصليبيات، لمؤلف لم أسمع به بين العلماء، اسمه عمانويل سيفان، ووضعت الكتاب بين ما اخترته من الكتب، وسألني الكتبي، وهو يضع قائمة الحساب: هل أصر عليه؟ إنه غال؟ .. ووافقت، فموضوعه ضمن اهتماماتي، لكني لم أتصور أن يكون الثمن في ذلك العهد أربعين ليرة لبنانية، وأعترف أني صدمت، ولم أستطع التراجع، فكان أول ما فعلت ذلك اليوم أن أرى ما في هذا الكتاب.
وفوجئت فيه بعدد من الكشوف، لو دفعت ثمنها الآلاف لكان ذلك رخيصاً رخيصاً: أولها: أن الجماعات اليهودية التي تحتل فلسطين تدرك تشابه غزوها واحتلالها للبلاد مع الغزو والاحتلال الصليبين، تدركه بوضوح وتعالجه جدياً في المنظور العلمي كتجربة رائدة، وثانيها: أنها تدرس الموقف، وفي الشرق العربي الإسلامي، في جذوره، وتحلل عناصره لتتفادى نهاية كنهاية حطين وما بعد حطين، وثالثها: ولعل الأهم، أن ثمة فرق عمل كاملة في الجامعة العبرية، تتخصص في هذا الموضوع، وعلى رأسها جوزيف براور صاحب كتاب تاريخ المملكة اللاتينية في القدس (وهو في مجلدين بالعبرية نشر سنة 1963). وتستعين هذه الفرق بالعلماء المتصهينين في الجامعات الغربية لهذا الغرض، فلهم مراكز بحث ومستشارون في جامعة باريس لدى العالم اليهودي كلود كاهن، وفي الجامعات الأخرى الأمريكية أمثال: آشتور شتراوس، وبرونشفيك، وكيستر، وأيالون المختص بالعصر المملوكي، وغريتاين الذي كتب عشرات الأبحاث حول قدسية القدس والصليبيات واليهود والإسلام.
هذه النقلة من الغزو الصليبي إلى الغزو الصهيوني وبالعكس، يجد فيها اليهود الغارقون في التوراة، وفي الحق التاريخي، طقساً من طقوس العبادة، إنها عندهم نقلة بين التاريخ وبين المستقبل، وليست تهمهم الصليبيات بالطبع بوصفها صليبيات، وإنما تهمهم بوصفها رموزاً تاريخية، وبوصفها إسقاطاً على المستقبل، زاوية اهتمامهم محصورة فيها في نقطة وحيدة كيف تم طرد الصليبيين من هذه البقاع نفسها التي يحتلونها؟ لهذا لا يهمهم بحثها الذي قتله الغربيون بحثاً، ولكن تهمهم الرمال المتحركة تحت الغزاة في فلسطين وحول فلسطين، الاستيطان ووسائله في الأرض هي الهاجس المؤرق، إن جذور الحاضر موجودة في الماضي، وممدودة إلى المستقبل، دراساتهم كلها ها هنا محورها.
إنهم يدرسون معنى الجهاد، وكيف استيقظ في المشرق العربي، ومدى حيويته في الشام بالذات، وتأثير فكرة الجهاد قبل الصليبيات وأثنائها وبعدها، يحللون مدى قدسية القدس وعناصرها في نقوس المسلمين، وردود فعلهم ضد الاحتلال الغريب، يرون كيف تمت الهدنات، وتم التعايش الفرنجي- الإسلامي أولاً، وكيف انقلب ذلك حروباً وجهاداً من بعد، رغم تطاول الزمن، كيف تحول مفهوم الجهاد القديم فحل في مفاهيم جديدة ألهبت الناس يبحثون عن مرتكزات الدعاية التي حولته دينياً إلى عنصر كره للفرنج، وعن جذور الترابط في المنطقة من مصر إلى العراق، وعن أسباب توحدها في حطين وما بعدها، بل يحللون “نصر” عين جالوت ضد المغول، ويلحقون بالتحليل الفتاوى الشرعية، ويحللون أسباب سقوط عكا الأخير سنة 1921، وخروج آخر الصليبيين على آخر المراكب من المشرق، يبحثون عن أسباب ذلك وجذوره حتى في لاوعي الشعب نفسه.
ولاحقت أعمال الجماعة الصهيونية في الأسئلة التي تطرحها، فإذا بين هذه الأسئلة:
1- لماذا لم تستيقظ فكرة الجهاد في العصر الحمداني إلا على الثغور والحدود، رغم دعاية سيف الدولة ورغم خطب ابن نباتة وأشعار المتنبي؟ ولم استيقظت في العصر الصليبي في دمشق وحلب خاصة
2- لماذا أخذ الجهاد الشكل الدفاعي السلبي والمحدود قبل الصليبيات؟ ثم أخذ الشكل الهجومي الواسع بعدها؟
3- كيف أقيمت الصلة بين فكرة الجهاد وبين قدسية القدس مع أنها لم تكن موضوع جهاد قبل ولا موضوع قدسية.
4- ماذا زادت الصليبيات من العناصر على قدسية القدس لدى المسلمين؟
5- لماذا كانت معركة (ملاذ كرد) سنة 1071 نصراً إسلامياً نسيه الناس بسرعة، مع أنها كانت معركة حاسمة أسر فيها امبراطور بيزنطة لأول مرة ولآخر مرة في التاريخ بيد سلطان السلاجقة ملك شاه، ولماذا لم تثر المعركة فكرة الجهاد لدى أهل الشام والعراق خاصة؟
6- لماذا لم يذكر علماء الإسلام في القرن الثاني عشر فكرة، “طلب الشهادة”، بين دوافع الجهاد؟ ولم يذكروا القدس؟ أن أعمال 12 عالماً في ذلك العصر لم تذكر ذلك، لم يذكرها إلا عالم داعية هو عز الدين السلمي في العهد الأيوبي، والإمام النووي أيام بيبرس.
7- ما موقف الشرع الإسلامي من الأموال الإسلامية التي تقع في يد الكفار؟ هل تبقى ملكاً للمسلم مهما طال العهد، أم هي غنائم للمتحابين؟ المذهب الحنفي وحده يجعلها غنائم، لكن استعادة القوى الإسلامية لتلك الأموال تعيدها إلى أصحابها، ومع ذلك فإن زنكي رغم أنه حنفي أعاد أملاك معرة النعمان سنة 1136 إلى أصحابها، وابنه محمود وهو مثله في الحنفية أعاد أملاك أعزاز سنة 1150 لأصحابها، فما تفسير ذلك؟
8- ما معنى ألا نجد لدى الشعراء الذين رثوا الدولة الحمدانية عند سقوطها أي ذكر الجهاد، ويذكر الكرم وحده؟
ولاحقت نصوص التراث الذي تتداولها المجموعة الصهيونية بالدراسة، فإذا التراث الذي نتصور أنه نائم في دمائنا وفي أدراجنا هو لديهم كيان كامل على المشرحة، يستنطقونه ويحكمون علينا من خلاله يدرسون:
1- خطب الجهاد منذ عهد الفتوح مروراً بالحمدانيين حتى العهد المملوكي.
2- كل الكتب التي ألفت في الجهاد، أو كتبت عنه، ويتوقفون بخاصة عند كتب الجهاد التي ظهرت قبيل العصر الصليبي وخلاله ومن بعده، وبخاصة عند كتاب الجهاد الذي ألفه علي بن ظاهر السلمي النحوي (المتوفى حوالي سنة 498- 499هـ) والذي كان يدرسه في دمشق في الجامع الأموي في 12 جزءاً إثر الاحتلال الصليبي للقدس مباشرة (وقد أخذوا صورة الكتاب من المكتبة الظاهرية ونشروا بعضه سنة 1966)، هذا الرجل كان أول من قال إن الحركة الصليبية واحدة في الأندلس وصقلية والشام، قالها قبل ابن الأثير بمائة سنة.
ويدرسون كذلك كتاب أحكام الجهاد وفضائله لعز الدين السلمي، وكتاب الجهاد مجهول من العهد نفسه، وكتاب الجهاد الذي وضعه القاضي بهاء الدين بن شداد لصلاح الدين الأيوبي ضمن كتابه دلائل الأحكام، فكان كتاب المخدة عنده لا يفارقه، ويتساءلون لماذا لم يضع ابن شداد في هذا الكتاب كلمة واحدة عن القدس؟ ولا قال هو ولا أحد قبله إن الجهاد من أركان الإسلام الأساسية إلا الخوارج وإلا علماء العصر المملوكي؟
3- بين ما يدرس الصهيونيون كل الكتب التي تتحدث في فضائل الشام والقدس ومقارنتها بمكة والمدينة، ويلاحظون أن الاسم في زيارة مكة هو الحج وفي القدس لا أكثر من زيارة، ويحللون في هذا السبيل خمسة وثلاثين كتاباً تتحدث في فضائل القدس والشام، ككتاب ابن الخوري (فضائل القدس الشريف)، وتقي الدين بن تيمية (قاعدة في زيارة القدس)، والكنجي الصوفي (فضائل بيت المقدس وفضل الصلاة فيها)، وشهاب الدين المقدسي (مثير الغرام في فضائل القدس والشام)، وأبي إسحاق إبراهيم المكناسي (فضائل بيت المقدس)، وعز الدين السلمي (ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام)، وابن المرجى (فضائل بيت المقدس والخليل)، وابن الفركاح إبراهيم الفزازي (باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس)، ومجير الدين العليمي (الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل).
4- وبين ما يدرسه الصهيونيون دواوين الشعراء، يلاحقون حتى الصغار منهم، لا يهملون المتنبي والمعري، لكنهم يدرسون الغزي، وديوان ابن النبيه، وابن الساعاتي، وابن الخياط، وابن سناء الملك، والبوصيري، وابن عنين، والبهاء زهير، وعمارة اليمني، والملك الأمجد، وسبط ابن التعاويذي، وغيرهم وغيرهم ممن عاشوا الفترة الصليبية لعلهم يكتشفون آثارها في قوافيهم.
5- ويدرسون مؤلفات العماد الأصفهاني، والقاضي الفاضل، والثعالبي، وابن جبير، ورسائل ضياء الدين ابن الأثير، وكتاب الإشارات للهروي، ورسائل ابن عبد الظاهر، وكتابات أسامة بن منقذ وخطب عبد الرحيم ابن نباتة.
6- ويدرسون كتب الفقه والفتاوى، بخاصة التي أصدرها العلماء، كالإمام النووي، وكتاب المغنى لموفق الدين بن قدامة.
7- ويدرسون ويسألون حتى السير الشعبية، ويرونها منجم المشاعر العميقة للجموع المتتالية، يرون فيها المرأة الحقيقية، فهل فتح أحد منا قصة الأميرة ذات الهمة (سيرة المجاهدين وأبطال الموحدين)، أو أسيرة عنترة، أو فتوح الشام للواقدي، أو فتوح الشام الأخرى للأزدي البصري، أو قصة علي نور الدين المصري مع مريم الزنارية، إنه سيرى فيها ما يكشفه الصهيونيون من المشاعر، إنهم يصلون حتى إلى تحليل النكات والنوادر، لماذا كل هذا العناء والجهد؟ ليس العلم وحده هو ما يقصدون، وإلا كانت لديهم آلاف المواضيع الأخرى الجديرة بالدراسة، إنهم يتحسسون في الصليبيات ونهايتها وجعهم، قلقهم، مصير الغد.
إن عقدة الصليبيات تلاحقهم، تؤرق استقرار المشروع الصهيوني كله، توغل وراءه فيوغل وراءها بحثاً ودرساً، السؤال الأساسي المطروح: كيف يتخلصون من مصير مملكة القدس الصليبية وتوابعها؟ كيف يأمنون من حطين أخرى مقبلة؟ .. كل قرون الاستشعار في هذا الأخطبوط الوحشي موجهة نحو الحروب الصليبية بالذات، يريدون أن يعرفوا كيف نبتت خيول حطين وامتطتها العواصف؟ وكيف عبرت مملكة القدس إلى التاريخ المنسي من الباب الخلفي فلم يبق لها من آثر؟ كان الناس عند وصول الفرنج إلى الشام أكواماً من الرمال ذرتها السيوف الصليبية مع الريح.
فكيف تحول مواطنو الريح هؤلاء إلى كتلة صخرية صلدة تحطم عليها الفولاذ الفرنجي فجأة ومرة واحدة، دايان قال سنة 1967 إن جيوشه انساحت خلال القوى العربية كالسكين في الزبدة، فهل تتحول الزبدة قنبلة تذهب بالسكين وصاحب السكين؟ هذا القلق المصيري سببه أن اليهود الغارقين في التاريخ والمعتمدين في استراتيجيتهم الدعائية على التاريخ يريدون أن يخرجوا من نفق التاريخ.
إسرائيل تبحث عن المستقبل وهي مندفعة بكليتها نحو الماضي: دينها، لغتها، رجالها، قيمها، تشريعها، صلواتها، شمعدانها، رموزها، وطواقي رجالها كلها موصولة مع الماضي بخيط عنكبوتي ممدود، لهذا تشكل الصليبيات جرحها الذي تريد أن تتجاوزه، إنها تريد التسلل من أحد الثقوب في التاريخ (وما أكثر الثقوب) إلى هذا العصر.
ويعرف الصهيونيون، يدرسون، يحللون كل التوازيات بين الصليبيات الغربية وبين الصهيونية، ويتوقفون عند النهاية المأسوية يريدون تفاديها، إنهم وهم المهرة في استخدام التاريخ ولي عنقه، يحاولون أن يهربوا من لحظته الأخيرة! فأين هذا التوازي وأين ينتهي؟
سآتي على التشابهات فقط وأترك التباينات القليلة، وهي ناجمة عن اختلاف العصرين، إن كل الاستراتيجية والتكتيك الصهيونيين موجودان في الصليبيات.
إنا لا نكاد نجد في التاريخ حركة كالحروب الصليبية كان نصيبها من الخيال وتأثير الأسطورة بقدر نصيبها من الآلام المآسي، إلا الحروب الصهيونية، والغريب أن مكان الكارثتين واحد، هو فلسطين، ولسنا نحتاج إلى أي جهد في التقاط التوازي الذي يصدم العين بين المغامرة الصليبية الفاشلة والمغامرة الصهيونية التي تقلدها، المغامرتان من نسيج واحد، يكفي أن نقرأ قصة إحداهما لتقفز الأخرى أمامك على الأسطر، على كل سطر وفي النقاط والفواصل، وإن شئت تحركت في الحديث قافزاً من هذه إلى تلك ومن تلك إلى هذه دون أن تحس بأنك تقفز 800 أو 900 سنة بعواصفها وأثقالها، دعونا نمش في المغامرتين خطوة خطوة، إن التشابه يبدأ هنا منذ الخطوة الأولى.
أولاً: القضية الصهيونية في منظورها الشامل إنما هي مشكلة أوروبية داخلية خالصة، وجدت حلها في عمل خارجي وعلى أرض خارج أوروبا، والقضية الصليبية بدورها إنما هي مشكلات أوروبية داخلية بدورها حلت على الطريقة ذاتها، التكاثر السكاني قبل الصليبيات مع تدهور الزراعة وانتشار المجاعات وكوارث الطبيعة والأوبئة سنوات طويلة بعد أخرى، وتعاظم المشاعر الدينية، إضافة إلى الظلم الإقطاعي وتراكم الديون الربوية وكثرة الفرسان، ولا أرض للفرسان فيما الحروب الداخلية تفترس الأمن والبشر، كل ذلك كوّن مشكلة التكاثر السكاني وحقد الأوروبيين على اليهود المرابين ومشكلات العمال الفقراء في شرق أوروبا والزحام القومي الهتلري وكلها غارقة في الجذور الاقتصادية بإلقاء هذه الفضلات البشرية- في نظرها من النافذة على الجيران!
ثانياً: ونمضي خطوة أخرى، لنرى أن الحركة الصليبية شملت كل أوروبا، في الصليبيات تحركت جموع شتى من مختلف الأمم الأوروبية من السويد والنرويج، من إنكلترا وفرنسا ومن ألمانيا والدانمرك وقلب المجر، كلهم تحركوا نحو إغراء المشرق! لم تكن الحركة ثماني حملات كما يزعمون، كانت مدداً لا ينقطع، وسيلاً من البشر يتحرك على السفن وفي البر مدار السنوات المائتين التي امتدتها الحروب، قد تكون الحملات بدورها أكثر من مائتين أو ثلاثمائة حلمة صغيرة وكبيرة لبضعة ملايين، بعضهم حجاج، وبعض محاربون، وكثير منهم تجار أو مغامرون، وأكثرهم فقراء، الكل نزحوا وراء حلم يمتزج فيه المسيح برفيف الذهب، هل يذكركم هذا بمجموعة الأمم التي تحشد منذ مائة سنة في فلسطين، بابل القرن العشرين، لغات وأجناساً وعادات ومن كل زوج غير بهيج؟ وتحشد وراء حلم يمتزج فيه الإله يهوا بطائرات الفاتنوم؟
ثالثاً: وكما انتصب للصليبيات قائد فكري في شخص البابا أوربان الثاني، الذي أعلن الحركة في مجمع كليرمون سنة 1095، وحدد لها الطريق والهدف النهائي: فلسطين أرض المسيح، أطلقها وترك لمن بعده المسير بها وتحمل عقابيها، كذلك كان للصهيونية رائدها الفكري في شخص ثيودور هرتزل، الذي كتب لها كتاب الدولة اليهودية سنة 1896، ثم أعلن مع المؤتمر الصهيوني الأول سنة 1897 في بال أن مكان هذه الدولة هو فلسطين: أرض إسرائيل، كان هرتزل هو بابا الصهيونيات، أطلقها وترك للآخرين مهمة التنفيذ.
رابعاً: ونصل إلى العامل الديني في الحركتين الصليبية والصهيونية، لنرى أشكالاً لا تنتهي من التوازي والتشابه تحتاج إلى التوقف الطويل والتعداد الطويل:
أ- ما الذي رفعه الصليبيون هدفاً، وما الذي رفعه الصهيونيون؟ شعار واحد رفعه الطرفان الصليبيون تحركوا لتخليص القبر المقدس، والصهيونيون تحركوا لتخليص الهيكل المقدس، ولو أنه لم يبق منه إلا في الذاكرة التوراتية شيء على الأرض! الإيديولوجية التي رفعت في المشروعين واحدة، وراء كل من الشعارين حينئذ لا ينتهي من المشاعر الدينية المتقدة، ولكنها تتمركز في النهاية في كلمة محددة، وفي نقطة من الأرض محددة بدورها، وكما سمي الصليبيون فلسطين أرض المسيح يعنون بذلك أنها أرضهم، كذلك يقول الصهاينة إنها “أرتز إسرائيل” أرض الميعاد، بوعد توراتي لا يزول.
ب- إذا كانت الحرب الصليبية أول حرب إيديولوجية، بعد الفتوح الإسلامية، وكانت هذه الإيديولوجية دينية بالضرورة، ولم يكن بالإمكان تحريك الجموع في العصور الوسطى الغارقة في الدين دون إيديولوجية دينية، فإن هذه الإيديولوجية نفسها قد استخدمت من قبل الصهيونية في تحريك آخر جماعة متحجرة مغلقة من الجماعات الأوروبية، وهم اليهود، للغرض نفسه في الحرب الصهيونية القائمة، محو الإثارة عند الطرفين هي فلسطين والقداسة فيها للقبر أو للهيكل.
ج- لم تحمل الحروب الصليبية هذا الاسم الديني أبداً لا في عهدها ولا بعده، في القرن السابع عشر ولأسباب تبريرية دينية شاع هذا الاسم ليغطي برداء الصليب فترة مائتي سنة من المآسي والحروب ليس لها ما يبررها، المسلمون الذين عاصروها والكاثوليك الغربيون الذين شنوها كانوا على السواء يسمونها باسمها: الأوائل يسمونها حروب الفرنجة، والآخرون يسمونها المآثر والأعمال التي تمت فيما وراء البحار، أو التي تمت في الشرق، أو أعمال الفرنجة، الحركة الصهيونية بدورها لم تسم نفسها الحركة اليهودية، وسمت نفسها الحركة الصهيونية، ولو أن العنصرية اليهودية المتزمتة تلفها بكلمات التوراة وإسرائيل والناموس والشمعدان السداسي العتيق.
صحيح أن الحرب الصليبية معقدة الدوافع، كالحركة الصهيونية سواء بسواء ولو جمعت مختلف دوافعها بعضها إلى بعض لوجدت أن العامل الديني قد يأتي بين العوامل الأولى لا سيما في فترة الإعداد وأيام الحملات الأولية، وقد يعصف بالنفوس تارة بعد أخرى، لكن العوامل الدنيوية كانت هي التي تعصف بهذه النفوس نفسها في حالات أخرى، والخليط الصليبي، كالخليط الصهيوني، متباين الطبقات والمشارب، فيه المغامرون والحجاج واللصوص والتجار والنبلاء والمحاربون وشذاذ الآفاق والرهبان والهاربون من العدالة والباحثون عن الثروة وفي كل واحد من هؤلاء جانب ديني قد يلتهب في بعض الظروف، لكن من الذي يكبح الجوانب الأخرى المادية اللاأخلاقية أو الوحشية في ظروف أخرى؟.. وهكذا كانت إيديولوجية الصليبيات الدينية غطاء مناسباً، وإن يكن أحياناً غير مخالف لأطماع النبلاء في الأرض، والرهبان الكاثوليك في الانتشار والسيطرة على كنيسة المشرق، والتجار بالربح والامتيازات، والفلاحين العاديين بالخلاص من الديون ومن المجاعات ومن الظلم الإقطاعي والفوز في النهاية بالسماء! أليس هذا هو الوضع الصهيوني نفسه؟
د- الصليبيات بدأت حجاً إلى القبر المقدس تحول إلى حج مسلح، ولقد استغلت الحج، وشجعته الأساطيل البحرية الإيطالية النامية على مياه البحر المتوسط (من جنوية وبيزية والبندقية وكاتلان)، تذهب ملئى بالحجاج وتعود من الشرق ملئى ببضائع الشرق من فلفل وبخور وأفاوية ونسيج وزجاج .. صارت سيدة البحر العربي بعد أن انهزمت القوى العربية الإسلامية في الأندلس، وتضاءلت أساطيلها، أو انقطعت أحياناً ما بين شمالي إفريقيا والمرافئ الإسبانية، وخرجت فرخشنيط وجبل القلال في جنوب فرنسا وجزر الباليار من السيطرة الإسلامية، فأين إذن الحج المقدس؟ وأين القبر المقدس نفسه، حين طرحت هذه الأساطيل نفسها بالصليبيات وبغزو الصليبين إلى القسطنطينية مرة وإلى مصر مرتين وإلى تونس أيضاً، فهل كانوا يحسبون أن القبر المقدس انتقل هناك؟ وفي الحركة الصهيونية، ألم يكن الحج والحج المسلح إلى حائط المبكى وبقايا الهيكل هما بدء الطريق إلى وعد بلفور ثم إلى أحداث 1948؟ ألم تكن العملية الاقتصادية الاجتماعية من تجارة وحلول للمشاكل العمالية والأطماع المادية وراء الهجرة الصهيونية ووراء أخذها الأرض واحتلالها النقب وتوسعها في المصانع والزراعات بعد أن تخاذلت القوى العربية سنة 1948 وما بعدها؟ أم أنهم يبحثون عن الهيكل في تونس أو عنتيبي أو حول المفاعل الذري ببغداد؟
هـ ضمن هذا الإطار الديني نفسه: يسمي الصليبيون أنفسهم في النصوص بفرسان المسيح “والشعب المقدس” و”شعب الرب” أليس يسمى الصهيونيون أنفسهم بشعب الله المختار، مقابل الغوييم الهائم الذين هم كل البشر الآخرين؟ وإذا قال البابا أوربان الثاني، وهو يعلن الصليبيات: حرروا هذه الأرض من الجنس الشرير .. فهذه الأرض التي يقول الكتاب المقدس إنها تفيض باللبن والعسل قد منحها الرب ملكاً للمؤمنين، أفلا يقول الصهيونيون بدورهم إنها ملكهم وعدهم الله بها من الفرات إلى النيل؟
و- وضمن الإطار الديني أيضاً، ألم تحاول البابوية، وهي الكاثوليكية الغربية، إبراز نفسها حامية لمسيحي الشرق المضطهدين؟ فماذا يقول اليهود الإشكنازيم (الغربيون) الواردين من روسيا ووسط أوروبا وألمانيا وفرنسا؟ أليسوا يجعلون أنفسهم حماة لليهود السفار أديم، يهود الشرق؟
ز- الطابع الديني استطاع أن يكون واضحاً في الأيام الأولى للصليبيات، لأنه كان الدافع المعلن، ولقد استطاع أن يغطي إلى فترة ما حقيقتها الاقتصادية- الاجتماعية، اختفى التجار وراء سواد المحاربين، وتوارى الإقطاعي بجشعه وراء الرهبان ورجال الكنيسة، لكن الأطماع في الأرض والقلاع والمدن والامتيازات التجارية كانت واضحة مسيطرة، وفيما نهب الجناح العسكري من نبلاء وفرسان: الأرض عماد الثروة والسلطة في المجتمع الإقطاعي الغربي، تقاسم التجار الغربيون الأسواق والامتيازات والأحياء والفنادق في المدن وحين دارت العجلة بالأحداث والناس، تكشف التناقض العجيب، وتجلى الإفلاس الإيديولوجي في الحملات التالية، وبلغ الذروة في الحملة الرابعة التي توجهت إلى القسطنطينية المسيحية تفتحها، ظهر أن البابوية والتجار الإيطاليين وإقطاعي أوروبا يستخدمون الدين سلاحاً سياسياً عسكرياً ضد المسلمين وضد بعضهم بعضا على السواء، ولو كان هذا “البعض” من أخلص المدافعين عن الكاثوليكية.
ج- إن كل الغطاء الديني للصليبيات يطير إذا استعرضنا الصليبيات الرسمية الثمانين فوجدنا أن ثلاثاً منها فقط توجهت إلى القدس، في حين توجهت الخمس الأخرى إلى أهداف أخرى فالثانية إلى دمشق، والرابعة إلى القسطنطينية، والخامسة والسابعة إلى مصر، والثامنة إلى تونس، لعلها كانت تفتش عن آثار المسيح هناك، وأما حملات القدس فقد احتلتها الحملة الأولى فقط وفشلت الثالثة في الوصول إليها، ووصلتها الحملة السادسة سلماً ومجاناً في حين كان البابا يستنزل على هذه الحملة اللعنات من الرب، ويرمي صاحبها بالحرمان.
ونعود إلى الصهيونية المعاصرة لنرى الصورة نفسها، وإن تكن متطورة على مقياس القرن العشرين: افتراس للأرض لا ينتهي، محاولات لربط العلائق التجارية بكل الموانئ، استخدام للإيديولوجية الدينية في التوسع العسكري، وإفلاس إيديولوجي يتجلى في حروب 1956و 1967و 1973، ويبلغ الإفلاس أوجه حين تكشف إسرائيل عن دورها الحقيقي في تونس، وفوق المفاعل الذري بالعراق، وفي حروبها في المنطقة، فإذا هي أجير أمريكي صغير، مجرد حاملة طائرات أمريكية تحمل قوى مرتزقة تموّن بالمعونات، وعملها الأساسي استنزاف قوى المنطقة ومراقبة الاتحاد السوفيتي.
هل انتهت المقارنة الدينية؟ لم تنته بعد، فثمة أيضاً الحديث عن الإرهابيين المدنيين أيضاً، عن مئير كاهانا وحزبه أغودات إسرائيل، وهن الحاخام شلوموغورين، والنائبة عئولة كوهين، وأركان مجلس الحاخامين، وأعضاء غوش أمونيم، وحركة هاتحيا، وغيرهم ممن ينفخون في الرماد التوراتي ويعميهم دخانه ومثاره، إن دور هؤلاء جميعاً هو الحفاظ على الحقد الديني في حالة الغليان ليصب الحساء ساخناً في الصحن الصهيوني- الأمريكي، مقابل هذه المؤسسات كان للصليبين أيضاً مؤسسات دينية- عسكرية مماثلة، وهكذا نقرأ عن الداويّة، وعن الاستبيارية، وهن مؤسسة النيوتون … والمؤسسات الصليبية المشابهة في إسبانيا: فرسان القنطرة، وفرسان قلعة ترافاً، وفرسان القديس يوحنا (سانتياغو) .. والدور هو الدور نفسه: تأييد اعتداءات الدولة على الأرض والناس، ومسحها بالممحاة الدينية، وإيجاد أيد أخرى بجانبها تحول التوراة إلى سيوف أو قنابل، وشيء من عمى غير قليل! ترى هل يتضح، بعد هذا كله، أن السبب الحقيقي وراء الصليبيات أو وراء الصهيونيات ليس هو الدين ولكن الأطماع الدنيوية للمتاجرين بالدين؟
خامساً: ونعود إلى الصليبيات والصهيونيات لنرى أن المشروعين إنما قاما على الدعاية المكثفة وعلى استغلالها الأقصى، ولقد طافت تدعو إلى الصليبيات مجموعات شتى من القسس والرهبان والتجار والمتشردين، كان جيش الدعاة الذي لا ينقطع يطوف أوروبا قرى وجبالاً وعبر الأنهار وفي عتمة الكنائس والغابات ومداخن البيوت، منهم بطرس الراهب وسان برنارد وجوسياس (رئيس أساقفة صور) وهرقل (بطريك بيت المقدس)، بل قام الدعاة من الأطفال، وقامت حملات من الأطفال بعشرات الألوف زحفت تريد تخليص القبر المقدس ببراءتها وحدها ( ولو أنهم انتهوا بمساعي الصليبيين أنفسهم إلى أسواق النخاسة)، كانت الدعوة للصليبيات بضاعة رائجة، أليس هذا ما يفعله الكهنة والربانيون في كل كنيس، وما تقوم به الصحف الصهيونية منذ مائة سنة؟ وكما استغل الصهيونيون جهل العالم بالتاريخ وبالواقع الجغرافي ليحوروهما كما شاؤوا، ليلغوا آلاف السنين العربية من التاريخ في فلسطين، وليلغوا وجود الشعب الفلسطيني من الجغرافيا، وليجعلوا من البلد الصحراء فارغة، كذلك استغلت الدعاية الصليبية سدوف الجهل الأسود في تلك العصور، فجندت في ما سموه، بجهل الخيال المنتصر، كل القوى في اتجاهين:
1) اتجاه يضع كل تراث الجهل والخرافة لدى الناس في خدمة الإيديولوجية المعلنة من الأساطير في السحر القديم، وجيوش الأشباح والموتى، والشياطين الشريرة والأشجار صانعة المعجزات، وقصص النجوم التي تتساقط من السماء، والشهب الملتهبة، ومعجزات الأطفال الذين يولدون بأطراف مضاعفة، والرعاة الذين يرون مدناً متألفة في السماء، والقسس الذين يشهدون سيفاً ضخماً تحمله الريح في الأفلاك، أو معركة بين فارسين يضرب أحدهما الآخر بصليب يرديه، وقصص النار والحساب والفردوس المقبل ونعيم الخلاص والغفران، بل وقصص الغنائم المنتظرة في الشرق الأسطوري، كل ذلك لإثارة حماسة الناس في الغرب حتى الحد الأقصى.
2) اتجاه يوجه هذه الدعاية كلها ضد عدو “شيطاني” الملامح: فالرسول الأعظم في منظورهم “ساحر هدم الكنيسة في إفريقيا والشرق بالسحر والخديعة” وجعلوا من المسلمين وثنين وعباداً لمجموعة من الآلهة والأصنام، ومحمد هو الصنم الرئيسي، وهو كبير آلهة الشرقيين “السراسنة” تمثاله المصنوع من المواد النفيسة بالأحجام الهائلة منصوب في أصبهان أو مكة، يرافقه 700 من مريديه! غربيو القرون الوسطى صدقوا هذا كله، وصدقوا معه ما يترشح لهم عن المسلمين من أنشودة رولاند وأغاني الـ Gueste وروايات الحجاج الذين كانوا يعودون بالمبالغات والغرائب لإضفاء الأهمية على مغامراتهم ولإثارة الدهشة والإعجاب.
وقد ثبت أن أصحاب الإيديولوجية الصليبية استخدموا في الاتجاهين الكذب وتزوير الوثائق والمبالغات إضافة إلى قصص الأحلام المقدسة والرؤى العجائبية، وكان لهم من سذاجة الناس وجهلهم ما يطمئنهم إلى النتائج.
أليس هذا يا ترى ما فعلته الصهيونية في الاتجاهين: فمن جهة استغلت كل موروث الغربيين من الحقد على اليهود في صيغة “اللاسامية” لتضخيم الشعور بالاضطهاد لدى اليهود، ولدفعهم إلى التكتل حولها والهجرة إليها، فما زالت إلى اليوم تحاكم النازيين القدامى، وتتهم غيرهم، وتتقاضى من ألمانيا ثمن الجثث المحروقة في أوشويتز، وترفع العصا في وجه كل داعية إلى التعقل في الغرب باسم اللاسامية، وهكذا ضخمت الأساطير وصاغت الروايات وصنعت الأفلام وكتبت واستكتبت كل الأقلام المكنة وكررت مسكنة اليهود وعذاباتهم كل يوم في كل إذاعة مسموعة أو مرئية، إنهم المضطهدون الوحيدون في العالم، هكذا قال زارادشت!!
ومن الجهة الأخرى فمادام الناس يجهلون كل شيء عن فلسطين وتاريخها وناسها فلماذا لا تصوغ دعايتها في كل ذلك على ما تشتهي؟ سكانها العرب: تجاهلتهم أولاً بالإلغاء الكامل، ثم لحقتهم بالتهم حين ظهروا على سطح الأحداث فهم في أدبها “برابرة” أنذال، مخادعون، وأخيراً “إرهابيون” وعلى العالم كله أن لاحقهم بالرصاص والإبادة، ألم تستخدم الكذب الدائم والمبالغات والتشويه وتزوير الوثائق؟
أي فرق في النتيجة بين ذلك التضليل الفروسي وبين التضليل الصهيوني الأمريكي عن “قادة الإرهاب ومصاصي الدماء والقتلة العرب الفاسدين المفسدين في الأرض”. الذين لا يهمهم في الحياة إلا القمار والقتل وجسد امرأة؟ أي فرق بين المهووس الصليبي القديم الذي جاء من أقصى الأرض يحارب “الشيطان” المسلم وبين مئير كاهانا الذي يقول:”كيف نضع أيدينا بأيدي الأبالسة؟”
أو أي فرق بين صورة “المسلم الوحش” في عيني الصليبي وصورة العربي التي ينشرها الصهيوني في العالم عن العرب:”صورة النخلة والجمل في صحراء ينبع فيها بئر النفط وأسنان العربي المكشر فوقها؟”.
سادساً: وتدفق الصليبيون على الشرق سنة 490هـ وما بعدها (1096م وما بعدها) وحين احتلوا القدس سنة 492هـ/ 1099م ذهب الصريخ إلى خليفة بغداد: يهز منبر المسجد الجامع ويكسره، ولكن يشكو هجوم “الروم” البيزنطيين! كانوا يجهلون أن العدو هم الفرنجة، مضت سنوات قبل أن يتبينوا أنهم فرنجة وليسوا من الروم الذين اعتادت دول الإسلام سماع قعقعة السيوف معهم على الحدود كراً وفراً أربعمائة سنة، ودون طائل، لا أكثر من غزوات تنسحب بعد حين، أبداً ما انتهت يوماً إلى الاحتلال النهائي ولو هددت به.
الشاعر أبو المظفر الأبيوردي، على طريقة الشعراء الذين تنفجر قوافيهم اليوم في الفراغ، صاح في قصيدة طويلة:
وشر سلاح المرء دمع يفيضه
وكيف تنام العين ملء جفونها
وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم
تسومهم “الروم” الهوان وأنتم
وتلك حروب من يغب عن غمارها
إذا الحرب شبت نارها بالصوارم
على هفوات أيقظت كل نائم
ظهور المذاكى أو بطون القشاعم
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم
ليسلم يقرع بعدها سن نادم!
وغابت القصيدة والعشرات من أمثالها في المستنقع الكبير.
كانت قوى المنطقة تجهل من هو العدو الذي تحارب صحيح أن القدس السلجوقية بعيدة المرمى ولكن السيف الصليبي كان ثقيلاً جداً وقاطعاً جداً، ولم يعرفه المحاربون في المشرق من قبل وحين تبينوا الواقع كان الفرنجة قد استقروا.
أليس هذا هو جو المستنقع الأخرس الذي تعيشه القضية الفلسطينية اليوم، جو البكائيات دون دموع، والصياح في غرف كتيمة من البلور، في حين يقوم في القدس عجل ذهبي له خوار يأكل عيون الأطفال حتى في بيروت! ألسنا نقول تلك القصيدة الأولى اليوم ألف مرة وبألف لحن؟
على الجانب الفرنجي كان الأمر بالعكس، اعتبر الكثيرون في الغرب نصر الفرنجة نصراً للكتاب المقدس ونبوءاته، تماماً كما يعتبر ذلك الصهيونيون، وتشجع الكثيرون على أن يسلكوا سبيل الشرق حجاجاً، محاربين، تجاراً، باحثين عن الثروة، فهم على كل شراع، كلهم كان يعتبر الاحتلال الفرنجي نهائياً، والتوسع فيه أمراً مقضياً، الجيل الثاني من الصليبيين الذي نشأ في البلاد أخذ يكتب ما كتبه المؤرخ اللاتيني فولشير أوف شارتر:”فيم يتعجب المرء من أن الله يظهر المعجزات في السموات في حين أنه أتى بمعجزة على الأرض نفسها بتحويله الغربيين إلى شرقيين .. ومن كان من روما أمس فرنجياً من قبل قد أصبح جليلياً ومن أهل فلسطين أو من صور، نسينا أوطاننا الأصلية، وأولئك الذين كانوا من قبل أجانب قد أصبحوا أهالي البلد، ومن كانوا فقراء أصبحوا يمتلكون هنا ما لا يحصى، فلم يرجع المرء إلى الغرب بعد أن وجد الشرق صالحاً إلى هذا الحد؟ إن الله لا يريد لأولئك الذين حملوا الصليب (ونستطيع أن نضع بدل هذه الكلمة اليهود) أن يقاسوا حتى النهاية .. إن الله يرغب أن يغنينا لأننا من أعز أصفيائه”. أليس هذا هو ما يكتبه اليوم بألف شكل ولسان كتاب الصهيونية؟ ونمضي مع المقارنة قدماً.
سابعاً: يطنب المؤرخون ويعيدون ويبدون في سبب النصر الصليبي الأول الذي بدأ عند إنطاكية سنة 1097م وانتهى باحتلال القدس سنة 1099، ويذكرون أن تمزق القوى في المنطقة هو الذي سمح للفرنجة بالنصر، ما في ذلك أي شك، وحين يكون رضوان صاحب حلب أخا لدقاق صاحب دمشق، ويكون في الوقت نفسه أعدى أعدائه، وحين يتصيد الفاطميون في مصر انشغال دقاق مع الصليبين في الشمال لينقضوا على القدس فيأخذوها، ويكون صاحب إنطاكية قيباً للسلطان علي صاحب حلب، وينفرد أمير شيرز بشيرز، وابن ملاعب بحمص، والقاضي ابن عمار بطرابلس، وبعضهم لبعض عدو، فماذا تنتظرون إلا انهيار الجميع قوى متفرقة أمام الموجة الغازية؟
ومن عجب أن تكون القوى التي تصدت للفرنجة في غزوتهم الأولى سبع قوى، وتكون الدول التي وقفت لموجة الاحتلال الإسرائيلي بدوره سبع دول، ولعلنا نتذكر هنا ذلك السائل الذي سأل: كيف تهزمون وأنتم سبع دول؟ فأجابه المجيب- لأننا سبع دول! على أن المؤرخين ينسون أن يضيفوا أن حائط الدم قام منذ اليوم الأول بين هذه القوى- على تفرقها- وبين الفرنجة، امتد كاللعنة الأبدية من إنطاكية إلى المعرّة، حتى وصل ساحة المسجد الأقصى حيث خاض الصليبيون في آلاف الجثث وسواقي الدماء! وقد ظل هذا الحائط يتكاثف على الدوام ويرعف على الدوام مع المعارك الدائمة، أضحى سوراً خانقاً حول الإمارات الفرنجية، أبداً ما صفا قلب أحد لها ولا نسي الدماء أحد، أليس حائط الدم نفسه يقوم اليوم حول المنطقة المحتلة؟ يحولها إلى “غيتو” كبير رغم الخروق التي فتحتها فيه بعض السياسة الخرقاء! الفيتو الصليبي انهزم في النهاية، أما الفيتو الصهيوني فهل تنجده يا ترى هذه الخروق؟
قوى المنطقة أقامت قاعدة المقاومة الصلبة للفرنجة فيها على النهب والعزل والتطويق، تماماً كما تطوق الكائنات الحية الأجسام الغريبة حتى تنفقئ كالدمامل، صحيح أن التجارات كانت تسير دون عائق، عابرة آمنة، ولكن صحيح أيضاً أن ذلك لم يؤد إلى أي تقارب فكري أو ثقافي أو “تطبيقي” مما يُطبعون من الطرفين، حتى الصهيونيون سجلوا أن الحوار بين الفرنجة وأهل البلاد كان “حوار الطرشان”، والعلاقة الوحيدة كانت علاقة المصلحة المادية المباشرة، ظلت الخلية الفرنجية المتوضعة على الساحل الشامي غريبة، في لسانها، في عقيدتها، في نظام حكمها الإقطاعي، في رجالها ونسائها، بل في عادات الطعام والشراب فيها، ربما كانت سياسة العزل متبادلة من الجانبين، لكن النفي الإسلامي للفرنجة كان هو الأول والأقوى والأصلب، لأنه الأقوى حضارياً والأعمق ألماً، كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ هو ضحكة استهزاء عريضة بكل حياة الفرنجة، تشبه الاحتقار، إلى أن جاء الوقت في حطين وما بعدها فإذا بالمحتلين الفرنجة قشرة تسقط وتزول كأن لم تكن! المحتلون الصهيونيون تنبهوا مبكرين إلى هذه الخطيئة الصليبية المميتة، أما ترون أن كل همهم كان، حتى قبل سنة 1948، أن يصبحوا جزءاً من المنطقة؟ أن ينتصروا على “لاءات” الخرطوم الثلاث، أن يمرروا، التطبيع؟ أن تعترف المنطقة بهم.
ثامناً: واعتمد الفرنجة في توطنهم على المعونات مما وراء البحر: الأسلحة، الرجال، الأموال، الطاقات البشرية كانت دوماً تأتيهم على الأشرعة، حتى الكهنة والنبلاء والتجار المدد البشري لم ينقطع، ومعظمه من الشباب المحاربين، أوروبا الغربية كلها كانت تصب في هذا المشروع ليعود عليها بالخيرات، ولينعم أصحاب النذور والهبات والتطوع بالفردوس الآخر! ريتشارد قلب الأسد بحث عمن يشتري منه لندن لينفق أموالها في الحرب ضد صلاح الدين، الأمراء والملوك كانوا يأتون بثرواتهم وثروات أتباعهم لينفقوا منها على الحرب، ولم تكن موارد أجزاء من الشام أو من مصر تكفي كما هي اليوم، حرب حاسمة أو ناجحة على الأقل ضد الجماعة المحتلة، إلى أن استطاعت إمبراطورية صلاح الدين أن تقيم التوازن في الموارد وبالتالي في القوى بينها وبين الفرنجة، ولم تكن هذه الموارد ضخمة على أي حال، بدليل أنها شحت بعد الفتوحات الأولى، وقصرّت عن إمداده في المراحل اللاحقة، وجفّ الذهب عنده، فلم يعد يضرب الدنانير ولكن الدراهم، وهو ما أبقى الصليبيين في صور ثم في عكا وفي الساحل مائة سنة أخرى.
ألستم ترون أننا، ونحن نتحدث عن الحروب الصليبية، إنما نتحدث أيضاً عن الحروب الصهيونية، وعن مليارات الدولارات التي تصب سنوياً في المشروع الصهيوني؟
ويبقى في هذا المجال أمر أخير لا بد من ذكره، هو التمويل اليهودي للصليبيات، يهود أوروبا ومن باب الربا، ساهموا في تمويل الصليبين، الأمراء والملوك، وبخاصة حين فترت الحماسة الصليبية الأولى، وفرضت ضريبة صلاح الدين في أوروبا لإيجاد الموارد التي شحت، كانوا يلجؤون إلى الاقتراض من المرابين اليهود، وكما غطى أغنياء اليهود في حروب سنة 1948 ثم سنة 1967 ثم 1973 ما تكبدته إسرائيلهم من نفقات، كان المرابون يغطون بعض تكاليف الصليبيات المتأخرة من الثالثة حتى الثامنة .. وحين فشلت الصليبيات الفشل النهائي، انصبت النقمة في أوروبا على اليهود! لا انتقاماً للفشل فقط، ولكن لأكل الديون أيضاً، وانضاف هذا السبب إلى السبب التاريخي القديم الذي يتهم اليهود بصلب المسيح ليشكلا معاً النواة الأولية للعزل اليهودي في أوروبا كلها.
تاسعاً: وقد قام المجتمع الفرنجي الخليط على طول الساحل الشامي، أسقف فرنسي معاصر للصليبيات يقول عن المجتمع الغربي إن “بيت الرب ذو جوانب ثلاثة، فبعض يصلي فيه، وبعض يحارب، وبعض يعمل”. هذا المجتمع الغربي الإقطاعي نفسه هو الذي تشكل في الشام في ثالوث ضلعاه: الذين يحاربون والذين يصلون، وقاعدته الذين يعملون، بل كان المحاربون (النبلاء) والمصلون (الكهنة) جناحين عسكرياً ودينياً لطبقة واحدة تقود المشروع الصليبي.
أليس هذا يا ترى وضع الجماعات الصهيونية المحتلة، جماعة تحارب، وأخرى تهز أجسادها جيئة وذهاباً وراء التوراة، وجماعة ثالثة تعمل في الأرض والمصانع؟ قد يكون الفرق في وجود طبقة رأسمالية إضافية في المجتمع الصهيوني الحديث، ولكن أليست هذه الطبقة امتداداً للطبقة الغربية نفسها والجزء المكمل بها والإفزاز الطبيعي للتطور الغربي الحديث نفسه؟
وكما بقيت في فلسطين تحت الاحتلال قوى عربية واسعة، تتمسك بالأرض والزيتون ومزراب العين، كذلك بقيت تحت الحكم الفرنجي طبقة عربية مسلمة تملأ الريف الفلسطيني يستثمر جهدها الرجل الفرنجي (كما يستثمرها اليوم الرجل الصهيوني) تحت رقابة الفرنجة، ولا تستطيع حتى الهرب من القرى، وكما للعرب اليوم مقاومتهم وتحركاتهم الجماعية والفردية ضد المحتلين، كذلك كانت لأجدادهم الأولين في تلك الأرض مقاومتهم الرافضة، في نابلس والناصرة كانوا يحتالون لها على الحجاج العابرين فيقتلونهم ويقطعون الطرق، ويتركون العمل بحجة الصلاة، فمن أعجزه الأمر هرب مهاجراً، ونواة حي الصالحية في دمشق إحدى نتائج الهجرة من “جماعين” إحدى قرى نابلس أواسط القرن الثاني عشر، في أوج القوة الصليبية.
وإننا لنستطيع أن نرى التشابك الفرنجي الصهيوني على مستوى آخر: فطبقة العاملين، في القطاع، في الأيام الفرنجية كانت تتشكل من المسلمين ومن أفراد الطوائف المسيحية غير الغربية، ومن فقراء الغرب في حين يحتكر النبلاء والكهنة السيف والكتاب المقدس، أليس هذا هو الوضع الصهيوني الذي يعمل فيه، في القطاع، العرب واليهود الشرقيون وفقراء المهاجرين؟ في حين ينعم أمراء الإشكنازيم بالحكم وقيادة الجيوش وتفسير التلمود؟
ونتابع المضي مع المقارنات أيضاً ما أشبه الليلة بالبارحة.
عاشراً: اعتمد الفرنجة السابقون والصهيونيون اللاحقون على السواء أسلوباً واحداً في التشبث بالأرض وفي التوسع عند الإمكان، القلاع التي نثرها الفرنجة على جميع المعابر إلى المنطقة المحتلة قابلها الصهيونيون بقلاع عسكرية من مثلها ترونها في أنواع المستعمرات التي زرعوها على طول الحدود وفي داخل البلاد وكل منها مسلحة كاملة، وكما كان المحاربون القدماء يعيشون على أراضي الزراعة حولهم، يعيش المحتلون الجدد محاربين مزارعين في المستعمرات الجديدة، وكما كانت القلاع الفرنجية في القديم تتوزع بين منظمات الداوية والاسبتارية والملك والإقطاعيين نجد المستعمرات الصهيونية موزعة بين الأحزاب والمنظمات الإرهابية.
حادي عشر: منذ الأيام الأولى للتموضع الصليبي في القدس، لم تكن الموانئ الشامية وحدها هي الهدف، بلى! كانوا يحتلونها واحداً بعد الآخر، الأساطيل التجارية الإيطالية وضعت كل ثقلها لاحتلالها، لكن عينها وعين مملكة القدس الصليبية معها كانتا على مصر وعلى “العقبة” مصبي طرق التجارة العالمية إلى المتوسط، حاولوا احتلال مصر مرات حتى سبقهم إليها نور الدين وصلاح الدين، بنوا قلعتين في الطريق إلى أيلة بشرقي الأردن، بنوا قلعة في جزيرة فرعون بخليج العقبة بالقرب منها، أقاموا إمارة في الكرك تسلمها قبيل حطين فارس من أعتى فرسانهم: أرناط المعروف الذي حاول بمشاريعه البحرية السيطرة على البحر الأحمر حتى عدن، كما حاول الوصول إلى المدينة وكان من الأسباب المباشرة لموقعة حطين، والسبب؟ السبب ليس حب الصحراء ولا الماء، ولكنه الدور الاستراتيجي والتجاري، كانت طرق التجارة العالمية بين الشرق البعيد، طرق الأفاويه والتوابل والبخور والنسج، تمر من هذه المنافذ، وما جاء بهم إلى الشرق الأدنى إلا الطمع بهذه المنافذ وتجاراتها، وحين انقطع الطريق البري بظهور المغول عليه في القرن الثالث عشر، وفقدوا السيطرة على القدس والمناطق في شرقها، وصارت مصر هي الطريق التجاري الأكبر توجهت الحملات إليها، وإلى دمياط الثغر الأول بالذات، الحملتان الخامسة والسابعة توجهتا إليها، وفشلت الحملتان، هل يذكرنا هذا بقتل الكونت برنادوت الوسيط الدولي بأيدي الصهاينة لكي يتوسعوا في النقب، وبإصرار بن غوريون على احتلال أيلة بأسرع وقت سنة 1948، أو بما أعقب ذلك من أحداث حول خليج العقبة البحر الأحمر حتى مشكلة طابا اليوم والجزر في مدخل خليج العقبة؟ وهل يكشف هذا نفسه لأعيننا عن معنى محاولات إسرائيل النفوذ من البحر الأحمر إلى ما وراءه لتكون مثلها مثل مصر المطلة على البحرين الأبيض والأحمر؟ وله يكشف ذلك دورها التجاري والاستراتيجي؟
ثاني عشر: حرص الفرنجة الصليبيون منذ أيامهم الأولى حتى أيامهم الأخيرة على إبقاء التمزق السياسي قائماً في المنطقة، كان كنزهم الثمين، وحرصوا أكثر من هذا على عقد هدنة مع كل طرف على حدة: مع إمارة دمشق، مع إمارة حلب، مع أمراء الجزيرة، مع مصر التي ظلت تحتفظ بعسقلان في أقصى الجنوب الفلسطيني خمسين سنة تماماً كما احتفظت مصر في العصر الحاضر بقطاع غزة، البند الأساسي في هذه الهدنات: فتح طرق التجارة والسبل الآمنة، هل يذكرنا هذا بشعار “التطبيع” اليوم؟ وبما تحاوله السلطات الصهيونية من العلاقات مع مصر؟ ومع غير مصر؟ الفرنجة في القديم كانوا كذلك يفعلون، ينفردون بالإمارات في المنطقة، يضربونها الواحدة بعد الأخرى ضربات خاطفة صاعقة، أو يهادنونها واحدة واحدة! كانوا يعرفون أن في لقائها بعضها مع بعض نهاية المشروع المهووس، يخشون هذا اللقاء خشيتهم للموت لأنه الموت! ألم يكن ذلك في حطين؟ ألسنا نرى استماتة إسرائيل منذ بن غوريون وشاريت إلى بيريز وشامير في المطالبة بالمفاوضات الفردية والمباشرة؟ ورعبها من أي لقاء بين دولتين، لقد جرت بعض هذه اللقاءات في القديم، أمير الموصل مودود اتفق مع أمير دمشق طفتكين وواقعا الفرنجة، فكانت لحظة من أخطر لحظات المملكة الصليبية، وأمير دمشق اتفق مع أمير حلب، على بينهما من تباين، فتمكنت الإمارتان من الوقوف يومذاك، وحارب معها أمام غزة، كما دافع عن ثغرها (صور) بجنده وماله، لكنها كانت اتفاقات عابرة غير واعية، ألا تذكرنا هذه المحاولات بمحاولات الوحدة بين سورية ومصر، أو بين سورية والدول العربية الأخرى؟
وكان أقصى ما تتمناه مملكة القدس أن تعقد الصلة مع إمارات الشام ودمشق بالذات، لقد أفشلت الحملة الصليبية الثانية كلها لتبقى لها دمشق التي كانت تهادنها، وعقدت معها حلفاً منفرداً استمر قرابة اثنتي عشر سنة هو “كامب ديفيد” الزمن القديم الذي أنهاه نور الدين محمود بتحرير دمشق من الأمير المتحالف، لقد ظلت مملكة القدس تلعب على حبال التفرقة، حتى سقطت بين الحبال!
ثالث عشر: أضاع العرب المسلمون، أيام الفرنجة، فرصاً ذهبية لإنهاء الوجود الاحتلالي الفرنجي، ارتسمت حطين عشرات المرات في الأفق قبل حطين بزمن طويل، قصر النظر السياسي وحده هو المسؤول عن عدم اغتنامها، السنوات التسعون التي انقضت بين سنتي 492هـ (سنة الاحتلال) وسنة 583هـ (سنة التحرير) شهدت مئات المعارك كما شهدتها مثلها مائة سنة أخرى من بعد، وبعضها في عنف حطين ونصرها الحاسم، أولى هذه الفرص كانت أمام انطاكية عشية وصول الفرنجة إلى الشام، دخلوا أنطاكية الفارغة من المؤن وهم حوالي مائة ألف، وبعد ثلاثة أيام فاجأهم الحصار الإسلامي بستة جيوش فدب فيهم الجوع حتى أكلوا النعال والجلود وعشب الأرض، وبادر الكثير منهم بالهرب، حتى الداعية بطرس الراهب! ثم خرجوا بهجمة واحدة يائسة، فلم يحاربهم أحد من الجيوش المتربصة حولهم واكتفوا بالفرار، كانت هذه المعركة هي التي أدت إلى التوطد الصليبي وإلى احتلال القدس! هل يذكركم هذا بحرب سنة 1948؟
وبعد أشهر من الاحتلال والمذابح، تحمل الفرنجة عائدين إلى بلادهم، لقد أدوا مهمتهم، لم يبق في فلسطين كلها سوى ثلاثمائة فارس وألفي محارب، ولم تستفد من هذه الفرصة مصر، وكانت تستطيع أن تسوق فيما يذكرون ثلاثين أو خمسين ألف فارس، ولم تستعملها دمشق وكان لديها عشرة آلاف فارس، كل ما صنعه طفتكين أتابك دمشق أنه ذهب في كواكب من فرسانه إلى طبرية فأخذ منها مصحف عثمان فدخل به دمشق في موكب حافل وأغلق الأبواب!
ومرت فرص بعد فرص من هذه اللحظات الحرجة أضاعها المصريون، كان أخطرها حلمة مايو/أيار سنة 1102م التي سحق فيها الفرنجة عند الرملة فاختفى ملك الفرنجة الهارب في أجمة قصب أحرقها المسلمون فلحقته النيران، والقدس فارغة دون حامية، ولكن النجدات الغربية التي وصلت على المراكب قلبت الميزان، هل تذكرون قصة حرب 1973 والجسر الجوي الأمريكي وثغرة الدفرسوار؟.
أخطر تلك الفرص كانت معركة الأقحوانة عند طبرية سنة 507هـ/1113م، أربع عشرة سنة بعد الاحتلال، التقى جيشا دمشق والموصل مع الجيوش الفرنجية قرب حطين، وتراءت حطين نفسها في المعركة، بحيرة طبرية اختلط فيها الماء بالدم حتى امتنع الشرب منها أياماً، وحشر الجيش الفرنجي محاصراً مهزوماً في الجبال شهرين بجرحاه وأثقاله لا يجرؤ على الحركة، لم يكن في كل مملكة فلسطين من حامية، ووصلت طلائع الجيش الإسلامي حتى مشارف القدس، ودانت لهم البلاد بالطاعة، ثم خشي أمير دمشق أن يختطف منه أمير الموصل إمارة دمشق فأقنعه بالعودة واستئناف القتال في الربيع القادم، ولم يأت هذا الربيع أبداً لأن الأمير الموصلي قتل.
أخطرها في هذه الفرص القديمة الضائعة أن الثمن الذي كان سيدفع فيما بعد كان دوماً أغلى فأغلى، أليس هذا هو قدرنا اليوم مع الاحتلال الصهيوني: الفرص دوماً تضيع والثمن دوماً يرتفع؟
رابع عشر: المقاومة الإسلامية للفرنجة لم تتبلور التبلور السريع لأسباب عديدة، كانت تتصاعد حالاً على حال مع ازدياد اندماج المنطقة ووعيها للكارثة، المعارك التي استمرت تسعين سنة أفرزت الكثير من البطولات كما سفحت على التراب الكثير من الشرايين، في حين كان الحزن يعشش أكثر فأكثر في الصخور والعيون، من هذا الصمود صاغت المنطقة عشرات الرجال، وكان لكل منهم “حطينه” على مقداره، كل منهم ضرب سيفاً في حطين المقبلة ولو لم يحضرها: كربوغاً، جكرمش، جاولي، مردود، أقسنقر البرسقي من الموصل، سقمان بن أرتق، إيلغازي أخوه، برسق، نجم الدين ألبي من الجزيرة، طفتكين، إسماعيل بن بوري، أتر من دمشق، علي كوجك، مظفر الدين كوكبوري من إربل، الأفضل الجمالي، إبنه شرف المعالي، الوزير المأمون، رضوان الولخشي من مصر .. هي أسماء كثيرة لا يذكرها أحد، ولكنهم كانوا الشرط الأساسي لظهور صلاح الدين، لقد كانوا ربيع السيوف الذي برز منه عماد الدين زنكي، ثم نور الدين ثم صلاح الدين، وإذا كان صلاح الدين وحده يخرج من الأسطر ويفرض نفسه على الذاكرة والتاريخ فإنه، بكل تأكيد، لم يخرج وحده من عتمة الإنهزامية والسكون، ما كان ممكناً أن يخرج لو لا “صلاح الدينون” الآخرون الذين سبقوه، كان لا بد أن يوجد السابقون الذين انطفؤوا في مستنقع السلبية والتمزق، ليوجد صلاح الدين من بعدهم محرراً أخيراً، أليس في سجل الصمود اليوم عشرات الأسماء التي تسجل في انتظار حطين المقبلة؟
خامس عشر: كانت عملية تحرير فلسطين من الفرنجة من عمل مصر والشام بالذات، وكان شمال العراق هو العمق الاستراتيجي للعملية، ويبدو أن المنطق الجيو- بوليتكي لا يزال قائماً ولا تزال عملية التحرير من مهمات هذه المنطقة بالذات قبل غيرها، وإن كان منطق العصر لا يكتفي بها ويدخل في التحرير ما لا ينتهي من العناصر الأخرى، على أنك تستطيع أن تفهم لماذا ارتجفت أركان إسرائيل والدول التي تستخدمها للوحدة التي قامت سنة 1958 بين مصر وسورية، لقد رأت فيها- كما ظلت ترى في كل مشروع وحدوي- بداية النهاية، إنها إنما تقوم على تمزق المنطقة وفتاتها، الضباع لا تعيش إلا على الجيف، وهي تفهم هذا الدرس جيداً، بقي أن نعي نحن بدورنا هذا الدرس.
سادس عشر: وأخيراً كانت حطين، لكنها لم تكن إلا بعد أن وجدت عاصمة ومركزاً ديناميكياً لها في دمشق، وقيادة واعية ملهمة، وقوة موحدة ساحقة، وعمقاً استراتيجياً وراءها، وموارد تدفع ثمن الدماء وإعداد سياسياً طويلاً مضنيا، ولن تكون حطين الأخرى إلا إن وجدت مثيل كل ذلك وعلى مقياس العصر هو العنصر الحاسم.
ونصل بعد إلى المحاور الأساسية وإلى تطبيقاتها في سياسة الصليبيين في المنطقة وفي سياسة الصهيونيين، كان الصليبيون يدركون، وهم يتجهون إلى الشرق أمرين أساسيين:
1) يدركون وحدة العدو العربي المسلم ما بين الأندلس إلى المشرق الكثيرون ممن شاركوا في الحملة الأولى كانوا من قبل يقاتلون في جبهة إسبانيا ضد المسلمين، واستمر الأمر على ذلك من بعد.
2) ويدركون أن موانئ الشرق الغنية هي مصب التجارات القادمة من المحيط الهندي وما وراءه، الأساطيل الإيطالية كانت قبل ذلك بكثير تقوم على هذه التجارات في البحر المتوسط واستمرت هذه الأساطيل سيدة هذا البحر من بعد.
وهكذا كانت استراتيجية الصليبين تقوم على الأمرين معاً:
1) ضرب العالم العربي الإسلامي في وسطه تماماً بجانب ضربه في الأندلس وشمال إفريقيا وصقلية، لينقطع اتصال الكتلة الغربية الإسلامية بعضها مع بعض.
2) استثمار الموقع الاستراتيجي لفلسطين حتى الحد الأقصى تجارة ودوراً، والتحكم في عقدة الاتصال الأساسية في التجارة الدولية فيها، ولما كانت مصر تشارك فلسطين الموقع الاستراتيجي فقد كان هم الصليبيين موجهاً إلى مصر دوماً لفصلها عما حولها أو أخذها، يوم وصلت الحملة الأولى الرملة سنة 1099 وقبل أن تحتل القدس أخذوا يتشاورون في متابعة المسير إلى مصر! وظلوا بعد ذلك على مهاجمتها دون انقطاع، وحاولوا أخذها أيام نور الدين، وتوجهت إليها الحملتان الخامسة والسابعة بعد ذلك.
هذه الاستراتيجية مرت خلال العهد الصليبي بمرحلتين: في المرحلة الأولى التي امتدت حوالي نصف قرن: كانت المملكة الصليبية والإمارات التابعة لها تعمل لحسابها في عملية استعمارية مبكرة، وكان لها سند قريب قلق في بيزنطة وسند عريض بعيد في دول الغرب، في المرحلة التالية: وبعد أن أدركت الحركة الفرنجية عجزها عن ابتلاع المشرق بكتلتها المحدودة، باعت نفسها لبيزنطة طلباً للمعونة المباشرة أيام نور الدين وأوائل أيام صلاح الدين، وقبل أن تقع حطين كانت قد باعت نفسها لمن يشتري في الغرب، كانوا يفتشون عن ملك، أي ملك، رموا هزيمة حطين على رأس الملك (غي) النبيل الفرنسي الذي اتفق أن قاد الجمع الصليبي ضد صلاح الدين، ثم بعد أن تضاءل المشروع الصليبي إلى مجرد شقة ساحلية بين صور ويافا أخذوا يبحثون له عن منقذ يعينه: فيليب أوغوست أو ريتشارد قلب الأسد، ثم جاءت أيام الحملة الخامسة فتحكم في المشروع ملك هنغاريا أولاً وفشل، ثم قاده الكاردينال بلاجيوس مندوب البابا سنة 1218- 1229م فغرق به في وحول الدلتا وبعد دمياط، ثم تولاه فريدريك الثاني صاحب صقلية فكانت مملكة القدس مجرد ملحق إضافي لمملكة الإمبراطوري، وجاء لويس التاسع بالحملة السابعة وقاد المشروع مرة أخرى إلى دمياط، وأغرقه مرة أخرى في مياه النيل عند المنصورة.
لو أغمضنا الأعين لحظات، نتأمل في كل هذا الذي مضى من تاريخ الصليبيات، استراتيجية ومراحل، واستبدلنا بكلمة الفرنجة كلمة الصهيونية فهل يختلف الأمر؟ تجاوزوا القرون الثمانية التي مرت، وضعوا مكان بيزنطة والغرب في المرحلة الأولى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول الأخرى حتى حرب 1967، وضعوا اسم الولايات المتحدة في المرحلة الثانية بعد تلك الحرب، وراقبوا الذيلية الصهيونية للاستراتيجية الأمريكية منذ ذلك الوقت إلى اليوم، أليس تنبئ مطالع الخط بنهاية المصير؟
لقد كانت إسرائيل في الجيو- استراتيجية البريطانية إسفين التحطيم للكتلة العربية، وعقدة الطريق إلى الهند، ولهذا خلقت في مكانها، فلما ثبت التمزيق للبلاد العربية، وأقيمت الحدود والدول المنعزلة، واستقلت الهند، انتقلت إلى الجيو استراتيجية الأمريكية لتصبح جزءاً من الحزام الأمني الاستراتيجي ضد الاتحاد السوفيتي، ووسيلة للإبقاء على التخلف العربي، وضاعت فلسطين بين أرجل الاستراتيجيتين، كما ضاعت من قبل أيام الصليبيات، وإلا فاسألوا إذن أنفسكم عن إسرائيل، هذا الحائط اللاهوتي الذي انتصب على العدوة- المفصل لتمارس الأمة العربية الموت على طرفيه، وليعزل مصر عن الوطن العربي بين اللاهوت اليهودي من جهة وبين بحار الماء والصحراء من جهة أخرى، ترى ما دوره في استراتيجيات الدول الكبرى؟ ولماذا تحقنه أمريكا كل سنة بنصف مساعداتها للعالم وهو في شبرين من الأرض وفي ملايين قليلة معدودة من البشر؟ إن الولايات المتحدة تحاول أن تجعل الجغرافيا الصغيرة تقوم بدور الدول الكبرى وتحقنها بالسلاح والمال حقناً في حين تعكف الجماعة المحتلة على اختراع التاريخ واللاهوت والمرتزقة.
وأخيراً هل يعني هذا الذي سلف كله أن لا جديد تحت الشمس؟ وأن التاريخ يعيد نفسه بنفسه؟ وأن حطين ذاتها قادمة في حطين أخرى مماثلة؟ لست أعني هذا أبداً ولا أعتقده، ثم كل يوم جديد تحت الشمس، وحذار أن ننظر إلى حطين من خلال الماضي، إنها لن تكون إلا من خلال المستقبل وأهوال المستقبل، حذار أن نطلب منها أكثر من أن تكون ملهمة بدروسها والمعاني لأنها لن تتكرر إلا بهذه الدروس والمعاني، إن التاريخ أعجز وأعظم من أن يعيد نفسه، وأنا أعرف أن الدنيا الدولية كبرت جداً وتعقدت مصالحها المشتبكة، وأن الأسلحة اختلفت حتى جهنم الذرة وعدميات الفضاء، وأن الأفكار والإيديولوجيات تطورت فما تلمها الخطوط والرؤوس، وأن حطين المقبلة سوف تكبر بهذا المقدار نفسه لتكون نصراً! لقد تكون قطعة من جهنم أو أشد عذاباً، ولقد لا تكون حطين واحدة حاسمة، ولكن سلسلة حطينات، ولقد تدخل تيه التعقيد الدولي فلا تكون بيننا وبين الصهيونية فحسب ولكن مع القوى التي توظفها أيضاً، ولقد لا تكون في ذلك المثلث المقدس من تراب اليرموك- حطين- عين جالوت، ولقد تلعب بها التكنولوجيا الحديثة لعباً ما عرفه العالم قط من قبل، ولقد تختلط فيها الرؤى فما “يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر”.
وإذا احتاجت حطين الأولى إلى صلاح الدين وصحبه، يعدون لها ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل، ومن الإعداد الدولي، والدبلوماسي، ومن الموارد الاقتصادية ومن الخطط التكتيكية، ويخوضون المعركة سنابك تقدح الشرور، وأشلاء ممزقة على الوديان، ونيراناً تحصد الوجوه، وسيوفاً تبصق الدماء، إلا أن كل ذلك ليس أكثر من لعبة أطفال أمام ما يجب لحطين المقبلة التي لا بد فيها من حرّاقة هرقل الأسطورية وهو يحارب الهيدار الأفعوان ذا الرؤوس السبعة الذي كلما قطع له رأس نبتت منه سبعة رؤوس فلا بد من حريق كل رأس حتى الجذور.
أعرف كل هذا الرعب المنتظر، وأعرف أبعاده المأساوية، ولكني إنما أفسر اهتمام الصهيونية بالصليبيات ودوافع هذا الاهتمام خارج إطار العلم والعلماء لأصل إلى معرفة السر وراء احتفال إسرائيل أيضاً بحطين.
إن حطين كانت معركة النهاية كما كانت معركة البداية، ومن خلال حطين تريد إسرائيل أن تفتح لنفسها ثقباً من ثقوب الشرعية، إنها تموت رعباً من التاريخ الذي ينذرها، ولو أنها تبني كيانها كله عليه، تخشى أي مناقضة تاريخية لئلا ينهار البناء كله، وهي تعرف أن الناس يلتهمون الطعم إن كان تاريخياً كما يلتهمون الفاكهة النادرة، مساحات الغبار التي تفصل بينهم وبين التاريخ تدفعهم إلى تصديق كل أسطورة، وإسرائيل تريد أن تخرق جدار العهد الإسلامي في فلسطين في أروع لحظاته بأسطورة تاريخية جديدة تصادر على المطلوب، وإذا كان العالم كله يرى في فلسطين نصراً لصلاح الدين فإن إسرائيل تريد أن تجير هذا النصر لليهود، تريد أن تطبع قبلة يهودية على جبين صلاح الدين، قد يكون من المضحك حتى القرف أن تسوق إسرائيل أسطورة تقول إن صلاح الدين كان عميلاً يهودياً، وما صنع حطين وفتح فلسطين إلا ليقدم القدس على طبق من فضة لليهود، مع ذلك سوف تسمعون هذا، وسوف يطلبون له بوسائل الإعلام معتمدين على تزييف بن غوريون.
بلى! يهودا الحريزي الشاعر الأديب اليهودي الذي زار القدس حوالي سنة 1216م، أي بعد ثلاثين سنة تقريباً من حطين كتب في مذكراته التي نقل عنها المؤلف اليهودي مان “لو تساءلنا عن السبب في منع الصليبيين المسيحيين لليهود من البقاء في فلسطين لسمعناهم يقولون بأننا المتسببون في قتل إلههم ولذلك أنذرونا بأنهم سيأكلوننا أحياء .. لكن الله أرسل الملك العادل صلاح الدين وزوده بالحكمة والشجاعة وحاصر القدس: فأسقط الله بعونه المدينة في يده، وعندما أرسل السلطان منادياً ينادي في أرجاء البلاد بأن يعود كل أبناء إبراهيم إلى القدس من العراق ومصر ومن كل البلاد التي لجأوا إليها، ذكر خبر آخر، يهودي بدوره: أن ثلاثمائة من يهود الغرب وصلوا سنة 1211م إلى فلسطين ومعهم الربانيون بن شمشون والإشكنازي واللونلي، فلم يجدوا سوى عشرة من اليهود معهم يصلون على جبل الزيتون، والتقط هذه الجمل عدد من كتاب اليهود وتبعهم بعض العرب ليعتبروا ذلك من بعض التاريخ، غير أن أكثر الجميع كذباً كان بن غوريون، لقد حور هذه الكلمات فكتب:”أصدر صلاح الدين نداء غداة فتحه القدس يحث في اليهود الفارين من حكم الصليبيين صغاراً وكباراً على أن يعودوا إلى القدس، وفي خلال سنوات قليلة من حكم هذا السلطان العادل أعيد تجمع اليهود في القدس، ووفد اليهود عليها من كل صوب، ولقد عاد مع هؤلاء العائدين عدد من كبار علماء اليهود ورابانييهم، منهم ثلاثمائة من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وسكنوا المدينة.
ولقد ذكر مؤرخ يهودي أن الملك العادل أخا صلاح الدين استقبل سنة 1211 هؤلاء العلماء الثلاثمائة استقبالاً طيباً، وسمح لهم ببناء مدارس ودور عبادة يهودية، وكان على رأسهم الرابي شمشون بن إبراهيم الشنازي والرابي يوناتان الونلي، ولقد استمرت هجرة العلماء اليهود الغربيين إلى القدس وفلسطين طول عهد صلاح الدين وعهد أسرته من بعده (بن غوريون، اليهود في أرضهم، ص 217- 218).
الهوس البن غوريوني زيّف النص ونفخ فيه حتى صار بالوناً ضخماً، إن معلمه غوبلز هو الذي قال: أكذب أكذب دائماً فلا بد أن يبقى من كذبك في النهاية شيء، وهكذا زيّف بن غوريون النص والتاريخ في عدد من النقاط ومد لسانه للجميع: زيفه في قوله:”يحث اليهود صغاراً وكباراًَ على أن يعودوا إلى القدس وفي سنوات قليلة أعيد تجمع اليهود في تجمع اليهود في القدس ووفدوا عليها من كل صوب، ولم يكن شيء من ذلك، ولا كان لليهود تجمع في القدس ليعودوا، ولم يذكر أحد من المؤرخين أن صلاح الدين بعث المنادين، إضافة إلى أن “أبناء إبراهيم” إنما يستعملها اليهود للدلالة على جميع أبنائه من سارة وهاجر، من عرب ويهود، وأضاف بن غوريون زيفاَ آخر في قوله: إن 300 من علماء اليهود بدلاً من 300 من اليهود وإنهم من فرنسا وإنكلترا وإسبانيا، وهم من إسبانيا فقط ممن طردهم الإسبان عند نشأة محاكم التفتيش كما طردوا غيرهم، فاسما الربانيين اللذين كانا بينهم هما شمشون بن إبراهيم الإشكنازي وهو اسم عربي إسباني، ويونان اللونلي من بلده لونة في الأندلس، وكانت البلاد الإسلامية كلها مفتوحة لليهود السفار أديم قبل حطين وبعدها، لا في القدس وحدها، فمنهم آلاف يتوزعون ويتنتقلون في كل من بغداد والبصرة ونيسابور وتبريز والموصل وحلب ودمشق والقاهرة والإسكندرية والقيروان وفاس وقرطبة وغرناطة وطليطلة. ويضحكنا قوله: استمرت هجرة العلماء اليهود طوال عهد صلاح الدين وأسرته إلى القدس بالذات، ولو كان هذا حقاً فلماذا لم يوجد سوى عشرة يهود في القدس بعد حطين بثلاثين سنة يستقبلون وفد اليهود الثلاثمائة.
ولو كان هذا حقاً لما دفن كبير فلاسفتهم ورئيس جالوتهم ابن ميمون في طبرية، ولكن في القدس عند بقايا الهيكل، ولو كان حقاً لذكر ذلك الذاكرون، ومصادر العهدين الأيوبي والمملوكي بما فيها أقوال الرحالة اليهود مجمعة على أنهم لم يجاوزوا في القدس في أحسن أحوالهم بضع عشرات أو بضع مئات حسب العصور والأحوال، وكان وجودهم ينعدم تماماً في القدس في بعض الفترات ويكمل تزييف بن غوريون في قوله: “بناء مدارس ودور عبادة يهودية” وإنما سمح لهم بكنيس فيه مدرسة هو معبد ناحوم، وسمح للمسيحيين- وهم الأعداء يومذاك- بأمثال ذلك.
إن عباقرة الإعلام الصهيوني سوف يحاولون أن يلبسوا صلاح الدين الطاقية اليهودية ويدوروا به على بوابات العالم باعتباره خادماً من خدمهم بدوره، وكما كان بإمكانهم أن يسرقوا مختلف الأساطير من قبل: أسطورة أرضهم من الفرات إلى النيل، وأسطورة أرض الميعاد، أسطورة الديمقراطية الفريدة، وأسطورة الملايين الستة التي أحرقها هتلر، وأسطورة الدولة المسكينة المهددة بالذبح، وأسطورة الإرهاب العربي .. فإنهم يريدون أن يركبوا اكتاف صلاح الدين ليسرقوا باسمه اعترافاً به المنادون: أن القدس لليهود.
ونعود إلى التشابه بين المشروعين الصليبي والصهيوني، التشابه الذي ليس ينقصه إلا كلمة الختام: حطين ولتكن حطين حلماً، إن المشاريع الإنسانية الكبرى إنما بدأت أحلاماً وليكن الطريق إلى حطين مفروشاً بعذاب جهنم، فلا خيار لنا في عدم سلوك الطريق. “كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم”. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين”.
ـــــــــــ
نقلاً عن: مجلة شؤون عربية/ فصلية فكرية – العدد 52 كانون أول/ديسمبر – 1987م/ربيع الثاني 1408هـ – تصدر عن جامعة الدول العربية – رئيس التحرير هيثم الكيلاني
الكاتب الدكتور شاكر مصطفى أستاذ التاريخ بجامعة الكويت