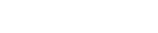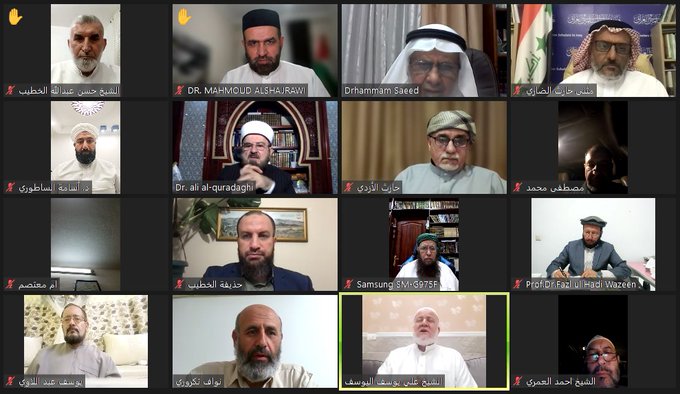إبراهيم الحقيل
أيها المُؤْمِنُون: قراءة الحوادث، والإلمامُ بالتواريخ، والاطِّلاعُ على أحوال الدول، ومصير الأمم؛ يقود إلى الاعتبار والادِّكَار، ويكون سببًا للزُّهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة؛ لأنَّ العبد يرى فيما يقرأ أشخاصًا تملَّكوا ثم مُلكوا، وأممًا عزت ثم ذلت، ودولاً أقبلت ثم أدبرت، ولا يبقى إلا وجهُ ربك ذو الجلال والإكرام: {لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ للهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ} [غافر: 16].
ومما سجله التاريخُ: ما وقع في شهر ربيع[1] من فتح بيت المقدس، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل – عليه الصلاة والسلام – ثُمَّ كان مَسْرَى خاتم النبيين محمدٍ – صلى الله عليه وسلم – إذ جمع له فيه الأنبياءُ كلّهم – عليهم الصلاة والسلام – فأمّهم في محلتهم ودارهم[2].
ان هذا الفتحُ العظيمُ في عهدِ الفاروق عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولكن بشائره كانتْ زمنَ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – قبل أن تدين له العرب، وقبل أن تفتح على يده مكَّة. كانت تلك البِشَارةُ حينما قابل هِرَقلُ الروم أبا سفيانَ، وكفار قريش وسألهم جملة من الأسئلة عن رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – وكانت تلك المقابلةُ بإيلياء؛ أي (بيت الله) الذي هو بيت المقدس.
فما أن انتهى هرقلُ من أسئلته، والمشركون من إجابة تلك الأسئلة، حتى أطلق هرقلُ تلك البشارة التي أَذْهَلَتْ كفار مكة. قالها وهو يتحسَّر على ملكه، ونفسُه يتنازع فيها داعي الإسلام وداعي الملك، وقلبُه يضطرب بين حظّ الدنيا وفوزِ الآخرة؛ لكنه في نهاية المطاف اختار الملك والدنيا؛ فخسر الملك والدنيا والآخرة.
قال هرقلُ لأبي سفيان – رضي الله عنه -: “فإن كان ما تقولُ حقًّا فسيملك موضعَ قدميَّ هاتَيْن، وقد كنتُ أعلمُ أنَّه خارج، لم أكن أظنّ أنه منكم، فلو أعلمُ أني أخلصُ إليه لتجشَّمتُ لقاءه، ولو كنت عنده لغسلتُ عن قدمه”[3].
إنها آيةٌ بينة، وبشارةٌ مُتَقَدِّمَة، بشارةٌ بفتح بيت المقدس، وإزالة عرش الرومان، وكانت تلك البشارةُ قبل أن تُفْتَح مكَّة، فما أعظمها من آية !! وما أطيبها من بشارة!!
ودار التاريخ دورته، وتوفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد أن كمل به الدين، وتَمَّتْ به النِّعْمَة، ثم تَوَلَّى خليفتُه الصديقُ الأول فقضى على الرِّدَّة، وأرسى دعائم المِلَّة، ثم انسابَتْ جُيُوشُه الفاتحة صوبَ الشَّام تحقيقًا للبِشَارة، ومات الصِّدّيقُ – رضي الله عنه – وجيوشُ الإسلام قاب قَوْسَيْن أو أدنى من تحقيق البشارة، وخَلَفه الفاروقُ عُمرُ، وجيوشُ الحق تواصل فتحها؛ حتى بلغت بيت المقدس، فحاصر المُسْلِمُون أهلها، ثم تصالحوا بعد الحصار، وقيل: بعد القتال[4] على أن يقدم الخليفة عمرُ – رضي الله عنه – من المدينة ليباشرَ الصلح بنفسه؛ لما علموا من سيرته وعدله.
فكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بشرطِ أهل إيلياء، فشاور عمرُ أصحابه في الخروج، ثم انشرح صدرُه إلى القدوم على بيت المقدس، واستخلف عليًّا على المدينة[5]، وسار إلى حيثُ مدينة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – وكتب إلى أُمَراء الأجناد أن يستخلفوا على أعمالهم ويوافوه بالجابية، وفي رواية أخرى: أنه وافاهم عند بيت المقدس[6].
فلما بلغ الجابية من أعمال الشام نزل بها، وخطب خطبة بليغة طويلة مشهورة كان منها قوله – رضي الله عنه -: “أيها الناس، أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكمُ تُكْفَوْا أمر دنياكم، واعلموا أنَّ رجلاً ليس بينه وبين آدم أب، ولا بينه وبين الله هوادة، فمن أراد لَحْـبَ وجه الجنة – أي طريقها – فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد…” إلخ خطبته البليغة[7].
وجاءه رجل من يهود دِمَشْق فقال له: “السلام عليك يا فاروق، أنت صاحبُ إيلياء لا والله لا ترجعُ حتى يفتحَ اللهُ إيلياء”[8].
وصالح عمرُ أهل الجابية ثم سار وقادته إلى بيت المقدس، وكان – رضي الله عنه – في غايةِ التواضع والاستكانة والذّلَّة لِله رب العالمين، قال أبو الغادية المزني : “قدم علينا عمرُ الجابية، وهو على جمل أورق، تلوح صلعته للشمس، ليس عليه عمامةٌ ولا قلنسوة، بين عُودَيْن، وطَاؤه فرو كبْش نجدي، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبتُه شملةٌ أو نَمِرةٌ مَحْشوةٌ ليفًا وهي وسادته، عليه قميص قدِ انخرق بعضه، ودَسَم جيبُه”[9].
هكذا نقلوا في وصف مركبه وملبسه، وهيئته وعُدَّتِه، ولو أراد – رضي الله عنه – للبس الحرير، ومشى على الديباج، وركب أصيلات الخيـل. ولو شاء لحمل معه المتاع الكثير، ولأحاطت به المراكب، وحفّت به المواكب؛ ولكنه – رضي الله عنه – علم قيمة الدنيا فأعطاها مُستحقها، وعلم قدر الآخرة ففرغ قلبه لها، وعمل عملها، وسعى لها سعيها.
وقد حاول أمراءُ الجيش أن يُحسِّنوا من هيئته المتواضعة أمام الأعداء؛ ولكن مَنْ يقدرُ على مَنْ؟ أيقدرون على عمرَ الذي كان كبيرُ الشياطين يخافُه، ويسلكُ فجًّا غير فجّهِ؟!
قال له أبو عبيدة – رضي الله عنه -:”يا أمير المؤمنين، لو ألقيت عنك هذا الصوف، ولبست البياض من الثياب، لكان أهيبَ لك في قلوب هؤلاء الكفار، فقال عمر – رضي الله عنه -: “لا أحب أن أُعَوّد نفسي ما لم تعتده، فعليكم معشر المسلمين بالقصد”[10].
وباءت مُحَاولة أبي عبيدة بالفشل فحاول يزيدُ بنُ أبي سفيان – رضي الله عنهما – فقال: “يا أمير المؤمنين، إنَّا في بلد الخَصْب والدعة، والسعر عندنا بحمد الله رخيص، والخيرُ عندنا كثير من الأموال والدوابّ والعيش الرفيع، وحالُ المسلمين كما تحب، فالبس ثيابًا بيضًا واكسُها الناس، واركب الخيل واحمل الناس عليها؛ فإنه أعظم لك في عيون الكفار، وألْقِ عنك هذا الصوف؛ فإنَّه إذا رآك العدوّ على هذه الحال ازدراك، فقال عمر – رضي الله عنه -: “يا يزيد ما أُريد أن أتزيَّا للنَّاس بما يَشِينُني عند الله – عزَّ وجلَّ – ولا أريد أن يعظم أمري عند الناس، ويصغر عند الله – عز وجل – فلا ترادّني بعدها في شيء من هذا الكلام”[11].
وواصل عمر – رضي الله عنه – مسيره إلى بيت المقدس على تلك الحال المُتَواضِعَة؛ فعرضت له مخاضة طين فَنَزل عن بعيره، ونزع نَعْلَيْه فأمسكها بيدٍ وخاض الماء ومعه بعيرُه، فقال له أبو عبيدة: “قد صنعت اليوم صُنعًا عظيمًا عند أهلِ الأرض، صنعت كذا وكذا، قال: فصكَّ في صدره وقال: أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذلَّ النَّاس، وأحقر النَّاس، وأقلَّ النَّاس، فأعزَّكم الله بالإسلام فَمَهْمَا تَطْلُبوا العزَّ بغيره يذلكم الله”[12].
فلما بلغ بيت المقـدس خرجَ إليه بطْريَرْكها صفـرونيـوس وكتب عمر – رضي الله عنه – لهم الأمانَ لأنفسهم وأموالهم وكنائسم وصلبانهم، ولا ينتقص شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم في مقابل أن يعطوا الجزية للمسلمين[13]، وسلَّم البَطْريَرْك مفاتيح القُدس لعمرَ بن الخطاب – رضي الله عنه – ثُمَّ بَكَى البَطْريرك فقال له عمر: “لا تحزن، هَوِّنْ عليك، فالدنيا دواليك، يومٌ لك ويومٌ عليك”، فقال البطريرك: “أظننتني على ضياع الملك بكيت، والله ما لهذا بكيت، وإنما بكيتُ لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية، ترق ولا تنقطع، فدولةُ الظلم ساعة، ودولةُ العدلِ إلى قيام الساعة، وكنت حسبتها دولة فاتحين تمر ثم تنقرض مع السنين”[14].
وتَمَّ الفَتْحُ، ودخل عمر بيت المقدس من الباب الذي دخل منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم – ليلة الإسراء، وصَلَّى فيه مستقبلاً القبلة، وجعل يزيح بردائه الأقذار التي رماها النصارى في قبلته. ولما رأى المسلمون فعْلَ عمرَ أخذوا في تنظيف المسجد من أقذار النصارى[15]، ثم بعد الفتح عاد – رضي الله عنه – إلى المدينة على ذات الجمل الذي قدم عليه، وعلى نفس الهيئة التي كان عليها قبل الفتح؛ لأنَّ اهتمامه – رضي الله عنه – ما كان بالشكليات والمظاهر، وإنما كان بأصول الشيء ومعانيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 7 – 8].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
الخطبة الثانية:
الحمدلله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن أصدق الـحديث كـلام الله – تعالى – وخير الهدي هدي محمد – صلى الله عليه وسلم – وشرَّ الأمـور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها المؤمنون: ظل بيتُ المقدس عبر تاريخه الطويل حافلاً بالأحداث العظيمة منذ أن سكنه خليلُ الرحمن إلى يومنا هذا، وسيستمر حافلاً بالأحداث الكبرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ إذ إن الأحداث العظام في آخر الزمان ستكون على أرضه كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
افْتَتَحَ بيتَ المقدس عمرُ بن الخطاب – رضي الله عنه – في السنة الخامسة أو السادسة عشرة للهجرة[16]، وظَلَّ تحت حكم المسلمين خمسة قرون؛ حتى استولى عليه الصليبيون في أثناء حكم العبيديين الباطنيين حينما حكموا الشام، ومكث في أيدي الصليبيين قريبًا من تِسْعينَ سنةً، ثُمَّ استردَّه المسلمون في حكم الأيوبيين، وظل في حوزة المسلمين أَكْثَرَ من ثمانية قرون، إلى أن جاء الاستعمارُ الظالم فاستولى عليه وسلّمه لليهود في أواسط القرن الهجري الماضي.
إنَّ الملاحظ – أيها الإخوة – أنَّ المسلمين لما فتحوا بيتَ المقدسِ تحت إمرة عمر – رضي الله عنه – ما استلموا مفاتيحه من اليهود وإنما من النصارى؛ بل اشترط النصارى على عمر – رضي الله عنه – أن لا يسمح لليهود بدخوله؛ لأنَّهُمْ قَتَلَةُ المسيح حسب زعم النصارى، فكيف يسكنون بلد المسيح عليه السلام؟! ووافق عمر على هذا الشرط. وفي العهد الأموي تسلَّل إلى بيت المقدس عشرة يهود، واشتغلوا فيه خدمًا فَطَرَدَهُم عمرُ بن عبدالعزيز لما تَوَلَّى[17]، ولما استولى الصليبيون عليه أبادوا من كان به من اليهود، وأحرقوا عليهم دورهم[18]. ثم فجأة إذا بالاستعمار النصرانيّ يُسلّم القدس لليهود، فلماذا هذا التغير؟ وما الذي دهى النصارى؟!
لقد لعِبتِ العصاباتُ الصِّهْيَوْنِيَّة الإنجيلية النصرانية لعبتها، وقذفت في روعِ النصارى أن نُزول المخلصِ عيسى – عليه الصلاة والسلام – الذي سيخلصهم من المسلمين حسب زعمهم لن يكون إلا باستيلاء اليهود على القدس، وتجمعهم فيها، وجعلها عاصمة لليهود، وأنَّ الحروب الصليبيَّة لن تتوقف إلا بذلك؛ فوافقت هذه الفكرةُ هوًى في نفوس النصارى خاصَّةً بعد أن أنهكوا من جراء الحروب مع المسلمين، وبعد أن فَشِلَتْ مساعي الاستعمار الحديث بالمقاومة الصَّامدة من قِبَلِ الشُّعوب الإسلامية المستعمرة؛ فتآزرت الصِّهْيَوْنِيَّة النصرانية مع الصِّهْيَوْنِيَّة اليهودية في هذا السبيل؛ تحقيقًا للعقيدة الألفية التي أصلها عقيدة يهودية[19].
وملاحظةٌ أخرى جديرة بالتأمل وهي: أن اليهود ما حاربوا عبر تاريخهم الطويل ولو مرَّةً واحدة من أجل الاستيلاء على بيت المقدس؛ ففي تاريخهم الحديث سلّمهم النصارى بيتَ المقدس، وفي تاريخهم القديم دعاهم موسى – عليه الصلاة والسلام – لمحاربة الكنعانيين ودخولها فامتنعوا ورفضوا[20].
فمتى كان اليهود أهل حرب ومبادأة بها؟ أيوم قال لـهم موسى – عليه الصلاة والسلام -: قاتلوا، فقالوا: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [المائدة: 24] أم يوم دعاهم – عليه الصلاة والسلام – إلى الفتح وقد مهَّد الله لهم أسبابه، وفتح لهم بابه؛ فارتجفوا كالشياه المذعورة وقالوا: {إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} [المائدة: 22].
هذه بطولات اليهود! يريدون من يحارب عنهم، ويُخرجُ لهم العدو من القلعة ليدخلوها فاتحين، وما تبدَّلت حالهم. إنَّهُمْ كما كانوا من قبل يقاتلون بسلاح سواهم، ويُلوحون بقوةِ غيرهم[21].
فليس بلاءُ المسلمين من قُوَّة اليهود؛ وإنَّما من ضعفِ المسلمين أنفسهم، حينما انتشرت فيهم العقائد المنحرفة، والأخلاقُ الفاسدة. حينما اعتمدوا على حولهم وطولهم، واغترّوا بعددهم وكثرتهم؛ فوكلهم الله إلى أنفسهم. حينما تخلَّوْا عن هدى الله، وركنوا إلى الذين ظلموا، في عصبيَّاتٍ جاهليَّة، وأحزابٍ ضالَّة، وقوميَّات ضيِّقة، ينفخ فيها دعاةُ كنعان، ودعاةُ العروبة، ودعاةُ التراب والوطن، فما زادهم ذلك إلا ذُلاًّ وانهزامًا.
أما آن للأمة أن تستفيد من تلك النتائج المرَّة، التي أفرزتها التجارب المخزية، فتعود – أفرادًا وجماعات – إلى كتاب ربها، وسنةِ نبيها بفَهْم سَلَفِها قولاً وعملاً؟! وبذلك سيكونُ النصر والخير، والصلاح في الدنيا والآخرة، ولن يَصلُحَ آخرُ هذه الأمة إلا بما صلَحَ به أولها.
ألا وصلوا وسلموا على محمد بن عبدالله؛ كما أمركم بذلك رب العزة والجلال.
[1] قيل: كان فتحه في ربيع الأول، وذكر الطبري أنه كان في ربيع الآخر، وأما سنته فذكره كل من الطبري وابن الجوزي وابن كثير في حوادث سنة (15هـ)، وذكره الذهبي في حوادث سنة (16هـ)، وهو قول ذكره الطبري أيضًا، وذكر البلاذري أنه كان في سنة (17هـ)، وانظر: “تاريخ الطبري” (2/45)، و”المنتظم” (4/193)، و”البداية والنهاية” (7/45)، و”تاريخ الإسلام” للذهبي (3/162)، و”فتوح البلدان” للبلاذري (144)، و”فتوح الشام” المنسوب للواقدي (1/228).
[2] حديث صلاته – صلى الله عليه وسلم – بالأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – في بيت المقدس مُخَرج في “مسند الإمام أحمد” (1/257)، وصححه ابن كثير في “تفسيره” فقال: إسناده صحيح ولم يخرجوه (3/25)، عند تفسير أول سورة الإسراء، وصحَّحه الشيخ أحمد شاكر في “شرح المسند” (2324).
[3] قصة هرقل مع أبي سفيان مُخَرَّجة في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما -: أخرجها البخاري في بدء الوحي باب (7) حديث (6)، وانظر: “فتح الباري” (1/42-44)، ومسلم في الجهاد باب كتابة النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (1773)، والترمذي في الاستئذان باب ما جاء كيف يكتب لأهل الشرك (2718).
[4] والراجح أنه لم يحصل قتال؛ بل حاصرهم المسلمون فاشترطوا أن يقدم عليهم عمر حتى يباشر الصلح بنفسه لما علموا من عدله – رضي الله عنه – وقيل: “إن صفة من ينتزع بيت المقدس موجودة في كتبهم؛ فأرادوا قبل تسليمه التحقق من كون الوصف الذي جاءت به كتبهم منطبقًا على عمر فكان كذلك فسلموه. انظر: “تاريخ الطبري” (2/449)، و”البداية والنهاية” (7/45).
[5] انظر: “الفتوح” لابن أعثم (1/224-225)، و”تاريخ الطبري” (2/449)، و”البداية والنهاية” (7/45 – 46)
[6] وقيل: بل إن أبا عبيدة والقادة لما بلغهم مقدم عمر ذهبوا يستقبلونه حال دخوله الشام، وانظر: “الفتوح” لابن أعثم (1/226)، و”البداية والنهاية” (7/46) .
[7] “البداية والنهاية” (7/46)، قال الذهبي: “وقدم إلى الجابية – وهي قصبة حوران – فخطب بها خطبة مشهورة متواترة عنه” انظر: “تاريخ الإسلام” (3/162)، و”معجم البلدان” لياقوت (2/91).
[8] “تاريخ الطبري” (2/448)، و”المنتظم” (4/192).
[9] “تاريخ الإسلام” (3/162)، وانظر: “الفتوح” لابن أعثم (1/226)، و”البداية والنهاية”، وفيه أطول مما ذكرت، وعزاه لابن أبي الدنيا (7/49).
[10] “الفتوح” لابن أعثم (1/226) .
[11] “الفتوح” لابن أعثم (1/227) .
[12] “البداية والنهاية” (7/49)، وقصة خَوْضِه – رَضِي الله عنه – في الطين أخرجها الحاكم بسياق أطول وصححها، وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. انظر: “المستدرك” (1/61 – 62) برقم (207).
[13] انظر كتابة الصلح في: “تاريخ الطبري” بأطول مما ذكرت (2/449).
[14] لم أعثر على هذا فيما وقفت عليه من كتب التاريخ وقد ذكره عبدالله التل في: “خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية” (129)، وانظر: “بيت المقدس وما حوله” للدكتور محمد عثمان شبير (44).
[15] “البداية والنهاية” وعزاه ابن كثير للإمام أحمد وللضياء المقدسي، وقال: “وهذا إسناده جيد” (7/48).
[16] انظر: هامش (1) في “تاريخ فتح بيت المقدس”.
[17] انظر: “القدس مدينة الله”، للدكتور حسن ظاظا (97) .
[18] المصدر السابق (99)
[19] وملخص هذه العقيدة الألفية اليهودية: أن اليهود ينتظرون منتظرًا من نسل داود يخرج في آخر الزمان؛ ليحكم العالم ألف سنة يسمى “ملك السلام”، وانسحبت هذه العقيدة على الأصوليين الإنجيليين الذي يحاولون إقناع سائر النصارى بها.
[20] انظر: “محاسن التأويل” للقاسمي (3/92-93)، و”التحرير والتنوير” لابن عاشور (6/161-166) عند تفسير الآيات (22-26) من سورة المائدة.
[21] بتصرف من: قصتنا مع اليهود للشيخ علي الطنطاوي (37).
نقلاً عن موقع الألوكة