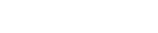خاص هيئة علماء فلسطين
محمّد خير موسى
خاص موقع هيئة علماء فلسطين

لقد انطلقت مسيرة العلم الشرعيّ والدعوة الرّاشدة والفكر الإسلامي منذ البعثة الأولى على أساس من البلاغ الصادق والتكليف الثقيل والموقف الذي يُترجم اليقين إلى صمود والعلم إلى موقف رجوليّ؛ فما الذي حدث حتى انفصمت هذه العلاقة وغاب الصوت حين وجب أن يُدوّي وتوارى الموقف في ستار من الرجولة الوهميّة وتحوّلت شريحة ليست يسيرة من أهل المنابر وحملة المحابر والعلماء إلى أصحاب مواقف صاخبة فيما هو متاحٌ في حدود “السلامة” وتحت سقف “المسموح” وليس ضمن “الواجب” و”الممكن” وغدا التفاخر بهذه المواقف نوعًا من التنافخ الرجوليّ يخفي غياب الرجولة الحقيقيّة في ساحة الموقف؟
مأزق الرجولة في وجه المذبحة
الرجولة ميثاق صدق لا تُوزن بعضلات اللسان بالصراخ المسموح به فوق المنابر ولكنّها تُقاس بقدرة الإنسان على التقدّم حين يتراجع الجمع، وعلى تسمية الأشياء بأسمائها حين يختبئ كثيرون وراء عمائم الصمت وربطات عنق الحياد.
حين تتهاوى العمارات على أطفالها في غزة ويتصاعد الغبار من تحت الأنقاض مخنوقًا بأنين الأحياء تحت الردم ويموت الأطفال في غزّة بردًا إذ تتجمد الدماء في عروقهم على الحقيقة لا المجاز؛ عندها تظهر الحقيقة فكثير من الدعاة والعلماء آثروا الهمس بما هو واجب في الغرف المغلقة وصرخوا على المنابر بما هو مسموح به، وركنوا إلى شعارات الحذر وحديث التوازن ومصطلحات التحفّظ؛ ألا وإنّ من اختار الصمت في زمن المذبحة متذرّعًا بخوف الفتنة فقد شُغلت بصيرته عن موضع الفتنة الحقيقي إذ التبس عليه الخوف بالحكمة والسكوت بالحلم والحذر بالديانة.
وانظر إلى ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 28/166: “وأقوامٌ ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدّين كلّه لله وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة وهذه الفتنة المذكورة في “سورة براءة” دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة؛ فإنها سبب نزول الآية، وهذه حال كثير من المتديّنين؛ يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدّين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات؛ وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فرّوا منه وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور”
تُرى أي توازن يُطلب في ساعة ذَبحٍ جماعيّ؟ وأي حياد يُفهم حين يُنتهك العرض وتُستباح الأرض ويُسحق الطفل تحت سقفٍ خَرّ عليه؟ وأيّة حكمة باردة هذه التي يتلفّع بها البعض عندما يتجمّد الدّم في عروق طفل غزّي؟ إنّ التوازن الذي لا يُغضب الطغاة لا يُنصر به المظلوم، وإنّ الحذر الذي يقي من “الإثارة” لا يصنع الوعي ولا يحرّك الشعوب بل إنّه يكرّس البلادة الجمعيّة ويجعل من المنبر شاهد زورٍ بدل أن يكون شاهد عدل.
لا تنبثق الأزمة هنا من غياب الأجساد عن ميادين القول وإنّما من حضورٍ باهتٍ مشوَّه يحرّف معاني الخطاب الديني عن مقاصده الكبرى؛ حين تُصبح الفتوى تعبيرًا عن الموت البطيء للفكرة، ويظهر الخلل حين تُتلى آيات الجهاد بقلوب باردة تُخرجها عن سياقها وتُختزل “حكمة التريّث” في تغليف العجز بمفردات دينية دون إحساسٍ بحرقة الدم المسفوك أو حرارة القلب المكلوم.
الرجولة موقف يكلّف صاحبه دفع الأثمان، والرّجولة فتوى تزعج المتخاذلين، والرّجولة كلمة تُغضب من فوق العروش وتُحيي من تحت الركام قلوبًا تنتظر أن ترى في العلماء صوتًا للحق لا صدىً للسلطان.
معركة غزة ليست ميدانًا لعدّ الشهداء فحسب، ولكنّها اختبار قاسٍ لمفهوم الرجولة في وجدان العلماء والدعاة، وكلّ تأخّر عن الجهر بالحقّ وكلّ مراوغة عن تسمية المجزرة باسمها وكلّ تحريف كي لا تسمى الخيانات باسمها هو انسحاب من أقدس معركة يخوضها العالِم؛ معركة الوفاء للأمة ومواجهة الطغيان بالبيان.
العلّة في النموذج وليس في النص
النصوصُ الشرعية نزلت لتكون مشاعل في درب التكوين الحضاري؛ تمدّ القلوب بحرارة البصيرة وتحفز العقول إلى الفعل الراشد وتسوق الجوارح إلى ميادين الشهادة على الناس بالعدل، ومن هنا فإنّ الأزمة لا تتبدّى في النص وإنّما فيمن قرأه بخوفٍ مقنّع بالحكمة، وفسّره بعيونٍ اختارت العافية في مواطن البلاء، وجعلت من فقه الاستضعاف منطلقًا للفرار من واجب البيان، ولقد تحوّل فقه النص من جسرٍ للفعل إلى متراسٍ للانكفاء حين صار الفقيه ينشغل بفرعيات الجهاد في الكتب متغافلًا عن دم المظلوم المسفوك على أبواب المساجد والعيادات والمدارس.
الذي جعل العلماء يتكلمون في التفاصيل الفقهية الدقيقة بينما تمرّ فوق رؤوسهم قذائف تسحق الأبرياء هو خللٌ في النموذج المرجعي وارتباكٌ في تموضع الخطاب الديني ضمن خارطة الفعل الإنساني؛ ولم يأتِ هذا من فراغ ولكنّه نتاج مسارٍ طويل من إعادة تشكيل “العالِم” في صورة الناصح المعزول والواعظ المتجرّد من التبعات والمتكلم بلسانٍ بلا موقف.
ما نشهده من ترددٍ أو تواطؤٍ صامتٍ في مواقف بعض العلماء والدعاة ليس ثمرة لحظة طارئة وإنّما هو نتيجة تراكمٍ طويل لإخضاع الدين لفردانية التدين، وانسحاب الدعوة من الشأن العام إلى مساحة الضمير المعزول؛ لقد صار الخطاب الدعوي حسابيًا في لغته يزن كلماته كما تُوزن النقود ويخشى أن تُحسب عليه المواقف كما تُحسب الديون.
ما قيمة منبر لا يُسمع فيه صوتٌ للحق؟ ما جدوى الكلام في فضائل التراحم إذا خرسنا عن المذبحة؟ هذه الأسئلة لا يُجيب عليها علم المصطلح، ولا كُتب الفقه بل يُجيب عليها القلب الذي يتألّم والضمير الذي يرفض أن يُشترى بثمن، والرّجولة التي تتدفّق في عروق صاحبها.
إنّنا حين نتأمل هذا الواقع المربك فليست غايتنا أن نعدّ الغائبين فردًا فردًا ولا نتوقّف طويلًا عند خرائط الأسماء ولكنّنا نسعى إلى أن نغور في التربة التي أنبتت هذا التآكل في الحضور ونقلب السؤال على موضع الخلل الأول: كيف أُعيد تشكيل العقل الدعويّ على هيئة تتهيب الاقتحام وتُحسن الترقّب وتُدرّب على حسابات السلامة أكثر مما تُربّى على شجاعة الوقوف؟ كيف صارت المنابر حصونًا للصراخ في حدود المسموح به حين تجاوزت المذابح حدود المتخيّل؟
الرجولة هنا ليست لقبًا يُمنح بكثرة التحصيل ولا تُنال بطول الصحبة ولكنّها تُكتسب في لحظة انكشاف الحق، ويُختبر صدقها في مقام التورّط النبيل حين تتقدّم الكلمةُ إلى المصير المضحّي ويغدو الصوت ميزانًا يوزن به الرجال.
هكذا يُولد الرجُل في زمن الفقد، وهكذا يُكتب للعالِم خلودُه في سفر الأمة؛ أن يكون حيث الجراح النازفة، وأن يصوغ من كلمته قبسًا يهتدي به من تاه في غياهب التبرير، فمن ارتقى إلى هذا المقام فقد انتصر للدين حين خذله المدّعون، وأقام لله تعالى في الأرض حجته وصار صوته حِصنًا يُؤوي إليه المظلوم وليس صدىً يضيع في صحراء الخطابة الإنشائيّة.