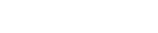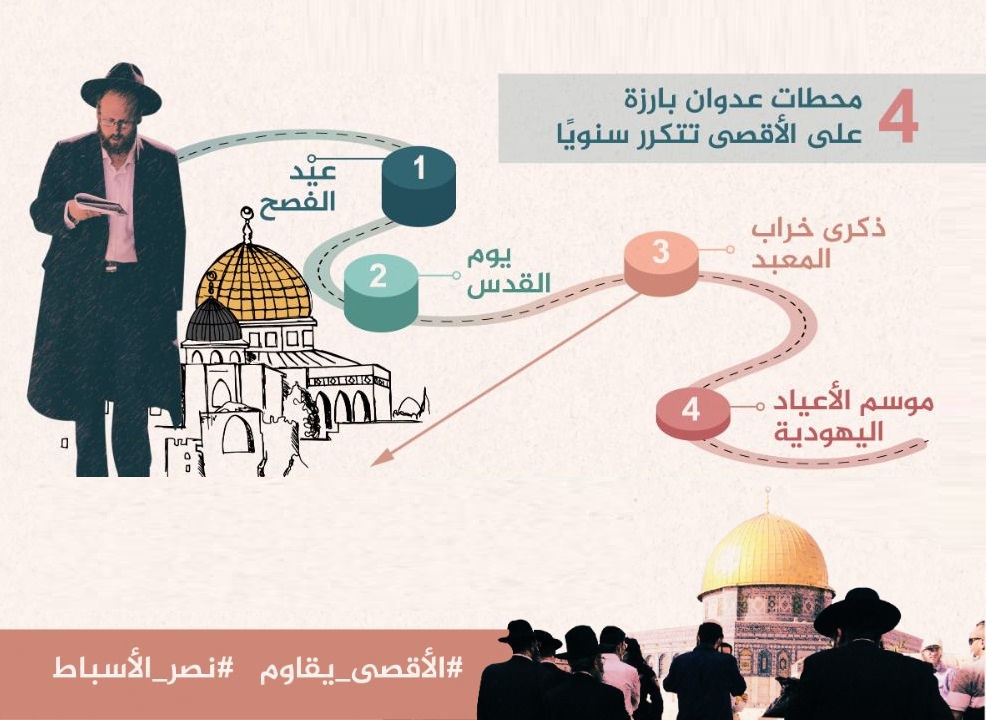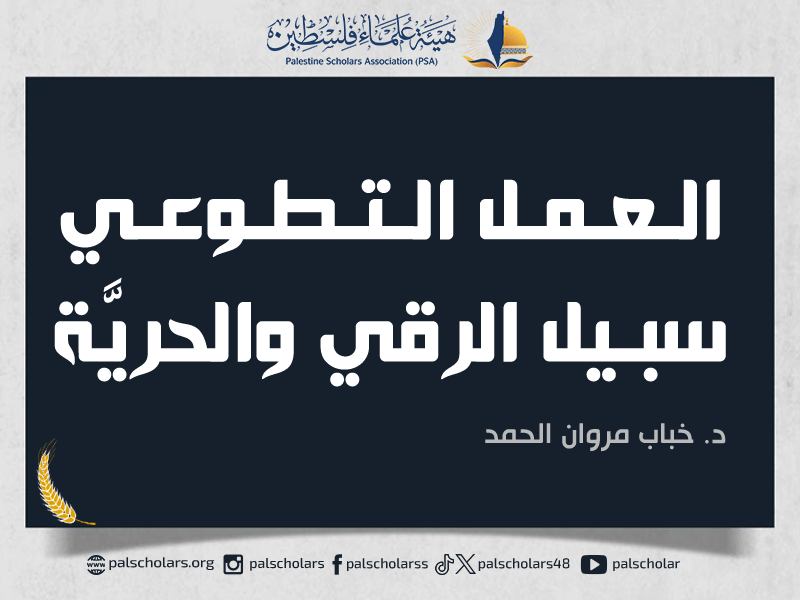2/2/2026
د. نواف تكروري
نقلاً عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: https://iums.me/40943

إنّ مهمةَ العلماءِ والقادةِ الصادقين الذين أُنيطت تصرّفاتهم بمصالح الأمة وحقوقها تتمثّل في جمع جهود الأمة وتوحيد صفوفها على مقاصد الخير، ومعالجةُ أسباب الفرقة المتكرّرة عبر الأزمنة وما تخلّفه من آثارٍ متراكمة في المجتمعات تقوم على ميزانٍ دقيقٍ تحكمه درجة التزام العلماء والدعاة والقادة بجمع الكلمة وبناء القواسم المشتركة؛ فبقدر حضور هذا الالتزام تُحاصر عوامل التشرذم، وبقدر غيابه تتغذّى حالة الانقسام وتترسّخ.
والقيادة الحقّة التي تنهض بالفعل للارتقاء بمجتمعها تجعل من بثّ روح الأخوّة والوحدة بين أبناء المجتمع ــ على اختلاف إثنيّاتهم وتنوّع دوافعهم ــ مسارًا دائمًا في عملها، وهي تدرك أنّ بناء شعبٍ قويٍّ متماسكٍ يتحقّق عبر ترسيخ روح الأخوّة الجامعة، وتوظيف التعدّد والإثنيّات في مساحات التكامل والتنافس المحمود.
أمّا القيادة الداخليّة أو تلك التي تحرّكها مصالح ذاتيّة تقتات من حقوق الشعب والأمّة فهي التي تدفع باتجاه تنمية أسباب الفرقة وتغذية عوامل الخلاف وإذكاء جذوتها حفاظًا على نفوذها واستمرار سيطرتها.
وأسباب الفرقة حضورها قائم في المجتمعات والأمم ومسارها صعودًا أو انحسارًا يرتبط بوعي القائمين على الشأن العام من قادةٍ وعلماءَ ومربّين؛ فقد بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمةٍ مثقلةٍ بالقبليّة، مشدودةٍ إلى التعصّب القبلي، حتى غدا الانتماء للقبيلة موضعَ ولاءٍ وبراء، وبلغ التنافس القبلي مبلغًا دفع بعض الرافضين للإيمان برسالته إلى اتخاذ العصبيّة دافعًا لموقفهم، كما عبّر أبو جهل بقوله: تنازعنا وبنو هاشم الشرف؛ أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأجاروا فأجرنا، حتى تجاثينا على الركب وكُنّا كفرسي رهانٍ متساويين في الفضل، ثم قالوا: منا نبيّ، فمتى يُدرك مثل هذا؟
كما ورد أن الأخنس بن شريق قال يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا، فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمدًا لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بنو قصيّ باللواء والحجابة والسقاية والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟
ويكشف هذا الموقف بجلاء أن التعصّب القبلي كان إطارًا حاكمًا للسلوك والمواقف تتقدّم فيه رابطة الانتماء على مقتضيات الصدق والعدل فيُعطَّل به ميزان الحق وتُستباح بسببه الدماء وتُتخذ المواقف العامة بدافع العصبية للقبيلة بعيدًا عن مقتضيات القيم والمعايير الأخلاقية الجامعة.
ولمّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة المنوّرة واجه مجتمعًا تحكمه الروابط القبلية وتديره منظومات الولاء التقليدية فبادر إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ثم بين الأوس والخزرج من الأنصار جامعًا الجميع على كلمة واحدة ومؤسسًا لوحدة الصف على قاعدة أوسع من الانتماءات الضيّقة وأكثر قدرة على إنتاج التماسك والاستقرار.
فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يرفع فيهم راية جامعة تتقدّم على سائر الرايات وهي راية أخوّة الإيمان بما تحمله من معنى الانتماء القيمي المشترك مع إدراكه لما للترابط القبلي من آثار إيجابية في بعض جوانبه الاجتماعية حين يوضع في سياقه المنضبط.
ورسول الله صلى الله عليه وسلّم إنما بُعث ليُتمّم مكارم الأخلاق كما أخبر عن نفسه صل الله عليه وسلم بقوله: “إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق” فجاءت دعوته لإعادة ترتيب منظومة القيم وضبط موازينها وتوجيهها وفق ميزان الوحي والهداية بما يضمن قيام الجماعة على أسس العدل والتكافل ووحدة المقصد
ورسولُ الله صلى الله عليه وسلّم في ظلّ التعصّب القبلي الذي كان يحكم المجتمعات في ذلك الوقت لم يشأ أن يحارب القبيلة من حيث كونها إطارًا اجتماعيًا قائمًا وإنّما أراد أن يحارب التعصّب القبلي مع إبقاء روح الترابط بين المجتمع وتوجيه الانتماء للقبيلة الوجهة التي تخدم مقاصد الاجتماع والعدل.
فتجده صلى الله عليه وسلّم يفرّق في تعامله بين الانتماء إلى القبيلة والتمسّك بها حين يكون باعثًا على التعصّب والتفرقة العنصرية وبين كونه باعثًا على إحياء روح التنافس في فعل الخير بما يجعلها عنصر دعم للبناء الاجتماعي وليس سببًا في تفكيكه أو تمزيقه.
ففي مصطلح المهاجرين والأنصار نجد أنّ الحقّ سبحانه وتعالى يثني عليه حين يكون مبعث خيرٍ وإيمان ويبعث على الجهاد ونصرة الحق فيقول سبحانه: “وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ”، فجاء الثناء مقرونًا بالفعل والموقف والسياق الذي تتحقق فيه معاني الإيمان والتضحية.
فالله تعالى يرضى عنهم ويثني على صفاتهم ويتبنّى القرآن الكريم تسميتهم مهاجرين وأنصارًا حين تُستخدم هذه المصطلحات في الخير والإيمان وتكون دالّة على معنى الانتماء الرسالي
ولكن عندما يتنادى القوم يوم المريسيع: يا للمهاجرين ويا للأنصار خصومةً وتعصّبًا يُسميها رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم دعوةَ الجاهلية فيقول صلى الله عليه وسلم: “أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟”، فالكلمة واحدة من حيث اللفظ غير أنّ دلالتها تتبدّل بحسب المقصد الذي تُستعمل فيه فلما كانت دعوةَ إيمانٍ وتآلفٍ وتنافسٍ في الخير، كانت: “رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ”، ولما كانت نداءَ تعصّبٍ وتفريق صارت دعوى جاهلية “دعوها فإنّها خبيثة”
وكذلك فيما يتعلق بالأوس والخزرج فلم يُرِدِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلغاء قبائل الناس ولا صِلاتهم وإنما وجّهها الوجهة التي تحفظ معناها الاجتماعي وتضبط أثرها السامي فأكّد ذلك بينهم تأكيدًا شرعيًا فبعد ان جعل التوارث لفترة على اساس مؤاخاة الاسلام لتثبيت الصلة الجديدة التي ارادها لهم اكد سبحانه ان شرعه الحنيف ليس من مراده قطع صلاة النسب والقوم بينهم لذا نسخ تشريع التوارث بينهم على مؤاخاة الاسلام وقرره من جديد على وفق رابطة النسب فقال سبحانه: “وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ”.
ولما استخدم الأنصار العشيرةَ والقبيلةَ في التنافس في الخير ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا أن أيّدهم ووافقهم على ذلك إدراكًا منه لما في هذا التنافس من تحريك للهمم وتسخير للطاقة الاجتماعية في نصرة الحق وذلك أنه لما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم: “من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى اللهَ ورسولَه؟”، فقال محمدُ بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله؛ أنا أقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: “أنت له فافعل إن قدرت على ذلك”
ولما نفّذ محمدُ بن مسلمة المهمةَ بنجاح مع إخوانه من الأوس؛ جاءت الخزرجُ منافسةً في قتال أعداء الله تحمل الدافع ذاته وتتحرّك بالمنطلق نفسه فاستأذنت مجموعةٌ من شبابهم في قتل سلام بن أبي الحُقيق (أبو رافع) وهو يهوديٌّ كان يؤذي المسلمين ويحرّض عليهم كما كان كعبُ بن الأشرف.
وأعلنوا في عرضهم أنهم يريدون أن لا يسبقهم إخوانُهم في الانتقام من أعداء الله فكان هذا الإعلان تعبيرًا عن تنافس موجَّه في نصرة الدين فأذن لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم بقتله وأمَّر عليهم عبدَ الله بن عتيك في صورة واضحة من صور توظيف الانتماء القبلي في ميدان الجهاد المشروع.
بينما لما تنادى الأوسُ والخزرجُ بذات الاسمين فقالت الأوس: يا للأوس وقال الخزرج: يا للخزرج استجابةً لفتنة شاس بن قيس اليهودي الذي ذكّرهم بحروبهم في الجاهلية خرج إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم غاضباً من تفرّقهم وتعصّبهم، وسمّاها دعوى الجاهلية ووصفها بالمنتنة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: “أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة”
كلُّ هذا يدلّ على إقرار النبي صلى الله عليه وسلّم لما في القبيلة من خير وما فيها من تنافس في أبواب الخير وتشجيعه صلى الله عليه وسلّم لهذا التنافس في الخير حين يكون منضبطًا بمقاصد الإيمان ووحدة الصف ولكن حين تُستعمل القبلية استعمالاً تعصبيًا وعنصريًا تتحوّل إلى معول هدم وهذا هو الموضع الذي يتجه فيه البيان النبوي إلى المواجهة والردع.
وصلاحُ الدين الأيوبي ومن سبقه من نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي برزوا في سياقٍ اجتماعيٍّ غلبت عليه المذهبيةُ المشحونة وترسّخ فيه التعصّبُ المذهبي حتى صار الانتماء الفقهي حاجزًا نفسيًا وسلوكيًا، وامتد أثره إلى الواقع التعبدي حيث امتنع أتباع بعض المذاهب عن الصلاة خلف غيرهم بدافع الاعتقاد المتصل بالخلاف.
وتعامل هؤلاء القادةُ المجاهدون والعلماءُ الصادقون مع هذا الواقع بميزانٍ دقيق فكان وعيهم موجّهًا إلى معالجة جوهر الإشكال فركّزوا جهدهم على تفكيك التعصّب المذهبي وضبط آثاره دون المساس بالبنية الفقهية للأمة ولا بتاريخها العلمي.
ومن هذا المنطلق شُيّدت المدارس للمذاهب كافة في صورةٍ مقصودة من صور الاحتواء العلمي مع أنّ صلاحَ الدين كان شافعيًا أشعريًا فجاء هذا التوجّه تعبيرًا عن إرادة واعية لتوسيع دائرة الالتقاء وتحويل التعدّد المذهبي إلى مساحات تكاملٍ وقوّة وتوجيه هذا التنوع ليكون رافدًا للاجتهاد وسعةً على الأمة.
وهكذا استقرّ الوعي القيادي آنذاك على أنّ التعدّد الفقهي بابٌ من أبواب السعة والرحمة وأن الخلل الحقيقي ينشأ من تحوّل الانتماء إلى أداة إقصاء للمخالف وبالتالي تحول التعصّب إلى حالة تضييق وتمزيق للنسيج الجامع للأمة.
ونحن اليوم نعيش زمانًا أُعيد فيه توصيف الجغرافيا السياسية والاجتماعية فحُمِّلت الأقطارُ والأقاليمُ بل المدن صفةَ الدول وتكوَّنت لكل جماعة حدودٌ نفسية وسياسية خاصة بها ونشأ تعصّبٌ قطريٌّ واسع حتى صار ارتباط أهل كل قطرٍ بغيرهم من أبناء الأمة ارتباطَ شعورٍ وجدانيٍّ محدود دون استحضار رابطة الكيان الواحد والمصير المشترك لكل ابناء الامة.
وعلى المستوى القومي تبلورت الهويات العرقية في صور متقابلة فاعتزّ العربي بعروبته، والتركي بتركِيّته، والكردي بقوميته، والفارسي بانتمائه، والملاوي بخصوصيته، وتنامى هذا الاعتزاز حتى تحوّل في كثير من صوره إلى تعصّبٍ حاد وجُعلت القوميات معاقلَ للولاء والبراء وتقدّمت في الوعي الجمعي على الرابطة الدينية الجامعة.
ثم تشكّلت داخل البنية الإسلامية أحزابٌ وجماعاتٌ ومدارسُ وطرقٌ متعدّدة من السلفي إلى الإخواني إلى الصوفي إلى التبليغي إلى التحريري وغيرها من الأطر التي تتقارب وتتنافر، وتلتقي وتفترق في طرائق النظر إلى القضايا والمناهج، ومع اتساع الزمن تعاظم التعصّب لهذه الأطر حتى تحوّلت عند كثيرين إلى دوائر انتماء حادّة ومراكز اصطفاف وجداني وفكري على نحوٍ يُشبه ما جرى في القوميات والأقطار.
ويُطرح في هذا السياق سؤالٌ مركزيٌّ يتصل بفقه الاجتماع الإسلامي وإدارة التعدّد: ما المنهج الأمثل في التعامل مع هذا الواقع المركّب؟ أهو الصّدام مع الأقاليم والأقطار والأقوام والأعراف والأحزاب والجماعات؟ أم يتّسع الإطار الجامع لاحتواء هذا التنوّع وتحويله إلى طاقة تكميلية فاعلة يُنتفع فيها من اختلاف البيئات والإثنيات وتعدّد المدارس؟ إذ إن بعض هذه الانتماءات متصلٌ بأصل الخِلقة والتاريخ كالأقوام والبقاع وبعضها نتاجُ اجتهادٍ بشريٍّ تنظيميٍّ كالأحزاب والجماعات والمدارس وكلّها تشكّل معطيات واقعية تحتاج إلى وعيٍ رشيد في توجيهها وضبط أثرها.
إنّ تنوّعَ الأعراق والأقوام سنّةٌ إلهية جارية في الخلق وهو من آثار التقدير الرباني في البشر حيث تتعدّد الأجناس وتتنوع الألوان وتتباين الألسنة ويُتاح لهذا التنوّع أن يكون مصدرَ إثراءٍ حضاريٍّ وتكاملٍ إنسانيٍّ متى وُضع في إطاره الصحيح؛ فهذا التعدّد يحمل في ذاته قابليةً عاليةً للتكامل والتعاون ويغدو رافعةً للبناء حين يُدار بميزان الهداية والرشاد.
والمشكلة الحقيقية قطعا ليس في هذا التنوع وانما الخلل حين يتحوّل هذا التنوّع إلى تعصّبٍ أعمى ويُستدعى في سياقات الحق والباطل والخير والشر ويُستثمر بوصفه أداةَ فرقةٍ وصدام، وهنا تتجه المعالجة الشرعية إلى تفكيك هذا المسار المنحرف مع تثبيت الحقيقة الكبرى المتمثّلة في أنّ القوميات والأجناس والألوان معطيات خلقية وليست معاقلَ للولاء والبراء ولا موازينَ للتفاضل. فميزان الكرامة والتميّز في التصور الإسلامي يقوم على الإيمان والعمل الصالح وخدمة مصالح الأمة والإنسانية كما دلّت عليه القاعدة النبوية الجامعة: “الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله”، وكما قرّرها الأصل الكلي في قوله صلى الله عليه وسلّم: “لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأبيضَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أبيضَ إلَّا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمَ، وآدمُ من ترابٍ”
ويأتي دور العلماء في بيان هذا الميزان وفي توجيه الانتماءات القومية والقطرية والإقليمية توجيهًا رشيدًا يجعلها روافدَ للتنافس في الخير ومساراتٍ لخدمة دين الله وتحقيق مقاصده ضمن إطار جامع يضبطها بالقيم الشرعية ويمنع انحرافها عن غاياتها.
وما قلناه بشأن الأقوام والأقطار ينسحب على الأحزاب والجماعات والمدارس والطرق إذ يجتمع فيها جانبُ الخير وجانبُ النقص وهي سِمةٌ ملازمةٌ للاجتهاد البشري، ولكلٍّ من هذه الأطر مجالُ إسهامٍ يتكامل مع غيره؛ فمنها ما يخدم باب التزكية والقرب، ومنها ما ينهض بوظيفة الدعوة والحراك، ومنها ما يُعنى بالعلم والتوثيق، ومنها ما يتصل بالإدارة والسياسة، وتقوم مصلحة الأمة على تكامل هذه الأدوار ضمن رؤيةٍ جامعةٍ تُحسن توظيف التنوّع وتمنع تحوّله إلى عامل تمزّق واضطراب.
ولو نظرنا إلى الواقع بعين الحرص على المصلحة الكاملة وبمنظارٍ يستحضر مقاصد البناء والارتقاء لتبيّن بوضوح أنّ الأمة في غنى عن الصراع بين هذه التوجّهات بل هي بحاجة ماسّة إلى تكاملها متى وعَت كلّ جهةٍ موقعها وأدركت أنّها جزءٌ من مسار النهوض العام للأمة وليست هي الأمة بكاملها؛ فلكلّ توجّهٍ مجاله الذي يُبدع فيه وطاقته التي يُسهم بها في تشكيل الجسد الواحد وتطويره دون أن يحتكر صورة الكلّ أو يدّعي تمثيله الكامل.
وأخطر ما تواجهه الأمة في هذا السياق أنّ الجميع يقرّ من حيث العبارة بأنّه جزءٌ من الأمة غير أنّ الممارسة العملية تكشف عن تصوّرٍ مضمر يرى فيه كلّ طرفٍ نفسه الممثّل الأوحد ويُنزِل غيره منزلة الهامش، ومن هنا تنشأ أزمات الاحتكار الرمزي وتتعمّق فجوة الشقاق داخل الصف الواحد.
والمطلوب في هذه المرحلة إدراكٌ واعٍ لحقيقة التعدّد يقوم على فهم الأحزاب والجماعات والمدارس والطرق بوصفها مكوّناتٍ متكاملة كلٌّ منها قائمٌ على ثغرٍ من ثغور الخدمة، وهذا الوعي لا يترسّخ عبر الخطاب الإعلامي وحده وإنما يتشكّل في البنية الداخلية لكلّ حزبٍ أو جماعةٍ أو مدرسة من خلال اللقاءات التربوية والتنظيمية التي تُعيد ضبط المفاهيم وتُصحّح التصوّرات.
وحين ينجح هذا الفهم في النفاذ إلى داخل المؤسسات والجهات الفاعلة وتقتنع به القيادات والكوادر تكون الأمة قد خَطَت خطوةً وازنةً نحو وحدةٍ واعية وتعدّديةٍ متكاملةٍ نافعة، تتلاقى فيها الجهود وتنتظم المقاصد.
وينسحب هذا المعنى على مؤسسات العلماء والجهات الإغاثية والمنصّات الإعلامية ومراكز البحوث وسائر ميادين العمل العام؛ فالإشكال لا يتعلّق بتعدّد الأطر أو كثرة الفاعلين وإنما يتعلّق بغياب النظر إليها بوصفها أجزاءً من جسدٍ واحد تتكامل أدوارها وتتساند مواقفها فتتشكّل من مجموعها قوّةٌ للأمة متماسكة الأثر.
وأمّا الجماعاتُ والأحزابُ والمدارسُ والطرق فقد خبرتُها وعايشتُ أبناءَها على تنوّعهم وأقصد الاسلامية منها فإنني إذ أستبعد من هؤلاء الشاطحَ والناطح؛ كما كان يقول شيخنا القرضاوي رحمه الله تعالى فإننا لا نجد فارقًا بينهم يتجاوز عشرة في المئة؛ إنما الفروق في طريقة التعامل وأساليب إدارة الأمور والنظر إليها، وهي في فروع الشرع والحياة.
وأمّا التسعون في المئة فهي متطابقة عند الجميع إذ الكل متفق على اركان الاسلام واركان الايمان والمشكلة أن كثيرًا من هذه التوجّهات تتعامل مع التسعين في المئة وكأنها عشرة وتتعامل مع العشرة على أنها تسعون؛ فتتّسع ساحة الخلاف وهي ضيّقة وتضيق ساحة الوفاق وهي واسعة.
ولو نظرنا في كثيرٍ ممّا نختلف فيه لوجدنا الصحابةَ الكرام رضوانُ الله تعالى عليهم قد اختلفوا فيه مثله ولكنهم وجدوا جامعًا لا يُلغي خلافهم وإنّما يضعه في موضعه ويحافظ على حجمه ويتعامل معه بقدره.
وأمّا في زماننا فقد ضخّمنا نقاطَ الخلاف حتى أصبحنا نرى المسلمَ الصادق يظنّ أنّ مواقع خلافه مع أخيه جوهرية لا حلّ لها إلا التنافر والتباعد ممّا أدّى إلى ما نحن فيه من ضعفٍ وتمزّق، وليس هذا من صُنع الأعداء كما نزعم وإنّما الأعداء وجدوه فينا فنمَّوه وزيَّنوه وإلّا فنحن صانعوه.
ولو أنّ كلَّ مسلم أو كلَّ جماعة استحضرت حجم الوفاق القائم بينها وبين غيرها من الجماعات وأدركت إمكان توظيف هذا التنوّع دون السعي إلى الإلغاء أو الإقصاء وأحسنت الإفادة من تعدّد الإمكانات وتنوّع الاهتمامات لانتقل العمل الإسلامي من حالة التزاحم إلى حالة التكامل.
ولكي يتحقّق ذلك فإنّني أتوجّه بالدعوة إلى العلماء في هذه الجماعات أن ينهضوا بدورهم الحق وأن يستعيدوا موقعهم الطبيعي في التوجيه والترشيد وألّا يكون حضورهم تابعًا لتيّارات الانفعال أو منساقًا وراء العصبيّات على قاعدة:
وما أنا إلّا من غزيّة إن غَوَت
غويتُ وإن ترشُد غزيّةُ أرشُدِ
وإنما يكون دورهم تأسيسيًا في البناء وجامعًا في التقارب ومؤسِّسًا للتكامل بين هذه الجماعات والمدارس إدراكًا منهم أن أثر الكلمة العلمية الرشيدة يتجاوز الاصطفافات الضيّقة ويصنع ميزانًا يُحتكم إليه عند التباين والاختلاف.
وبالتأكيد ان هذا الدور لا يستقيم أثره ولا يؤتي ثماره إلا حين يتحقّق في نفوسهم أوّلًا ويمتدّ من ذواتهم إلى خطابهم ومن خطابهم إلى ممارساتهم فيغدو العالم عامل جمعٍ ورشد وصاحب بوصلة ومحلّ ثقةٍ وطمأنينة في أوقات التداخل والالتباس.
وأسأل الله تعالى أن يجمع كلمة أمتنا على الهدى وأن يستعملنا في حمل هذه الأمانة وأن يوفّقنا إلى سواء السبيل وأن يجعل اجتماع القلوب مقدّمةً لاجتماع الصفوف ووحدة المقصد أساسًا لوحدة المسار، تحقيقًا لقوله سبحانه:
“وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ”
“وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ”