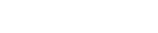خاص هيئة علماء فلسطين
1/2/2025
د. حسن سلمان عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين
مقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) (البقرة: 213)
منذ نشأة البشرية، ارتبطت مسيرتها بالصراعات والتدافع البشري لأسباب متعددة، فقد كان التعدد الثقافي والاقتصادي والديني والسياسي محركًا أساسياً لهذه الصراعات، وعلى مدار التاريخ حاولت القوى المتصارعة إضفاء طابع مختلف على دوافع صراعاتها، سواء كان دينيًا، أيديولوجيًا، أو اقتصاديًا.
——-
عوامل الصراع الحضاري:
- ظاهرة الاختلاف: تختلف الأمم والشعوب في العقائد، الأفكار، والتصورات، مما يؤدي إلى نشوء صراعات حول طبيعة الحياة، الحقوق، والواجبات.
- ظاهرة التنوع: تختلف الموارد والاحتياجات بين الدول والشعوب، مما يخلق تباينات في أنماط توزيعها وإدارتها، سواء عبر التعاون أو النزاع.
- توهم شح الموارد وندرتها: بالرغم من الوفرة الطبيعية للموارد، فإن النزعة الاستهلاكية والسياسات الاقتصادية غير الرشيدة تدفع العديد من الدول والشعوب نحو صراعات من أجل السيطرة على الموارد.
——-
البعد الأيديولوجي للصراعات الدولية:
خلال العصور الوسطى، لعب الدين دورًا محوريًا في النزاعات الدولية، كما في الحروب الصليبية التي اجتاحت المشرق الإسلامي بدوافع دينية معلنة، ومع تطور الفكر الغربي وتراجع الهيمنة الدينية في أوروبا، تم استبدال الصراع الديني بصراعات أيديولوجية وسياسية دون استبعاد الدين تماما كمحرك من المحركات يتم توظيفه متى كانت الحاجة إليه.
——-
نظريات تفسير الصراع الدولي:
- النظرية الواقعية: تركز على القوة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدول، متجاهلة الأبعاد الثقافية والدينية.
- نظريات البعد الحضاري والثقافي: تعتبر أن الصراعات الدولية لا يمكن فصلها عن العوامل الدينية والثقافية، وهو ما ظهر جليًا بعد الحرب الباردة في صراعات مثل البوسنة والهرسك.
——-
صدام الحضارات: (رؤية صمويل هنتنغتون)
يرى صمويل هنتنغتون في كتابه صدام الحضارات أن الصراع المستقبلي سيكون بين الثقافات والحضارات وليس بين الدول القومية أو الأيديولوجيات، حيث ستكون الانقسامات الكبرى في العالم ذات طابع ثقافي وديني.
أبرز ملامح نظريته:
- السياسة الدولية يعاد تشكيلها بناءً على الخطوط الثقافية.
- الأمن الدولي يرتبط بالهوية الثقافية أكثر من سيادة الدول.
- الهوية الثقافية ستحدد طبيعة الصراعات المستقبلية.
نهاية التاريخ :(رؤية فرانسيس فوكو ياما)
يؤكد فوكو ياما في نظريته حول نهاية التاريخ أن الديمقراطية الليبرالية الغربية هي النموذج النهائي للحكم، ويرى أن التحديات الجديدة التي تواجه الرأسمالية تأتي من الدين والقومية.
نظرة ريتشارد نيكسون إلى الإسلام السياسي:
في كتابه نصر بلا حرب، يتحدث نيكسون عن الأصولية الإسلامية باعتبارها العدو الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويؤكد على أن الصراع القادم سيكون بين الغرب والإسلاميين الذين يسعون للوصول إلى السلطة.
——-
الرؤية الإسلامية لعوامل الصراع:
الإسلام لا يعتمد على نظرية العامل الواحد في تفسير الصراعات البشرية، بل يقدم رؤية شاملة تفسر كافة أشكال الصراع، حيث إنها رؤية جامعة مانعة تشمل جميع أنواع النزاعات والمدافعات، وذلك من خلال العوامل التالية:
1. العامل الديني:
الدين هو رسالة الله تعالى لعباده، ويتضمن الهدايات الكلية والجزئية، ولهذا فهو الحاكم على كل قضايا الحق والعدل. غير أن طبيعة الناس في تعاملهم مع الدين ليست واحدة؛ فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، وهذا الاختلاف يؤدي إلى الصراع عندما يكون مصحوبًا بالبغي والعدوان والهوى. كما أن بعض الأفراد قد يوظفون الدين لأغراض سياسية أو دنيوية، خلافًا لمراد الشارع من إقامة الدين. قال تعالى:( (هَـٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُوا۟ فِی رَبِّهِمۡۖ فَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِیَابࣱ مِّن نَّارࣲ یُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِیمُ) الحج/١٩،(إِنَّ ٱلدِّینَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَـٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاۤءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡیَۢا بَیۡنَهُمۡۗ وَمَن یَكۡفُرۡ بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ) آل عمران/19
وقد يكون الاختلاف الديني في تأويل النصوص لا في أصل الدين، كما هو الحال في الصراعات الداخلية بين أتباع الدين الواحد، وهو ما شهد به التاريخ البشري.
2. الصراع القومي والإثني:
التنوع القومي والإثني بين الشعوب والقبائل ظاهرة اجتماعية أقرها القرآن، حيث جعلها من الآيات التي يتأمل فيها أهل العلم والفكر، ويمكن أن تكون مصدرًا للثراء المعرفي والثقافي. إلا أن هذا التنوع قد يتحول إلى تعصب أعمى يؤدي إلى النزاعات بين الأمم، نتيجة الاستعلاء والكبرياء والطغيان. قال تعالى: (وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِی نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَـٰثࣰا تَتَّخِذُونَ أَیۡمَـٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَیۡنَكُمۡ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرۡبَىٰ مِنۡ أُمَّةٍۚ إِنَّمَا یَبۡلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦۚ وَلَیُبَیِّنَنَّ لَكُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ مَا كُنتُمۡ فِیهِ تَخۡتَلِفُونَ) النحل/٩٢.
وقد جاء الإسلام بمفهوم الأمة الواحدة، القائم على الإخوة الإيمانية، وليس العصبيات القبلية أو القومية. قال الله تعالى:
“إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ“ (الحجرات: 10(إِنَّ هَـٰذِهِۦۤ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةࣰ وَ ٰحِدَةࣰ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ“ (الأنبياء: 92.
وقد حذر النبي ﷺ من العصبية القومية فقال:
“ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية“ (رواه أبو داود.
إلا أن الواقع يشهد بأن بعض الحروب والصراعات قامت على أسس قومية أو شعوبية أو عرقية.
3. صراع المصالح والموارد:
المصالح السياسية والاقتصادية تُعدّ من أقوى العوامل التي تؤدي إلى الصراعات بين الدول والجماعات. قال الله تعالى:
“وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبࣰّا جَمࣰّا“ (الفجر: 20.
وقد قامت العديد من الحروب المعاصرة، مثل الاحتلال والاستعمار، بدوافع اقتصادية، كالرغبة في السيطرة على الموارد الطبيعية والأسواق التجارية.
4. المحرك الشيطاني:
الرؤية الإسلامية تؤكد أن الشيطان حاضر في جميع الصراعات، فهو المحرض الأول على النزاعات والفتن بين البشر. قال تعالى:
“إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ أَن یُوقِعَ بَیۡنَكُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَاۤءَ“ (المائدة: 91.
كما قال النبي ﷺ:
“إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم“ (رواه مسلم.
فالشيطان يعمل على زرع الفتن، وتعزيز الأنانية القومية، والتحريض على الصراع، كما أنه داعية للفقر ومُعارض لحكمة الله في توزيع الأرزاق قال تعالى:
“ٱلشَّیۡطَـٰنُ یَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَیَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَاۤءِ“ (البقرة: 268.
——-
غزة نموذج للصراع الحضاري:
تكشف الحروب المتعاقبة على فلسطين أن الصراع الدولي ليس مجرد نزاع سياسي، بل هو صراع حضاري بين الإسلام والقوى الصهيو-صليبية، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لإعادة تعريف القضية الفلسطينية ضمن أطر سياسية وقومية ووطنية بحتة، إلا أن المقاومة الفلسطينية تدرك أن الحل لا يكمن في التسويات السياسية، بل في القوة والمقاومة وتعزيز الهوية الدينية والثقافية.
وقد شهدنا كيف تحرك العالم الغربي لحماية الكيان الصهيوني ودعمه، متجاهلًا الانتهاكات الحقوقية والجرائم ضد الإنسانية التي حولت قطاع غزة إلى هدف حربي، في ظل حصار شامل يهدف إلى الإبادة والتهجير، متجاهلًا القوانين الدولية التي تؤكد أن فلسطين قضية شعب تحت الاحتلال.
——-
خاتمة:
وخلاصة القول، لا يمكن تفسير الصراعات الدولية فقط بالمصالح الاقتصادية والسياسية والعوامل المادية، بل إن العامل الحضاري والثقافي والديني يلعب دورًا محوريًا في تشكيل هذه النزاعات، وإن تجاهل البعد الديني والثقافي في تفسير الصراعات يؤدي إلى تغييب الوعي وإضعاف قدرة الأمم على مواجهة التحديات، مما يعزز هيمنة الثقافة والحضارة الغالبة، مستنزفًة الموارد المادية والمعنوية للأمة المسلمة، دون وجود العوامل المحفزة للمقاومة والجهاد كما أشار العلامة ابن خلدون في مقولته الشهيرة:
“المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب”