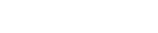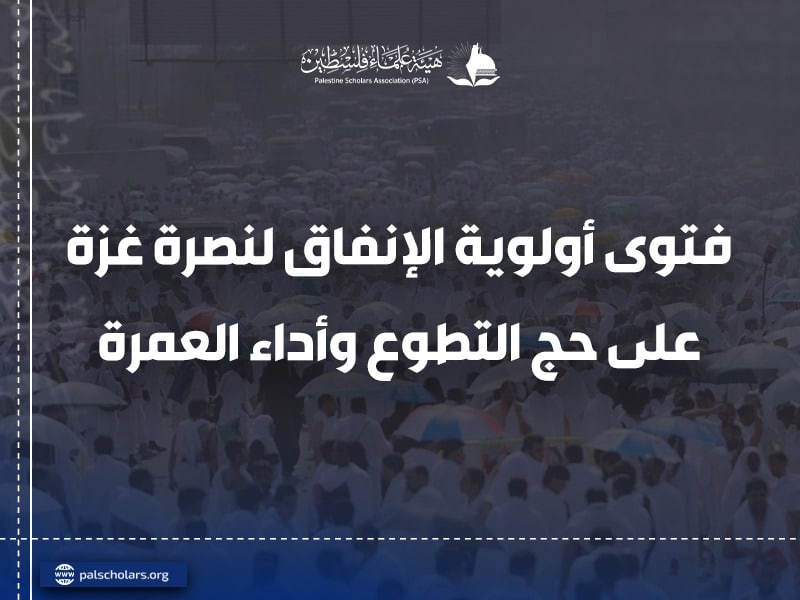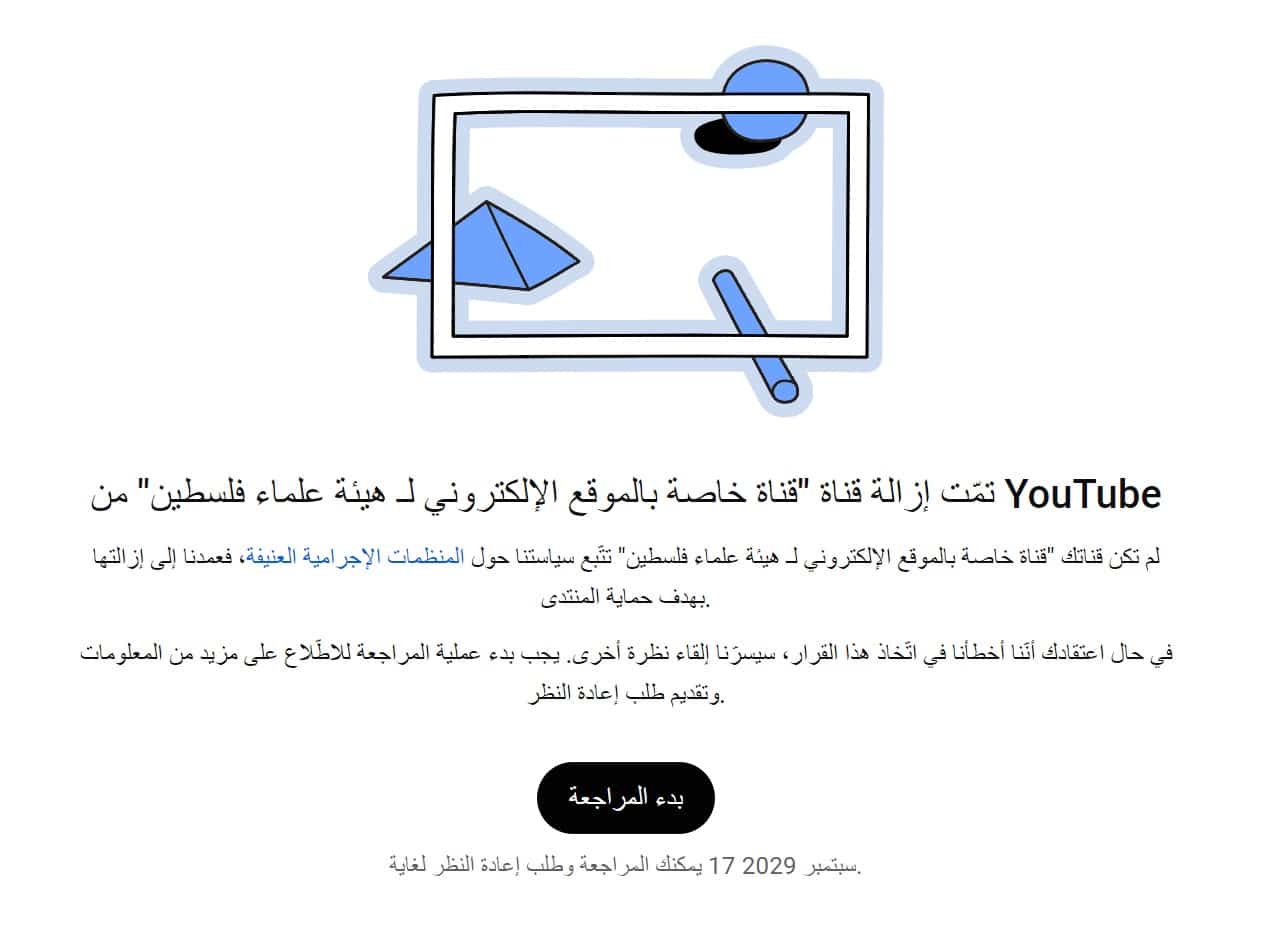خاص هيئة علماء فلسطين
23 ربيع الأول 1447هـ 15/9/2025
السؤال:
هل يصح الاستشهاد بصلح الحديبية على ما كان من معاهدات السلام التي وقعتها بعض الدول العربية مع اليهود، مع ما صحب ذلك من تطبيع للعلاقات؟
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالأصل أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع ينبغي الاقتداء به فيه واتباع أثره واستلهام هديه صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب، قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} الأحزاب 21
ولا يستثنى من ذلك سوى الأحكام التي ثبتت خصوصيتها به صلوات ربي وسلامه عليه.
ولكن الاستشهاد بفعله صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور لا بد له من تحقيق المناط، وهوَ نظرُ الفقيهِ – حين استعماله القياس – في تحققِ (العلّةِ) في (الفرعِ) أو عدمِ تحقُّقها.
فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى – مثلا – إلى جهة الجنوب حين كان بالمدينة، وقال (ما بين المشرق والمغرب قبلة) لكن هذا الحكم ليس بعام، بل هو في حق أهل المدينة ومن كان في جهتهم، أما من كان في ماليزيا – مثلاً – فلا يصح منه أن يصلي إلى الجنوب استدلالاً بالنص السابق؛ إذ الجنوب ليس علة التوجه وإنما الكعبة هي المقصودة بالتوجه
فكذلك الأمر في المصالحة مع الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار، لكن ذلك الصلح كان غير مخالف لنص قطعي، وكان المراد منه جلب المصالح للإسلام وأهله ودرء المفاسد عنهم. وللصلح – في كلام الفقهاء – تفصيلات كثيرة؛ لكن ثمة أمران لا بد من تحققهما من أجل أن يكون سائغاً شرعا:
الأول: أن يكون الصلح مما يوافق أحكام الشريعة في أصله وتفصيلاته، فلا يشتمل في أصله أو تفاصيله على ما يضاد أو يناقض الأحكام الشرعية.
الثاني: أن يكون مبناه على ارتياد ما هو في مصلحة الإسلام والمسلمين؛ فالصلح الذي يجلب على المسلمين الضرر، سواء في دينهم أو دنياهم، وكذلك الصلح الذي لا يجلب نفعاً، هو صلح لم يقم على قاعدة ارتياد الأصلح، وكل عهد أو صلح بين المسلمين وبين الكفار لم يحقق هذين الأمرين، أو أحدهما فهو صلح لا يعتد به شرعاً، وهو صلح باطل؛ لأنه أُسس على غير التقوى.
وإذا نظرنا فيما أبرم من معاهدات من بعض الدول العربية مع الكيان تجدها خالية من ذينك الأمرين الرئيسين، بل تضمنت من المخالفات الشرعية ما لا يخفى على ذي بصيرة، بل تجد الفروق واضحة بينها وبين صلح الحديبية الذي كثيراً ما يستشهد به هؤلاء، ومن ذلك:
أولاً: أن صلح الحديبية كان مؤقتا، وهو بالمفهوم المعاصر هدنة أي وقف لحالة الحرب لمدة عشر سنوات، وليس إنهاءً كلياً لها مع استمرار العدوان، وبالتالي فقد أجمع العلماء على أن الصلح مع الأعداء المعتدين على سبيل التأبيد لا يجوز، وإنما يجب أن يكون مؤقتاً بزمن، أو على أوسع الأقوال مطلقاً عن التأقيت بمعنى أن المدة مفتوحة، ولكن يملك كل من الطرفين انهاءها إذا رأى ذلك.
وأما المعاهدات التي أبرمت بين الصهاينة وبعض بلاد العرب فإنه منصوص على ديمومتها واستمرارها حتى سميت بالصلح الدائم والشامل، أو (معاهدة السلام الدائم).
ثانياً: أن صلح الحديبية كان تحقيقاً لمصالح المسلمين واعترافاً من قريش بهم، ومصالحات العرب اليوم على العكس تماماً فهي اعتراف بكيان غاصب متسلط على مقدسات المسلمين – بعد أن كنا نرفض وجوده لقيامه على العدوان والإجرام، فهي خضوع لمراد العدو وتأكيد لوجوده وإقرار له بما استولى عليه من بلادنا. بعد أن كانت تلك الدول ممتنعة عن ذلك الاعتراف حيناً من الدهر.
ثالثا: إن صلح الحديبية عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمثِّل المسلمين جميعاً، فكان جمعاً للأمة على خيار سلم مؤقت تُحفظ فيه الحقوق وتنتشر فيه الدعوة إلى الله تعالى ولا يتنازل به عن حقوق الناس، وأما مصالحات حكام العرب فهي تفريق للمسلمين بحيث ينفرد العدو بكل بلد منهم على حدة، حيث لا تسمح هذه الاتفاقيات للمسلمين بنصرة بعضهم بعضاً، بل تجعلهم كيانات متفرقة يتعامل كل منها مع العدو من مواطن الضعف التي كبَّلتهم وتحول دون موقف موحد لهم. والكيان قادر على كل واحد منهم بمفرده والاتفاقيات تحول دون تجمعهم ليمثلوا قوة تصد عنهم؛ فهي فرصة يغتالهم واحداً بعد الآخر بفعل هذه المصالحات الهزيلة.
رابعاً: أن استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلح لم يكن على حساب دماء المسلمين وحقوقهم وإنما على شرط رعايتها وحمايتها، ولذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتلته قريش بايع أصحابه على الموت انتصاراً لدمه، ولم يقل إنني مستعد للصلح وهو (استراتيجي) مع قريش مهما فعلت ليس أمامي إلا الصلح كما يفعل العرب اليوم.
فواقع هذه المصالحات أنها قد فرقت شمل المسلمين، وما زال العدو يمارس أثناءها وبعدها كل ألوان القتل والهدم والإجرام والعدوان ضد إخوانهم، والبلاد المصالحة ترعى الصلح وتصونه على حساب دماء المسلمين، فإن من أبسط المسلمات ألا ينقض العدو شرطاً من شروط الصلح، وها هم الصهاينة يشتمون الإسلام ونبي الإسلام علانية، ويهينون المصحف ويقتلون المسلمين ويدنسون المقدسات تحت سمع وبصر تلك الدول التي صالحتهم يهينون، ومع ذلك لا يحركون ساكناً بدعوى أن بينهم وبين الصهاينة معاهدات!! بينما نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أعانت قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرسل صلى الله عليه وسلم إلى قريش نذيراً، بل اعتبر عهدهم منقوضاً، وطفق يجهز جيشه حتى باغتهم في مكة فاتحاً منتصرا، أما هذه المعاهدات – على فرض صحتها – فإن العدو الصهيوني قد مارس كل ألوان النقض لها، من القتل والتدمير وسبِّ الرسول صلى الله عليه وسلم وتدمير المساجد وتدنيس المصحف واقتحام الأقصى، وما زال عاقدو هذه المعاهدات يرونها مستمرة يصونونها ويقدسونها، رغم نقض العدو لها في كل يوم، بل في كل ساعة.
وعليه فإن تلك المعاهدات لا يجوز قياسها على صلح الحديبية، ولا أن تقاس أفعال حكام العرب المعاصرين على ما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا القول بأن ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام أو إحياء لسنته، هيهات هيهات؛ بل إن نسبة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر جرما من الفعل نفسه.
أخيراً فإن الصلح الذي كان مع قريش إنما هو وقفٌ لحالة الحرب لظروفٍ لصالح الطرفين، مع استمرار حالة العداء، بينما مصالحات بلاد العرب مع الكيان تقوم على وحدة الحال والشراكة وتبادل العلاقات الدبلوماسية والثقافية والتجارية، وتمرير السلاح له لقتل المسلمين، فأي عاقل من المسلمين يمكن أن يلحق هذه بتلك؟
ولو قيل: بأن الضرورة تقتضي وقف حالة الحرب مع يهود، فهل اقتضت الضرورة وحدة الحال معهم، بل ودعمهم ضد المسلمين؟
إن هذه ليست مصالحة مشروعة، بل خيانة وجريمة عظيمة يستحق مرتكبها المحاكمة والعزل عن تولي أمر من أمور المسلمين، والله الهادي إلى سواء السبيل.