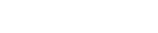خاص هيئة علماء فلسطين
13/1/2026
بقلم د. يونس محيي الأسطل عضو رابطة علماء فلسطين وعضو المجلس التشريعي
[ضمن نشاطات أسبوع القدس العالمي6]
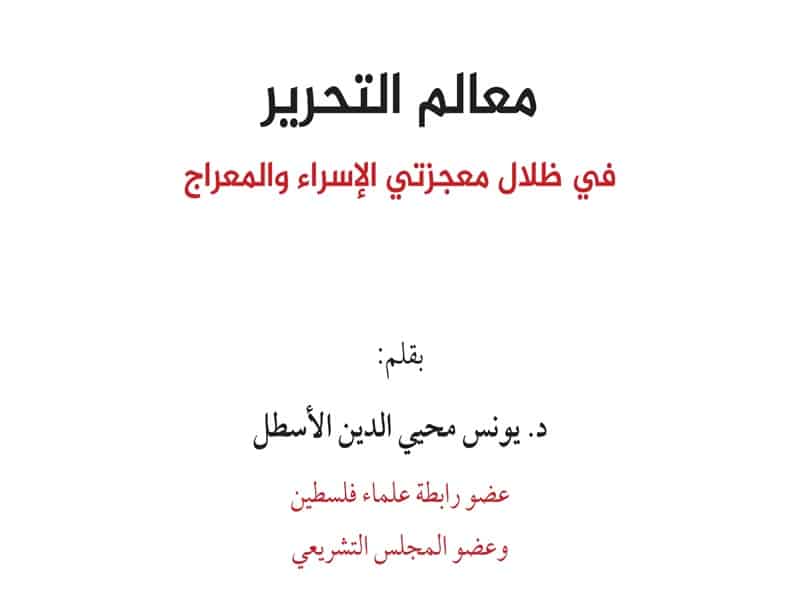
الحمد لله الذي يقصُّ علينا من أنباء الرسل ما يُثَبِّتُ به أفئدتنا، ويفرغ علينا من الصبر ما يُثَبِّتُ به أقدامنا، وينصرنا على القوم الكافرين، كما يؤتينا بعدم وَهْنِنا ولا ضعفنا ولا استكانتنا، وبدعائنا كذلك ثواب الدنيا، وحسن ثواب الآخرة، والله يحبُّ المحسنين.
أما بعـد:
فإن الظروف التي يعيشها قطاع غزة يمتحننا الله بها؛ لِيَصنَعَنَا على عينه، من الدمار، والحصار، والقتل، والنزوح، وحياة الخيام، ومقاساة الآلام ، تشبه تلك الأيام العصيبة التي أحاطت بالنبي ، والسابقين الأولين إلى الإسلام، لاسِيَّما في العام الثانيَ عشرَ للبعثة الذي نُعِتَ في السيرة النبوية بعام الحزن، حيثُ تُوفِّيَ فيه أبو طالب عمُّ رسول الله ، وهو الذي أخذ على عاتقه، مع رهط بني هاشم وبني المطلب، أن يمنعوا طواغيت قريش من أن ينالوا من ابن أخيه عليه الصلاة والسلام؛ بدافع العصبية والحمية، وإذا بأولئك السفهاء يتسلطون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل إنهم أرادوا رأسه في مرحلة لاحقة، وقد تزامن ذلك مع موت زوجه الوحيدة خديجة بنتِ خويلد رضي الله عنها التي كانت تُسَرِّي عنه ما كان يلقاه من العنت، وقد تسلَّل سِرَّاً إلى ديار ثقيفٍ بالطائف مؤمِّلاً أن يجد فيهم أنصاراً، ولكنْ هيهات، فقد تشابهت قلوبهم، ولم يكن ردُّهم أقلَّ سوءاً من قريش نفسِها.
في هذه الأثناء جاءت رحلتا الإسراء والمعراج؛ ليرى من آيات ربِّه الكبرى ما تتضاءل معه تلك القوة الغاشمة لقريشٍ أو ثقيف؛ بل للعرب والجزيرة، ثم العجم والقُوى العالمية، وإنهم جميعاً -أمام ملكوت السموات والأرض- ليسوا إلا كَمَثَلِ العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فلله جنود السموات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكان الله عزيزاً حكيماً، ولو تَخَيَّلنا أنَّ الرسولَ قد ألقى نظرة إلى الأرض وهو يَصَّعَّد في السماء، فكم يكون حجمها في نظره، وكم يكون حجم مكة فيها، ولو أنه عندما وصل إلى سدرة المنتهى، ورأى من آيات ربِّه الكبرى، راح يتخيَّل مكةَ ومَنْ فيها، والطائفَ ومواليها؛ لَمَا ساوت ذرة هباء في جَوِّ السماء.
ولما كانت سنن الله لن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً؛ فإننا متفائلون ونحن في ذكرى معجزتي الإسراء والمعراج أن نستنبط منهما من المعاني ما يربط الله به على قلوبنا، ويثبت به الأقدام، ويكون نوراً لنا ودستوراً لتحرير الأسرى والمسرى، وإنقاذ البلاد والعباد من براثن الأوغاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، بل وتحرير الإنسان وجميع البلدان يومَ نُتَبِّرُ ما علاه بنو إسرائيل تتبيراً، ونقيم الخلافة الراشدة الوارثة لأنظمة الحكم الجبري بعد قرنٍ من احتلال فلسطين، وإسقاط الخلافة الإسلامية، وصيرورتنا كالقصعة التي يتداعى إليها الأكلة.
والآن تعالوا بنا إلى طائفةٍ من المعاني أو المعالم المستوحاة من معجزتي الإسراء والمعراج؛ لعلها تكون نبراساً للتحرير والتطهير؛ حتى تعود أرضنا مُقَدَّسَةً للرُّكعِ السجود، ومباركة للوجود؛ فإن الله تبارك وتعالى قد بارك فيها للعالمين مشارِقها ومغارِبها؛ بدءاً من المسجد الأقصى، مروراً بما حوله من العريش إلى الفرات؛ ولتكون عاصمة للخلافة، وراثةً لأحلام بني إسرائيل، أولئك الذين جاء الله عز وجل بهم لفيفاً لوعد الآخرة؛ فريقاً تقتلون، وتأسرون فريقاً، وهو حكم الله في المفسدين، وقد أغرق به فرعون ومَنْ معه جميعاً، وأخذ به ثمود بعد أن قيل لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، حين استحبوا العَمَى على الهُدَى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فقد عَقَرُوا الناقة، وعَتَوْا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تَعِدُنا إنْ كنت من المرسلين.
(1) إنِّ المعلمَ الأوَّلَ مستفادٌ مِن الحِكَم الكبرى لتلكُما المعجزتَين؛ فقد نَصَّتْ سورة الإسراء على أُولاهما في أولها، وأكَّدت سورة النجم باليمين أنه رأى من آيات ربِّهِ الكبرى، وكيما نعلم الحكمة من تلك الحكمة دعونا نذهبْ أولاً إلى مشهدٍ من قصة سيدنا موسى، خاصة وأن سورة الإسراء قد ربطت بين الإسراء وقصة سيدنا موسى عليه السلام من الآية الثانية مباشرة؛ لوجود شبهٍ كبيرٍ بين رسالة سيدنا موسى وقصة الإسراء، ولأن سورة الإسراء تبشِّر بنهاية بني إسرائيل.
إن الله عز وجل قد نادى سيدنا موسى من جانب الطور في البقعة المباركة من الشجرة، وأراه عصاه وهي تنقلب حيةً تسعى، كأنها جانٌّ، فولَّى مدبراً ولم يُعَقِّب؛ لولا أن ربَّنا تبارك وتعالى قد أذهب عنه الرَّوْعَ قائلاً: لا تخفْ؛ إنك من الآمنين، فخذها ولا تخفْ، سنعيدها سيرتها الأولى، واضممْ يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوءٍ آية أخرى؛ لنريك من آياتنا الكبرى؛ اذهب إلى فرعون إنه طغى.
لقد كان سيدنا موسى هارباً من بطش فرعون منذ عشر سنين، حين مكر به الملأ من الفراعنة وبني إسرائيل ليقتلوه، فقد كان من شيعةٍ استضعفها فرعون، فَذَبَّحَ أبناءهم، واستحيى نساءهم؛ لكنه مكلَّفٌ الآن أن يذهب إلى فرعون، فيقول له: هل لك إلى أن تزكَّى، وأهديك إلى ربك فتخشى؛ وهو بذلك مأمور أن يتحوَّل تابعاً وتلميذاً لموسى عليه السلام، كما أنه مطالب أن يرفع يده عن بني إسرائيل؛ ليصبحوا ملوكاً أحراراً، يذهبون حيثُ يشاؤون، وقد كان سلاحه في هذا ما رأى من آيات ربِّه الكبرى.
وهكذا؛ فإن نبيَّنا عليه الصلاة والسلام قد انتقل في كثير من أنباء الغيب إلى عين اليقين؛ فإنه يوشك أن يهاجر، ويقيم سلطان الإسلام في الأرض، فترميَه العرب عن قوسٍ واحدةٍ، فضلاً عن دسائس اليهود والمنافقين؛ فما الذي يُقْحمه في ذلك التحدي، لولا أنه رأى من آيات ربِّه الكبرى ما جعله يهزأ بقوة عدوِّه، حتى لو جاؤوا زاحفين بخيلهم ورَجِلِهم، في الوقت الذي اسْتُدْرِجَ فيه إلى ساحة بَدْرٍ بمجموعةٍ من المشاة، وهم لا يتوقعون قتالاً؛ بل لم يخوضوه من قبلُ، وليس معهم إلا السيوف في قِرابِها، لكنْ أنَّى للمشركين أن يصمدوا أمامَ ألفٍ من الملائكة مُرْدِفِينَ، أو ثلاثة آلافٍ من الملائكة مُنْزَلين، أو خمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين، وهم يروننا مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ العين، مع أنه عز وجل قد قَلَّلنا في أعينهم قبل الالتحام، وقَلَّلهم في أعيننا على الدوام؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، فقد أُخِذوا بالبطشة الكبرى، وكانت عليهم طامةً كبرى.
وهكذا بقية الغزوات كان اليقين بربِّ العالمين، ثم بآلاف من الملائكة منزلين، مع ما شاء ربُّنا من الجنود الآخرين، هو ما يربط الله به على قلوبنا، ويثبت به أقدامنا، مما رآه نبيُّنا عليه الصلاة والسلام من آيات ربِّه الكبرى، لاسيَّما في الغزوات التي هدفت إلى فتح الطريق إلى بيت المقدس، أو فتح بيت المقدس نفسِها، ودخول المسجد الأقصى، وتطهيره للعاكف فيه والباد، خاصة بعد الإغراء بشدِّ الرحال إليه أسوةً بما كان إليه من الإسراء.
(2) وأما المعلم الثاني المستوحى من حِكَمِ المعجزتين؛ فهو أن الله عز وجل أراد أن تكون تلك الرؤية فتنة للناس، واختباراً لإيمانهم، فيزداد الذين آمنوا إيماناً، ويزداد الذين كفروا رِجْساً إلى رِجْسِهِمْ، بينما ينقلب ضعاف الإيمان على أعقابهم، وكان مَثَلُ تلك الرؤيا أو الرؤية مَثَلَ الشجرة الملعونة في القرآن، تلك هي شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم؛ فإن الذين كفروا جحدوا قدرة الله في إنبات الشجرة في الدرك الأسفل من النار، بينما أيقن المؤمنون بها أن الله على كلِّ شيءٍ قدير.
ويعود السرُّ في هذه الحكمة إلى أن الهجرة، وإقامة الدولة، تحتاج إلى الرواحل أُولي البأس الشديد، بينما ضعاف الإيمان لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خَبَالاً، فأراد ربُّك أن يعلم مَنْ يتبع الرسول ويُصَدِّقه ممن ينقلب على عقبيه في قضية كبيرة إلا على الذين هدى الله.
ولذلك؛ فإن تحرير فلسطين لن يكون إلا بعبادٍ لله أوُلي بأس شديد، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم، ممن إذا رأوا الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً، وممن يَنْفِرون خفافاً وثقالاً، ويُجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فهم يُسارعون في الخيرات، وهم لها سابقون.
(3) وأما المعلم الثالث فمستنبطٌ من رؤية رسولنا جنة المأوى عند سدرة المنتهى، وقد رأى ألواناً من النعيم العظيم المقيم فيها، وإذا رأيتَ ثَمَّ رأيتَ نعيماً وملكاً كبيراً، ولذلك فإن الله عز وجل جعل العروة الوثقى بينه وبين عباده المؤمنين صفقةً تجاريةً يبيعون فيها أنفسهم وأموالهم لله بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، فَيَقْتلون ويُقْتَلون، وحين حرَّضهم على القتال أمرهم أن يُسارعوا إلى مغفرةٍ من ربهم، وجنةٍ عَرْضُها السموات والأرض، أُعدت للمتقين الذين يخشون ربَّهم بالغيب، وهم من الساعة مشفقون، كما نهى عن حسبان أن تدخلوا الجنة حتى يعلمَ الذين جاهدوا منكم ويعلمَ الصابرين؛ بل أقسم ليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين، ويَبْلُوَ أخباركم.
وفي المقابل فإن رؤية طائفة من العذاب في الجحيم لِأَكَلةِ الربا، وأكلة أموال اليتامى ظلماً، والزناة، وأصحاب الغيبة، وغيرِهم، كلُّ أولئك كان سَيِّئُهُ عند ربِّك مكروهاً؛ أيْ محرَّماً، ومن كبائر الإثم والفواحش، ولا جدال في أن الفرار من النار هو الذي يدفعنا لاحتمال حَرِّ الدنيا، ولظى الحرب، وحين قال المنافقون: لا تنفروا في الحرِّ كان جوابهم: {قل نار جهنم أشد حرَّاً؛ لو كانوا يفقهون} (التوبة: 81).
إن بعض الصحابة حين أُمِروا أن يجمعوا حطباً، ويُورُوا فيه ناراً، وأن يقتحموها، كان رفضهم معلَّلاً أننا ما خرجنا للجهاد إلا فراراً منها، وقد جاء في الحديث (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ)، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مشفقين من الساعة، يحذرون الآخرة، ويخافون سوء الحساب، فإنه يوم عسير على الكافرين غير يسير، فهو عَبوسٌ قَمْطَرير، تتقلَّب فيه القلوب والأبصار، ويجعل الوِلْدانَ شِيباً.
(4) إن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليكون العروج منه إلى الله ذي المعارج، ولم يكن من البيت العتيق مباشرة، كان وضعاً له أمانةً في أعناقنا؛ لنسعى لتحريره رغم كوننا مستضعفين في مكة؛ بل في أحلك ظرفٍ أمنيٍّ وسياسي، ويكفيه أنه كان مُدَنَّساً بالاحتلال الروماني قرابة سبعة قرون، باستثناء بضع سنين غُلِبَ فيها الروم، وسيطر فيها الفرس على الأقصى وفلسطين ما يناهز تسع سنين، وقد وقع الإسراء في تلك الفترة؛ لأن عودة الروم للغلبة على فارس كانت في العام الثاني للهجرة، وجاءت متزامنةً مع غزوة بدر الكبرى التي فرح فيها المؤمنون بنصر الله، وكان ذلك فيما دون أربع سنين من تلك المعجزة.
لذلك فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطط لذلك التحرير عبر إقامة قاعدةٍ للإسلام، وعاصمةٍ تُتَّخذ نقطة انطلاق نحو الشام، غير أن ذلك تراخى إلى ما بعد فترة الدفاع والمقاومة التي انتهت بمعركة الأحزاب، وتأكدت بصلح الحديبية، فلما أَمَّنَ الجبهة الجنوبية تفرَّغ للزحف شمالاً؛ بدءاً بخيبر، ثم بمؤتة، ومن بعدها غزوة تبوك، ثم جيش أسامة بن زيد الذي عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عهده بالدنيا، وأنفذه أبو بكر رضي الله عنه، رغم ارتداد معظم العرب عن الإسلام، ولم يُثْنِهِ ذلك عن المضيِّ في جولات تحرير فلسطين، وإنقاذ المسجد الأقصى.
بل إن أبا بكر حين أحس ببأس الروم، وأن ذلك قد يؤخِّر كسر شوكتهم، وفكَّ رقبة المسجد منهم، أمر خالداً رضي الله عنه أن يترك فتوح العراق، أو الاشتباك مع الفرس، وأن يتوجه من فوره إلى الشام، فغامر رضي الله عنه، ووصل إلى الشام في أقلَّ من أسبوعين، غير أن أبا بكر لم تكتحل عيناه برؤية الأقصى محرراً، فقد عاجلته المنية، وتسلَّم مفاتيحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أربعة أشهر من الهزيمة النكراء للروم في اليرموك.
وحين وقع أسيراً في أيدي الصليبيين مع نهاية القرن الخامس الهجري قام العلماء يُحْيُونَ علوم الدين، ويُرَبُّون عليها جيلاً بعد جيل، وبعد ثِنتيْن وتسعين سنة كان صلاح الدين الأيوبي بجيلٍ من عبادٍ لله أُولي بأسٍ شديد قد كسر شوكتهم في معركة حطين، وتسلَّم مفاتيح بيت المقدس تارةً أخرى بعد أربعة أشهر كذلك من تلك المعركة الفاصلة، وفي السابع والعشرين من رجب سنة583 هـ، وهو ذكرى معجزتي الإسراء والمعراج على الغالب.
ثم إنه حين هاجم المغول والتتر بلاد الشام، لم يشأ المماليك في مصر أن ينتظروا حتى يغزوهم في عقر دارهم، فتحركوا تلقاء فلسطين، وكسروا شوكتهم في عين جالوت، وكنسوهم من الشام والعراق والحجاز، فيما لا يجاوز ثلاث سنين من تاريخ وصولهم إلى بغداد، أو ثماني سنين من بَدْءِ غزوهم للجزيرة عام 650 هجرية، بينما كانت عين جالوت في 658 للهجرة.
وإن وقوع المسجد الأقصى في أيدي الصليبيين منذ عام 1917م، ثم في أيدي الصهاينة في عام 1967م، ليس بِدعاً في التاريخ من قَبْلِ الإسلام ومن بعده، فقد أفسد فيه القوم الجبارون، ثم بنو إسرائيل، فغزاهم البابليون والأشوريون، ثم سيطر عليه جالوت وجنوده، فهزمهم طالوت وجنوده وهم أذلة؛ لمَّا كانوا يظنون أنهم ملاقو الله، فقالوا: كم من فئةٍ قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، وقتل داوود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلَّمه مما يشاء، كما في سورة البقرة (246-251).
ولا زالت عقيدة الإسراء والمعراج، وأن جنود السموات والأرض التي رآها نبيُّنا رأي العين، هي التي ربط الله بها على قلوبنا في انتفاضة المساجد عام 1987م، ثم في انتفاضة الأقصى عام 2000م، وانتفاضة القدس عام 2015م، إلى حرب طوفان الأقصى مع يقيننا أن التحرير وشيك، ولن يضروكم إلَّا أذىً، ولئن نصرهم المنافقون والمشركون ليولن الأدبار، ثم لا يُنْصَرون، وذلك هو المعلم الرابع.
(5) إن المعلم الخامس هو ما أنبأت به سورة الإسراء، وخلاصته أن بني إسرائيل بدل أن يأخذوا الكتاب بقوة، وأن يذكروا ما فيه، وهو الذي آتاه الله سيدنا موسى هدىً لبني إسرائيل، ناهياً إياهم أن يتخذوا من دونه وكيلاً، غير أنهم نبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمناً قليلاً، وأَمْسَوْا يوقدون نار الحرب، ويسعون في الأرض فساداً، وأنهم سيتخذون من الإفساد سبيلاً للعلو الكبير في أرض المسجد الأقصى، وأن ذلك سيقع منهم مرتين.
ولما كان من سنته سبحانه أنه إذا أَمَرَ قريةً بالطاعة، ففسق مترفوها؛ حقَّ عليها القول، فدمرها تدميراً؛ فإن بني إسرائيل بذلك الإفساد والعلو الكبير يكونون قد حقَّت عليهم كلمة العذاب، وحاق بهم ما كانوا يكسبون.
وحالئذٍ؛ فإنه عزَّ وجلَّ سيبعث عليهم عباداً له أُولي بأس شديد، ليسوا متفوِّقين لا في العُدَّة، ولا في العدد، غير أنهم يعشقون الشهادة والحياة في جوار الله بأشدَّ من حرص اليهود على الحياة أيِّ حياة، مهما كانوا فيها أذلةً صاغرين، وفي المرة الأُولى يتمكنون من الجوس خلال ديارهم فريقاً يقتلون، ويأسرون فريقاً، وقد يذرونها خاوية على عروشها.
ثم إنه بعد حين يردُّ الله جل وعلا الكرة لبني إسرائيل على الذين سُلِّطوا عليهم أول مرة، ويُهَيِّئُ لهم أسباب الانتصار؛ بأن يجعلهم أكثر أموالاً وأولاداً، وأن يجعلهم أكثر نفيراً؛ اغتراراً بالقوة المادية، وبسبب دخول الأولين في الوَهْن، وهو حُبُّ الدنيا، وكراهية الموت، أيْ أنهم يتعرضون لسنة الله التي أخذ بها بني إسرائيل من قبل.
ألم تروا إلى أجيال خلتْ من فجر القرن الماضي، وحتى صعود انتفاضة المساجد في العقد الأخير من القرن العشرين؛ أنهم قد بلغ بهم الإلحاد أن يقولوا: إن الدِّينَ أَفْيُوُن الشعوب، وأنه بالإمكان التعايش مع الفساد والعلو الكبير للاحتلال عبر القبول بالتقسيم، والاكتفاء بما تيسَّر من فلسطين؛ للتمتع بحكمٍ ذاتي، حتى لو أسميناه دولة أو امبراطورية، وهي لا تعدو مخترةً في مقاولة أمنية؛ للحصول على لقمة العيش، ولو تغمَّست بالجُبْن، بل بدماء الشهداء، ودموع الثكالى، وصديد الأطفال الذين يحترقون بالشموع.
وأما في المرة الثانية، أو وعد الآخرة؛ فإن بني إسرائيل يُجاء بهم إلى فلسطين لفيفاً؛ حتى إذا بلغوا بالفساد وجوه العلو الكبير المتعددة، وأحاطت بهم خطاياهم، بعث ربُّنا جلَّ جلاله عليهم عباده أُولى البأس الشديد، ليسوموا بني إسرائيل سوء العذاب، ويحرِّروا فلسطين، ولكنْ عبر ثلاث مراحل، يتمكنون في الأُولى من إساءة وجوه اليهود، ويدخلون في الثانية المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وأما الثالثة فهي التي يُتَبَّرون فيها ما عَلَاهُ بنو إسرائيل تتبيراً.
وأعتقد أننا بصدد هذه المرة، فقد جاء اليهود لها لفيفاً بالهجرات الجماعية، تلك التي تصاعدت وتيرتها بعد المقاولة الأمنية في أوسلو، مع مَنْ وَالاهم، فكان منهم؛ بعد أن لم يكونوا منكم ولا منهم؛ بل كانوا مُذَبْذَبِينَ بين ذلك، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، ولكنهم اليوم يسارعون في نُصْرَتِهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة.
إن بضع السنين الماضية قد أمكننا ربُّنا جلَّ وعلا من أن نَسُوءَ فيها وجوههم؛ بإفشال ثلاث غزوات، لم يستطع فيها الصهاينة أن يحققوا أياً من أهدافهم؛ باستثناء قتل المدنيين من النساء والبنين، فضلاً عن طرد الاحتلال من القطاع، ثم القضاء على فلتان مَنْ لهم من بني جلدتنا من الإخوان، ثم انتزاع الأبطال في صفقة وفاء الأحرار.
ولعل تباشير المرحلة الثانية في معركة طوفان الأقصى؛ فإنها تُفضي غالباً إلى دخولنا المسجد الأقصى فاتحين مُطَهِّرين، وقد لا تحتاج إلى خمس سنين، فإن انتفاضة المساجد صمدت سبع سنين عجاف، وإن انتفاضة الأقصى قد حَرَّرت غزة في خمس سنين، وقد تختصر معركة الطوفان ذلك في ثلاث سنين.
وأما المرحلة الثالثة؛ فإن أمتنا تتأهَّب لها عبر اكتساب الخبرة العسكرية القتالية في صراعها مع دخول بعض دولنا المعركة مع الصهاينة وإسناد غزة عسكريا، فإننا لنرجو ألَّا تستغرق خمس سنين من تاريخ وُصولنا إلى بيت المقدس، والقضاء المبرم على الاحتلال ومَنْ معه من الحِبَال في الضفة الغربية، والجهة الشرقية من القدس الأَبِيَّة.
(6) وأما المعلم السادس فهو ما نصَّ عليه السياق بعد البشارة بالتتبير للعلو الكبير من أن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ويُبَشِّر المؤمنين الذين يعملون الصالحاتِ أن لهم أجراً كبيراً، فهو أقوم الطرق وأقصرها لتحقيق البشارة بالقضاء المبرم على المفسدين في فلسطين.
وكيما نكونَ على يقين من هذه الحقيقة تعالوا ننظرْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حقَّق وجوب العودة إلى البلد الأمين في ثماني سنين، حين رسم المولى تبارك وتعالى له خارطة الطريق، وأنزل عليه وهو في دربه إلى المدينة: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} (القصص: 85).
فقد عرف أن القرآن هو طريق العودة؛ ووجه ذلك أن القرآن يصنع الإنسان خلقاً آخر، لا يحزن على الدنيا، ولا يخاف الموت، ويرى في القتل في سبيل الله فوزاً بالحياة في أسمى معانيها؛ فإن غاية ما يرجوه من بيع النفس والنفيس لله أن يفوز بالمغفرة والجنة، وإن الله جعلنا خير أمة أخرجت للناس؛ لتحريرهم من قبضة الطواغيت، وليكونوا أحراراً في دينهم ومعتقداتهم، وما أُرْسِل نبيُّنا عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين، وقد أرسل ربنا تبارك وتعالى رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.
إن مثل القرآن في صناعة الرجال من الغلمان والأشبال كعُود زرعٍ أخرج شطأه وبراعمه، فآزره وغَذَّاه، فما لبث أن استغلظ واستوى على سوقه؛ يعجب الزُّرَّاع من قوته وسرعة نمائه؛ ليغيظ بهم الكفار، وهكذا غلمان المساجد المنتظِمون في حلقات تحفيظ القرآن المنخرطون في الأنشطة العامة، الملتزمون بالتربية الخاصة، وهم فتيان حَزَاوِرة؛ أي يشبهون البالغين في الفهم والهمة؛ فإنهم وقود المقاومة والانتفاضة، والقتال من مسافة صفر، فهم حقيقةً عبادٌ لله أولو بأسٍ شديد.
وقد اتخذ قومنا هذا القرآن مهجوراً؛ بل اتخذوه وراءهم ظهريَّاً؛ حين رضوا بالقومية العربية عقيدة للتحرير، ثم تقزَّموا في الوطنية الفلسطينية، وغلب عليهم الفكر اليساري الإلحادي، أو العلماني الذي يزدري الدين منهجاً للتحرير، فوقع التيه، وانسلخ أربعون سنة منذ سقطت الخلافة إلى الميلاد الخداج لمنظمة التحرير، وإن شئتم قلتم من قيام الكيان اليهودي عام 1948م إلى آخر عام 1987م، حيث انطلقت انتفاضة الأشبال والمساجد، وتمكنت من تعجيز اليهود سبع سنين، ثم انكمشت سبعاً أخرى منذ اتفاقية أوسلو إلى اشتعالها من جديد من ساحات الأقصى عام 2000م، وعلى رأس سبعٍ أخرى كان ترحيل الاحتلال، وتحجيم الفلتان في عام 2007م، وبعد سبع أخرى كان تعجيز الاحتلال عن العودة إلى الهيمنة على غزة؛ بل ونسف نظريته الأمنية في الحرب الخاطفة، وسياسة الأرض المحروقة بإيقادها في جبهة الخصم، فضلاً عن التفاخر بقوة الردع، وقوات النخبة لجيش لا يُقهر؛ إنه قد استحال بعد الجرف الصامد إلى جرفٍ هارٍ، فتآكلت قوة الردع، واضطر الصهاينة إلى الملاجئ لأيام عديدة، مع هزيمة مخزيةٍ لقوات النخبة في الحروب البرية، فضلاً عن إبداعات المقاومة الإسلامية التي جعلت ما سُمِّي بجيش الدفاع جيشَ دفاع من وراء الجُدُر والقباب الحديدية، وما وقائع إبداع المقاومة في حرب الطوفان عنا ببعيد.
ولن تَمُرَّ سبع حججٍ أخرى حتى يكون الاحتلال من الهوان بحيث يتسوَّلُ التهدئة أو الهدنة بأثمانٍ باهظة، وما أظنه ينالها بمشيئة الله وفضله؛ فإن الإيمان والقرآن هو سلاحنا ونورنا على درب التحرير.
(7) وأما المعلم السابع فإنني أنتزعه من المدة التي احتاجها الصحابة الأولون من تاريخ الإسراء والمعراج إلى دخول المسجد الأقصى، وتحرير الأرض المقدسة؛ إذْ إنها لم تزد على سبعة عشر عاماً؛ فقد وقعت المعجزتان قبل الهجرة بسنة ونصف تقريباً في منتصف عمر النبوة، وكانت معركة اليرموك في عام 15هـ، وبعدها بأربعة أشهر فتحنا القدس صلحاً، فالمدة لم تستغرق أكثر من سبعةَ عشرَ حَوْلاً، صعد فيها الإسلام من القاع الأمني إلى العلو الكبير بالقضاء على الاحتلال الروماني الغربي.
ومن المعلوم أن آخر الحروب التوسعية للاحتلال كانت في عام 1982م، وقد انطلقت المقاومة المتواضعة بالمسدسات هناك في عام 1983م، ولم يصل عام 2000م حتى كانت السيارات المفخخة قادرة على التدمير التام لمبنى قيادة الاحتلال في صور، وهو القائم على سبعة طوابق، فإذا بالاحتلال يمسي في جنوب لبنان، ويصبح منكمشاً في الجليل داخل فلسطين، والمدة لا تزيد عن سبعة عشر عاماً.
ومن الجدير بالإشارة أن انتفاضة الحجارة قد كنست الاحتلال من جنوب فلسطين عام 2005م بعد سبعَ عشرةَ سنة من شرارتها الأُولى بتاريخ 9/12/1987، وباعتقادنا أنه إذا كان بداية التحرير قد حصل بهذا التوقيت؛ فإن نهاية التحرير لا يحتاج لأكثرَ من ذلك، وهذا يتوافق مع الإرهاصات والدراسات التي تقول بأن عام 2027م سيشهد نهاية ما يسمى بإسرائيل.
(8) وأما المعلم الثامن فمأخوذٌ من رواية ابن جرير الطبري لبعض المشاهد التي رآها نبيُّنا عليه الصلاة والسلام وهو على متن البراق، فقد نقل عنه ابن كثير أنه أتى على قوم يزرعون في يوم، ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل: ما هذا؟، قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيءٍ فهو يُخْلِفه، وهو خير الرازقين.
إن القرآن قد شهد بصدق ذلك حين ضرب المثل للنفقة الصغيرة أو الكبيرة التي تنفقونها في سبيل الله بحبة قمحٍ أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء؛ بل إن من يقرضِ الله قرضاً حسناً يضاعفه له أضعافاً كثيرة، والله يقبض ويبسط، وإليه ترجعون، فما بَالكُم لو كنتم ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل؟!، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكُلَّاً وعد الله الحسنى، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ بل ينفرون خفافاً وثقالاً، ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم موقنين أن ذلك خير لهم، وأن الذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقون في سبيل الله؛ فَبَشَّرهم بعذابٍ أليم يومَ يُحمى عليها في نار جهنمَ، فَتُكْوى بها جباهُهم وجنوبُهم وظهورُهم.
ألستم معي أن ذلك المشهد من أُجور المجاهدين حين علمه الصحابة الأولون من رؤيا العين والقلب كان دافعاً لأن يقولوا: إنا لَصُبُرٌ في الحرب، صُدُقٌ عند اللقاء، ولو استعرضت بنا هذا البحر، فَخُضْتَه لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد، فجالدت مَنْ دونه لجالدناهم معك، ما تخلَّف منا رجل واحد، ولن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربُّك فقاتلا؛ إنا ههنا قاعدون؛ بلِ اذهبْ أنت وربك فقاتلا؛ إنا معكما مقاتلون، ولذلك فقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أذلة، وقال لكم: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (الأنفال: 26)، وقال أيضاً: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (الأنفال: 29)؛ أي ينصركم نصراً عزيزاً، كما نصركم في بدر يوم الفرقان يوم الْتقى الجمعان.
(9) وأما المعلم التاسع من معالم التحرير المصاحبة للمعراج تلك الصلوات الخمس التي هي عمود الدين، ومَنْ هَدَمَها فقد هدم الدين، ولعل الله عز وجل أراد أن يدلنا على أهميتها في معركة أمة الإسراء مع أمة إسرائيل حينما أوحى بها مباشرة، وكلَّم بها نبيَّنا تكليماً، فلم تكن بواسطة جبريل عليه السلام، كما كان بقية التكاليف.
إن الصلاة قد شُرعت لِحِكَمٍ كثيرة، ومقاصدَ عظيمةٍ، تحرِّض المؤمنين على الجهاد بالأنفس والأموال، ومن ذلك:
(أ) إحياء ذكر الله في النفوس، وفي الكون، فقد خاطب ربنا تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه السلام بهذا فقال: {فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (طه: 14).
كما خاطب نبيَّنا محمداً عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من بعده بمثل ذلك؛ فقال سبحانه: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} (العنكبوت: 45).
فإن أحد تأويلات الجملة الأخيرة أن مقصد إحداث ذكر الله بالصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر.
ومن المعلوم أن أسباب النصر في الميدان ستة، كما نصت على ذلك سورة الأنفال، وكان الثاني منها ذكر الله كثيراً، وهاؤم اقرؤوا هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (الأنفال: 45).
(ب) النهي عن الفحشاء والمنكر: وقد نصَّت على ذلك آية العنكبوت التي سيقت آنفاً، والسرُّ في ذلك أن الذين يخرون للأذقان سجداً، ويزيدهم ذلك خشوعاً، يكونون قد قهروا النفسَ الأمَّارة بالسوء، ووقفوا على كثير من المعاني وهم يدعون ربهم رغباً ورهباً، أو خوفاً وطمعاً، يُستبعد معها أن يعودوا لما نُهُوا عنه؛ فضلاً عن الحياء من أعين الله البصير بما تعملون.
إن الشيطان هو الذي يأمر بالفحشاء والمنكر، وهو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
ومن المعلوم أن الذنوب أفتك بالجيوش من عدوِّهم، وأننا إذا تساوينا مع العدو في المعصية كانت الغلبة للقوة المادية، وأن الذين تولوا منكم يوم الْتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كما أن الشيطان يخوفكم بأوليائه، وهو الذي يعدكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء.
(جـ) الصلاة علاج لداء الهلع؛ فقد جاء في سورة المعارج: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . إِلَّا الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ} (19- 23).
إنه من المعلوم أن القتال يحتاج إلى المال كما يتوقف على الرجال؛ فإن الله ذا الجلال بعد أن أمر بالإعداد في سورة الانفال قال: {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (الآية: 60).
إن معظم الآيات الآمرة بالجهاد قد جمعت بين الأموال والأنفس؛ بل أغرى ربنا تبارك وتعالى من يقرض الله قرضاً حسناً أن يضاعفه له أضعافاً كثيرة، لاسيما من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، كما أن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون، ولن تنالوا البِرَّ حتى تنفقوا مما تحبون، وما أنفقتم من شيءٍ فهو يُخْلِفُه، وهو خير الرازقين.
إنه ليس من غرضي أن أستطرد في سرد مقاصد الصلاة، إنما الهدف أن نوقن أن لها دوراً في التعبئة بذكر الله، وفي التحصين من خطوات الشياطين، وفي الإغراء بالوفاء بشراءِ النفوس والأموال لله، وكل ذلك زادٌ للمجاهدين، فتكون هدية الله لعباده في ليلة المعراج مدشنةً بذلك معلماً من معالم التحرير.
(10) وأما المعلم العاشر فمستنبط من صلاة الأنبياء جميعاً خلف نبيِّنا عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى نفسه؛ فقد كان هذا تأكيداً أنه من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين؛ فقد أخذ الله ميثاق النبيين لَما آتيتكم من كتابٍ وحكمةٍ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري؟، قالوا: أقررنا، وقد وَفَّوا بذلك بتلكما الركعتين خلف خاتم النبيين.
لقد صار من الواجب علينا أن نظهر هذا الدين على الدين كلِّه، ولو كره المشركون، ولن يتحقق هذا إلا بالدعوة أولاً، سواء دخلوا في الإسلام، أو قَبِلُوا بعقد الذمة، وإلَّا فهم حربيون، ويجب قتالهم ثانياً؛ حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كلُّه لله، وقد ثبت عبر خمسةَ عشرَ قرناً أنه لا مفرَّ من القتال؛ ولولا ذلك لفسدت الأرض، وجُعِلَ أعزةُ أهلها من المؤمنين أذلة.
ولما كانت فلسطين هي الحاضنةَ للخلافة الخاتمة على منهاج النبوة، تلك التي ترث حقبة الحكم الجبري، عبر الملاحم الدائرة اليوم بين شعوب الأمة وبين الطغمة الحاكمة، ورموز الدولة العميقة أو العقيمة؛ فقد وجب علينا أن نُعَجِّل بتحريرها تزامناً مع دَوْسِ رؤوس الحكم الجبري؛ حتى تقومَ فيها الخلافة، ونغزو العالم بجيوش الدعاة والفاتحين؛ تحقيقاً لما استقرَّ عملياً ليلة الإسراء من حيازة هذه الأمة لميراث الأنبياء، وأن كلَّ الزاعمين اتِّباعَ غيرِ محمدٍ من النبيين، لو كانوا منصفين، ما وسعهم إلَّا الاقتداء بأنبيائهم في اليقين بانتساخ دينهم بهذا الدين، ولكنَّ أكثرهم لا يؤمنون.
وفي الختام تلك عشرة كاملة من معالم الجهاد والتحرير للمسرى والأقصى من العبر المستفادة من معجزتي الإسراء والمعراج، قد اكتفيت بها خشية الإطالة، ويمكن لكل مشهد أن يكون له سهم في تلك المعالم، وفيما ذكر بلاغٌ لقوم عابدين؛ لعل تناولنا لسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يتحول من السرد التاريخي القصصي، إلى التحليل الفكري السياسي المقاصدي الذي نتحسَّس به معالم النهوض والصعود من حضيض الأمية إلى الدرجة الرفيعة في الفهم والعلم، وفي الإعداد والجهاد، ولتكون تلك المعالم بمثابة الزاد الذي نتبلغ به في تطهير البلاد، وتحرير العباد من الأوغاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، وقد تأذن ربك لَيَصُبَّنَّ عليهم سَوْطَ عذاب، وإننا لنرجو أن نكون من جند الله الذين أساؤوا وجوه اليهود، ويوشك أن يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وأن يتبروا ما علاه بنو إسرائيل تتبيراً، وألَّا نضع راية الزحوف حتى نَبْلُغَ بهذا الدين ما بلغ الليلُ والنهار؛ إن الله على كل شيءٍ قدير، وبالإجابة جدير.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه