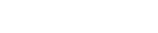خاص هيئة علماء فلسطين
29/10/2025
المفتي: لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
السؤال: ما حكم الوصية الواجبة؟
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالإجابة على هذا السؤال تتمثل في بيان جملة من الحقائق الشرعية، خلاصتها:
أولاً: أن قسمة المال بعد وفاة الميت أمرٌ تولاه الله بنفسه وأنزل فيه آيات محكمة لا يجوز لأحد مخالفتها؛ لا في تعيين الورثة ولا في بيان أنصبتهم؛ وقد قال سبحانه بعد أن بين تلك القسمة، {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مهين} وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني.
ثانياً: قسمة الميراث تُنَحَّى فيها العواطف جانباً ويُتَّبَع فيها شرع الله؛ ولذلك قال ربنا جل جلاله بعدما بيَّن قسمة الميراث {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له، فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأنا العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبَّرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه. اهـ.
وقال السعدي: فلو رُدَّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما اللهُ به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم، وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. اهـ.
ثالثاً: الشريعة المطهرة تأمر بإعطاء القريب غير الوارث – كأولاد البنت وبنات الإخوة والعمات وغيرهم من ذوي الأرحام أو الفقراء والمساكين والقسمة له – من التركة قبل قسمتها، فقد قال الله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} على سبيل الوجوب – كما هو قول بعضهم – أو على سبيل الاستحباب؛ قال القرطبي رحمه الله: والصحيح أن هذا على الندب، لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث… انتهى.
قال السعدي رحمه الله تعالى: وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، فقال (وإذا حضر القسمة) أي: قسمة المواريث (أولو القربى) أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله (القسمة) لأن الوارثين من المقسوم عليهم. (واليتامى والمساكين) أي: المستحقون من الفقراء. (فارزقوهم منه) أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب، ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه، وقلوبهم متطلعة فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم، ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين) أو كما قال.. وكان الصحابة رضي الله عنهم -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرّك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علماً منه بشدة تشوفه لذلك، وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك -لكونه حق سفهاء أو ثم أهمُّ من ذلك- فليقولوا لهم (قولاً معروفاً) يردوهم رداً جميلاً بقول حسن غير فاحش ولا قبيح… انتهى.
رابعاً: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوصية أواجبة هي أم مستحبة؟ فجمهورهم – ومنهم الأئمة الاربعة – على استحبابها، اللهم إلا إذا تعلق بذمة الإنسان حق لله كزكاة، أو حج، أو كفارة، أو حق للعباد في دين أو وديعة أو غير ذلك، فتجب الوصية حينئذ كوسيلة للخروج من الحق الواجب. بل نقل بعضهم – كابن عبد البر – الإجماع على ذلك؛ فقال رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة، إلا على من عليه حقوق بغير بيِّنة، وأمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذت فأوجبتها.
وذهب جماعة من السلف كعطاء والزهري وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس إلى وجوب الوصية على من ترك مالاً، وبهذا قال ابن حزم أيضاً.
خامساً: هذه الأمة المرحومة معصومة من أن تجتمع على ضلالة؛ من تضييع حق أو تفويت مصلحة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وصححه الألباني.
وقد توالت أجيال الأمة قرناً بعد قرن، من لدن الصحابة رضي الله عنهم فمن جاء بعدهم، وفيهم من الأئمة المهديين والعلماء العاملين الجمُّ الغفير، ومع ذلك لم يوجب أحدٌ من علماء الإسلام على مرِّ العصور طريقة معينة لازمة في الوصية وقسمتها، كهذا الذي حصل في عصرنا من سنِّ قانون الوصية الواجبة، ولا تصح نسبة هذا القانون لابن حزم الظاهري ولا غيره؛ فإن القائلين بوجوب الوصية من أهل العلم لم يفرِّقوا بين الأقارب غير الوارثين، ولم يخصوا الأحفاد دون الأجداد، أو الأعمام، أو الأخوال، أو غيرهم. ثم إن أحدا ًمنهم لم يعيِّن لذلك قدراً معلومًا.
سادساً: حاصل ما عليه هذا القانون – المعمول به في بعض الدول – أن الوصية تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلت طبقاتهم، وصية بمثل ما كان يستحقه أبوهم ميراثاً في تركة أبيه لو كان حياً عند موت الجد، في حدود الثلث، بشرط أن يكون الحفيد غير وارث، وألا يكون الجدُّ الميّت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له
ومن وضعوا هذا القانون استندوا إلى قول أولئك الموجبين للوصية، وإلى قول ابن حزم رحمه الله تعالى، مع أن أولئك السلف ما قَصَروا الوصية على الأحفاد، ولم يقدِّروها كذلك بنصيب لو كان حياً؛ كما فعل واضعو هذا القانون؛ فالحق أنه لا سلف لهم في ذلك.
سابعاً: ثمة تناقضات تتنزه عنها الشريعة المطهرة عند تطبيق قانون الوصية الواجبة، وهي دليل على نقص البشر، وتصديق لقوله تعالى {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} ومن ذلك:
1/ أنه قد يوجد من الأقارب غير الوارثين من لا يقل حاجة عن الأحفاد، وهؤلاء لم يعتبرهم القانون المذكور. ومن ذلك – مثلا – ما لو مات الرجل عن أم وإخوة لأم، وأم لأب، فإن الجدة أم الأب في هذا المثال محجوبة بالأم، وقد تكون، محرومة لا عائل لها.
2/ أن هذا القانون يترتب على تطبيقه وجود حالات شاذة لا يمكن قبولها، ومن ذلك:
أ- أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت الابن، فلو مات شخص عن بنت، وبنت بنت، وبنت ابن، وترك 30 فداناً – مثلاً – فإن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت هنا هو ثلث التركة وهو 10 أفدنة نصيب أمها لو كانت حية. وتأخذ البنت وبنت الابن الباقي فرضاً وردّاً بنسبة 1:3، فيكون نصيب بنت الابن خمسة أفدنة أي نصف ما أخذت بنت البنت.
ب – أن تأخذ بنت الابن أكثر من البنت، وذلك فيما إذا مات شخص عن بنتين، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وترك 18 فداناً – مثلا – فإن مقدار الوصية لبنت الابن ثلث التركة وهو 6 أفدنة، أما الباقي فيقسم بين البنتين والأخت الشقيقة، فتأخذ البنتان الثلثين 8 أفدنة، لكل منهما 4 أفدنة، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 4 أفدنة.
ج – أن هذه الوصية – بحكم هذا القانون – قد أخذت سبيل الميراث المفروض؛ وهو ما أقر به بعض مؤيدي هذا القانون، ومنهم الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى حيث قال في كتابه (شرح قانون الوصية): هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة … وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله، على ألا يتجاوز الثلث، وإذا كان هذا غاية القانون فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً، ولذا تجب من غير إيجاب، وإذا وجبت صارت لازمة لا تقبل عدم التنفيذ، وبذلك تشابهت مع الميراث. اهـ.
وكذلك الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى حيث قال في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: وبما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي والقبول من الموصَى له، فهي أشبه بالميراث، فيسلك فيها مسلك الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحجب الأصل فرعه، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. اهـ.
ويدل على صحة ذلك الذي قاله الشيخان الجليلان رحمهما الله تعالى عدة أمثلة:
1/ أن الجد لو أوصى بالفعل لأحفاده، ولكن بأقل مما يوجبه هذا القانون، فإنهم يوجبون بحكم القانون إكمال مقدار الوصية الواجبة، وهذا باطل بلا مرية!!
2/ أن قانون الوصية الواجبة لا يفرِّق بين المحتاج وغيره من الأحفاد، فلو افترضنا أن رجلاً عنده ثلاثة أبناء، أحدهم في غاية الثراء والآخران في غاية الفقر، فمات هذا الثري في حياة أبيه، فستنتقل ثروته لابنه ولا يرث أعمام هذا الابن من أخيهم شيئا، فإذا مات الجد بعد ذلك فالشرع والعقل ومراعاة الحال يقتضي انتقال ثروة الجد لأبنائه المباشرين ولا يرث حفيده هذا شيئا، ولكن بمقتضى قانون الوصية الواجبة سيشارك هذا الحفيد الثري أعمامه الفقراء ويأخذ مثل نصيبهم. فهل مثل هذا يُقبل في الشرع أو في العقل؟؟!!
وعليه فإن الواجب الرجوع إلى شرع الله تعالى في تدارك هذا الخلل، وذلك بالاقتصار على إعطاء الأعمام أولاد أخيهم المتوفى شيئاً من تلك التركة؛ يقول الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى: هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف، وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً} إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة والأموال توزع وهم ينظرون ولا يعطون شيئًا؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة. وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى. ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام. إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي. وذلك مثل ابن الأخ. ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل. إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة، وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى … هذا لا يجوز في شرع الإسلام. بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز. اهـ.