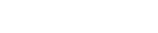د. حاكم المطيري
صحيفة الوطن، بتاريخ 5/3/1995م

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد …
فقد كان لفتوى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه في شأن الصلح مع اليهود صدى بالغ وأثر واضح؛ حيث ورد الناس عليها وأصدروا، وقد اختلفت فيها آراؤهم واضطربت في إدراكها فهومهم؛ فطائفة: طارت بها فرحا واحتجت بها على مشروعية معاهدات الصلح العربية الإسرائيلية بصورتها المطروحة، لا كما يتصورها صاحب الفتوى، وأخذت تصف كل رافض لهذه المعاهدات بأقذع وصف وأقبحه؛ كما عبر عن ذلك بعض الكتاب!
وطائفة أخرى: وجدت في هذه الفتوى السبيل للطعن في صاحب الفتوى ولمزه؛ بل والطعن في جميع الحركات الإسلامية ووصفها وأتباعها بالنفاق… إلخ؛ وقد عبّر عن هذه الطائفة وموقفها أحمد البغدادي في (الفتوى التي تجاوزها الزمن).
وطائفة ثالثة: تثبتوا ورجعوا إلى المصدر الذي استقت عنه وكالات الأنباء الخبر؛ فوجدوا أن الفتوى تم استغلالها إعلاميا بعد بترها وتحريفها، ولما كان من المناسب عرضها على الكتاب والسنة وأقوال فقهاء الإسلام لمعرفة وجه الحق وحكم الشرع في الموضوع؛ وجب تقديم بعض القواعد المهمة؛ ومنها:
أولا: ما كل من أستدل صح دليله، وما كل من صح دليله صح استدلاله، وما كل من صح استدلاله صح تنزيله الحكم على الواقعة وسلم له في توافر الشروط الموجبة وارتفاع الأسباب المانعة؛ وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه بين أهل العلم والإيمان.
وثانيا: الحكم على الأشياء فرع من تصورها؛ وإنما يقع الخلل في الحكم عليها؛ ممن تجرد للحق بسبب أمرين:
الأول: قصور في إدراك النصوص والقواعد.
والثاني: قصور في تصور الحوادث والوقائع.
وكل إنسان عرضة لدخول أحد هذين السببين عليه عند إصداره الحكم على الأشياء؛ ومن هنا كان إجماع أهل العلم والإيمان حجة قاطعة دون اختلافهم؛ لزوال ما يخشى على العقل الإجماعي من قصور في الإحاطة بالنصوص والقواعد أو القصور في تصور الحوادث والوقائع عند صدور الحكم فيها عنه، وهذا بخلاف حالهم عند اختلافهم؛ إذ كل واحد منهم عرضه لذلك؛ ومع ذلك أيضا لا يسع الخروج عن مجموع أقوالهم عند اختلافهم في فهم النصوص؛ إذ الحق لا يخرج عن مجموعهم في ذلك لقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}، وقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}، وللحديث: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) .
ثالثا: هذا وإن ما أجمع عليه أهل الإسلام وما اتفق فيه أهل العلم والإيمان من أصول الإسلام وشرائعه أكثر مما اختلفوا فيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان ص 341: (وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا).
وقال العلامة عبد الرحمن السعدي في المختارات ص 182: (علم الفقه وهو نوعان: نوع مجمع عليه وهو جمهور علم الفقه ولله الحمد، ونوع وقع فيه الخلاف بين أهل العلم لاختلاف مآخذهم وتباين استنباطاتهم).
وفيما ذكره هذان الإمامان أبلغ الرد على من جعلوا من اختلاف الفقهاء فيما اختلفوا فيه حجة لهم في إعراضهم عن نصوص الشرع؛ بدعوى أن لهم في كل قضية قولين، وأن اختلافهم أكثر من اتفاقهم!
ولعل في نقل أقوال فقهاء الإسلام في هذه القضية التي نحن بصدد دراستها أصدق شاهد على صحة ما ذكره هذان الفقيهان من أن ما اتفق عليه أهل الإسلام من أمور شريعتهم هو أضعاف أضعاف ما اختلفوا فيه هذا مع أن ما اختلفوا فيه يجب بإجماعهم رده إلى القرآن والسنة ويكون أحقهم بالاتباع أظهرهم دليلا وأقواهم حجة وأقربهم مأخذا.
وهذا أوان الشروع في ذكر أقوالهم؛ ومن المناسب تقديم تعريف عقد الهدنة اصطلاحا.
تعريف عقد الهدنة: هو عقد إمام أو نائبه على ترك قتال أهل الحرب مدة؛ ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة.
كذا عرفه في حاشيته المقنع من كتب الحنبلية 1/520 وفيه أيضا ص :522 (الهدنة التزام الكف عنهم فقط) ونحوه في المغنى لابن قدامه الحنبلي 9/238.
وقال الموصلي الحنفي في الاختيار 4/120: (الموادعة طلب الأمان وترك القتال).
وكذا قال الماوردي الشافعي في الحاوي 14/296 والدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير 2/206.
وعامة تعريفات الفقهاء دائرة في هذا المعنى؛ فلا خلاف بينهم على أن معنى الهدنة والمصالحة والموادعة: التزام وقف القتال وتحقيق الأمان للطرفين مدة الصلح.
حكم هذا العقد: ولا خلاف بين عامة الفقهاء على مشروعية عقد الصلح مع أهل الحرب؛ قال الإمام الشافعي في الأم 8/386: (إن نزلت بالمسلمين نازلة بقوة عدو عليهم هادنهم الإمام)، وقال ابن المنذر في الإقناع 2/498: (للإمام أن يصالح أهل الشرك)، وكذا قال ابن قدامة في المغني والمقنع، والموصلي في الاختيار، والدسوقي في حاشيته، والدردير في الشرح الكبير؛ كما في المصادر السابقة، وكذا في حدائق الازهار مع السيل الجرار 4/564 في فقه الشيعة الزيدية… إلخ.
ودليلهم من القرآن قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} ومن السنة معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار من المشركين وأهل الكتاب؛ وهي متواترة.
شروط صحة عقد الصلح: ولا خلاف بينهم على أن عقد الصلح يجب أن تتوافر له شروط؛ كي يكون صحيحا نافذا ومن هذه الشروط:
1- أن يحقق ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين؛ فلا خلاف بينهم على أن عقد الصلح مبني على ما فيه مصلحة أهل الإسلام، قال الإمام الشافعي في الأم: (هادنهم الإمام على النظر للمسلمين). وكذا قال ابن المنذر في الإقناع وقال الموصلي في الاختيار: (والمعتبر في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين؛ فيجوز عند وجود المصلحة دون عدمها). وقال ابن قدامه في المغني: (أو لا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين)، وكذا في الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه؛ وفي حدائق الازهار في فقه الزيدية: (وللإمام عقد الصلح لمصلحة).
والمعتبر في المصلحة المنوط بها الحكم وجودا وعدما أن تكون:
أ- مشروعة: فلا عبرة بالمصلحة الممنوعة شرعا، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص 124: (إذا كان فعل الإمام مبنيا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه فان خالفه لم ينفذ)، للحديث (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
ب- عامة: فلا عبرة بالمصلحة الخاصة بطائفة من الناس؛ بل يشترط فيها أن تكون في صالح الإسلام والمسلمين على وجه العموم.
ج- حقيقية: فلا عبرة بالمصلحة المتوهمة.
والقاعدة المقررة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83: (أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).
والمصلحة المرادة في هذه القاعدة: هي المشروعة الحقيقية العامة فيما كان من أمور العامة.
واشترط أكثر الفقهاء في عقد الصلح أن يكون مؤقتا بمدة معلومة؛ ففي المغني: (لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة) وفيه أيضا: (ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة) وقال ابن المنذر في الإقناع: (ولا يجوز أن يصالحهم إلى غير مدة) وفي حدائق الأزهار في مذهب الزيدية: (مدة معلومة) وقدرها أكثرهم بعشر سنين؛ قال ابن حجر في الفتح 5/430: (وهو قول الشافعي والجمهور)؛ فإن تجاوزت المدة العشر؛ بطلت فيما زاد عليها، كما نص عليها القاضي الماوردي في الأحكام السلطانية ص 106 ، وفي المقنع في رواية عن الإمام أحمد: (فإن زاد على عشر بطل في الزيادة)؛ ودليلهم في ذلك مدة عقد صلح الحديبية وهو أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه وسلم قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 1/93 موضحا مأخذهم: (ولا يجوز الزيادة عليها لأن الكفر أنكر المنكرات، فلا يجوز التقرير عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة).
فخصصت السنة عموم آيات السيف والقتال، فما زاد عن العشر يبقى على عمومه؛ كما قال ابن قدامة في المغني 9/238 وذهب بعض الفقهاء إلى جواز إطلاق العقد وعدم تقييده بمدة محدودة؛ بل بحسب ما تقضي به المصلحة، إلا إنه لا خلاف بينهم على بطلانه إذا كان الصلح مؤبدا، أما من اشترط مدة معلومة فظاهر إذ اشتراطهم التأقيت ينافي التأبيد، قال البهوتي في شرح منتهى الارادات 2/126: (وإن أطلقت الهدنة أو المدة لم تصلح… لاقتضائها التأبيد) وقال الدسوقي في حاشيته: (شرطها أن تكون في مدة بعينها لا على التأبيد ولا على الإبهام ثم تلك المدة لا حد لها؛ بل يعينها الإمام باجتهاده).
وأما من أجاز إطلاق المدة وعدم تقييدها؛ فلأن المعتبر عنده المصلحة؛ كما نص عليه الموصلي في الاختيار وكذا السرخسي في المبسوط 10/86، وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير 5/456: (وما أبيح -أي: الصلح- إلا باعتبار أنه جهاد وذلك إنما يتحقق إذا كان خير للمسلمين وإلا فهو ترك للمأمورية به) وقال الكاساني في البدائع 9/4329: (عقد الموادعة: عقد غير لازم).
كما أن العقد عندهم غير لازم ينافي التأبيد؛ ومن هنا يظهر الفرق جليا بين الإطلاق الذي أجازه بعض الفقهاء؛ وبين التأبيد الذي أبطله عامة الفقهاء.
هذا ولا خلاف بينهم على إن العلة المانعة من تأبيد العقد ومنع كونه على سبيل الدوام والاستمرار: هو كون التأبيد معطلا لفريضة الجهاد؛ قال ابن المنذر في الإقناع: (ولا يجوز أن يصالحهم إلى غير مدة؛ لأن في ذلك ترك قتال المشركين وذلك غير جائز). وقال ابن قدامة في المغني: (ولا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة؛ لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية)، وقال البهوتي في كشاف القناع 3/111: (ولا تصلح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد لمصلحة) وقال الشوكاني في السيل الجرار: (وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقا أو مؤبدا لكان ذلك مبطلا للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام؛ فلابد أن يكون مدة معلومة على ما يرى الإمام من الصلاح).
وكذا هي العلة عند من أجاز الإطلاق ومنع التأبيد، قال الموصلي الحنفي في الاختيار: (وإذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب؛ لأنه لا مصلحة في ذلك لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى أو تأخيره).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع 9/4324: (وشرطها أي المعاهدة الضرورة… فلا تجوز عند عدم الضرورة؛ لأن الموادعة ترك القتال المفروض؛ فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال لأنها حينئذ تكون قتالا معنى).
وكذا علله في فتح القدير وشرحه 5/456، ففرض الجهاد مما علم من الدين بالضرورة؛ فالتزام تركه ممنوع شرعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 28/503: (فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات… أو عن التزام جهاد الكفار… وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها؛ وإن كانت مقرة بها؛ وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء).
2- ومن الشروط التي اشترطها عامة الفقهاء: خلو العقد من شرط فاسد، ولا خلاف بينهم على بطلان الشرط الفاسد، واختلفوا في بطلان العقد إذا تضمن شرطا فاسدا بعد اتفاقهم على بطلان الشرط، والأكثر على بطلان العقد.
قال الإمام الشافعي في الأم: (وإن صالحهم الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه)، وقال النووي في روضة الطالبين 7/520 في شروط صحة عقد الهدنة: (الثالث أن يخلو عن الشروط الفاسدة)، وقال أيضا: (إذا جرى في المهادنة شرط فاسد؛ فسد به العقد على الصحيح)، وقال ابن قدامة في المغني: (وإن شرط شرطا فاسدا؛ بطل الشرط في العقد، وفي بطلان العقد وجهان)، وكذا قال الدردير في الشرح الكبير 2/206، وقال الدسوقي في حاشيته: (المهادنة لا تجوز إلا بشروط… الثالث: أن يخلو عقدها عن شرط فاسد).
ولا خلاف بينهم أيضا على أن من الشروط الفاسدة التي يجب نقضها: اشتراط بذل شيء للكفار مقابل عقد الصلح، قال الإمام الشافعي: (ولا يجوز أن يهادنهم على أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال؛ لأن القتل للمسلمين شهادة وإن الإسلام أعز من يعطي مشركا على أن يكف عن أهله قاتلين ومقتولين ظاهرين على الحق)، وقال النووي في الروضة في أنواع الشروط الفاسدة: (وكذا لو عقد بشرط التزام مال) وقال ابن قدامة في المغني 9/242 في الشروط الفاسدة: (أو يشترط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله)، وكذا هو من الشروط الفاسدة عند المالكية، وكما عند الحنفية؛ لما فيه من الذل والصغار كما في الاختيار للموصلي… وإنما استثنى الفقهاء حالة واحدة وهي: خوف الاصطلام وهلاك أهل الإسلام بالإحاطة بهم من كل جانب؛ دفعا للضرورة، قال الإمام الشافعي في الأم: (إلا في حال يخافون الاصطلام… لأن هذا موضع ضرورة) وقال النووي في الروضة: (أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطلام؛ فيجوز بذل المال ودفع أعظم الضررين بأخفهما).
وقال الموصلي في الاختيار: (وإن دفع إليهم مالا ليوادعوه؛ جاز عند الضرورة وهو خوف الهلاك).
وفي الروض المربع 4/300: (ولو بمال منا ضرورة).
وكذا قال المالكية كما في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي وفي الخرشي على مختصر خليل: (وإلا لم يجز كشرط بقاء مسلم أسير بأيديهم أو بقاء قرية للمسلمين خالية منهم أو أن يحكموا بين مسلم وكافر أو أن يأخذوا منا مالا).
والنصوص التي استمد منها الفقهاء هذه الشروط كثيرة، منها: قول الله تعالى: {إلا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين}.
وقوله تعالى: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل).
انتهاء عقد الهدنة:
وأجمع أهل العلم على وجوب الوفاء بالعهود بين المسلمين وأهل الحرب وتحريم الغدر والخيانة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وإنما يكون أهل الإسلام في حل من هذا العقد؛ إذا توافرت شروطه وكان صحيحا في حالات:
1- انتهاء مدة العقد؛ لقوله تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم}.
2- نقض أهل الحرب لشرط من شروط العقد؛ لمفهوم قوله تعالى: {ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم}، وقوله تعالى: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}.
3- الخوف من الخيانة إذا قامت القرائن؛ لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين}.
وأما إن وقع العقد باطلا؛ فأهل الإسلام في حل منه ومن التزام شروطه إلا أن من دخل من أهل الحرب دار الإسلام معتقدا الأمان؛ فإنه يكون آمنا، ويرد إلى دار الحرب ولا يبقى؛ لبطلان العقد؛ كما في كشاف القناع 3/114، وتكون صورة العقد شبهة تمنع من الاعتداء عليه حتى يبلغ مأمنه؛ هذا وليس للمسلمين أن يمدوا أهل الحرب بما يستعينون به على قتال أهل الإسلام من مقومات القوة في أثناء الهدنة، قال الكاساني في البدائع 9/4310: (ليس للتاجر أن يحمل إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب من الأسلحة… وكل ما يستعان به في الحرب المسلمين قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} فلا يمكن من الحمل إليهم (وكذا الحربي إذا دخل دار الإسلام ولا يمكن أن يشتري السلاح).
وبعد هذا التفصيل نوجز ما سبق ذكره بما يلي:
1- عقد الصلح في الفقه الإسلامي :عقد على وقف القتال وكف الاعتداء وتحقيق الأمان للطرفين.
2- وهو قائم على مراعاة ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
3- وله مدة ينقضي فيها أجل هذا العقد مؤقتة أو مطلقة؛ فليس هو على سبيل الدوام والتأبيد؛ إذ في تأبيده تعطيل لشريعة الجهاد وهو ممنوع بالإجماع.
وقد يكون الصلح دائما على معنى أنه ما التزم الطرف الآخر فالصلح قائم، وهذا عقد مطلق غير مؤقت وغير مؤبد.
4- ويشترط فيه: خلّوه من الشروط الفاسدة، ومنها: بذل شيء للأعداء إلا في حال الاضطرار وهو أن يحاط بأهل الإسلام من كل جانب.
5- وتنتهي مدة هذا العقد إذا كان صحيحا بانتهاء المدة أو عند الخوف من الخيانة؛ فينبذ إليهم على سواء أو عند مظاهرتهم على المسلمين وإخلالهم بالاتفاق.
6- فإن وقع العقد باطلا؛ لفقد شرط من شروط صحته؛ فالواجب نقضه وإعلام الطرف الآخر بذلك وأهل الإسلام في حل من التزام شروطه إلا إن له بعض الآثار مع كونه عقدا باطلا؛ لوجود صورة العقد وهي شبهة تمنع من الاعتداء على من دخل من أفراد الطرف الآخر معتقدا الأمان.
فهذه هي صورة عقد الصلح في الفقه الإسلامي، وهذه أهم شروطه، لا نكاد نجد فيه بين الفقهاء كبير خلاف؛ فهل تنطبق صورة هذا العقد على عقد الصلح القائم بين العرب وإسرائيل؟
تخلى بعض المسلمين عن أرض فلسطين لا يسقط حق الآخرين:
لا شك في جواز عقد الصلح مع إسرائيل من حيث المبدأ؛ لكف القتال ومنع الاعتداء وتحقيق الأمان بين الطرفين، كما هو قول عامة الفقهاء، كما لا خلاف على أن العقد إنما يلزم دول وشعوب من وقعوا الاتفاق دون سائر المسلمين؛ إذ لا يلزم أهل الإسلام عامة إلا ما عقده إمام العامة وهو الخليفة حال وجود الخلافة وهذا أيضا متفق عليه بين عامة الفقهاء.
إلا أن هذا العقد -مع كونه فاقدا لركن العقد الأساسي وهو الرضا؛ إذ يتم توقيعه من قبل القيادة الفلسطينية خاصة تحت ضغوط من الإكراه المادي والمعنوي من قبل أطراف عديدة استمرت لسنوات طويلة حتى رضخت لسياسة الأقوى وفرض الأمر الواقع- مع ذلك فقد تضمن هذا العقد شروطا تخرجه عن كونه عقد هدنة ومعاهدة صلح بمفهوم الفقه الإسلامي؛ وذلك من وجوه هي:
1- أنه عقد دائم شامل؛ فقد جاء في نص إعلان المبادئ في المعاهدة الفلسطينية الإسرائيلية: (تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة) ونحوه في المعاهدة الأردنية؛ إذ فيها: (تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط).
ولا شك إن هذا المبدأ باطل شرعا بلا خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية؛ إذ فيه تعطيل لشريعة وفريضة الجهاد المعلومة من الدين بالضرورة القطعية، ففي إقرار هذا المبدأ مع أهل الحرب الذين يغتصبون أرض فلسطين والرضا به؛ مصادمة للنصوص القطعية.
2- اشترط عقد الصلح انتهاء العداء وزوال العداوة؛ فقد جاء في ديباجة المعاهدة الأردنية: (تأخذان بعين الاعتبار أنهما أعلنتا انتهاء حال العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن) وفيه أيضا: (متخطين بذلك الحواجز النفسية)!
وجاء في ملاحق المعاهدة الفلسطينية 4/3 ما نصه: (يتفق الطرفان على وقف حملات العداء لليهود… وكذلك حملات العداء للصهيونية العالمية) ولا خلاف بين فقهاء الإسلام على بطلان مثل هذه الشروط؛ إذ فيها مصادمة للعقيدة الإسلامية ونصوص الكتاب والسنة القطعية؛ كما قال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم}!
وقوه تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} وكما في الآية الكريمة: {وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}.
ويتأكد ذلك أكثر مع أهل الحرب منهم؛ كما في قوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}.
ولا يتنافى ذلك مع أمر الله به المؤمنين من الإحسان والرحمة والعدل والصدق والوفاء بالعهود مع غير المسلمين كما قال تعالى: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}، وقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.
وقوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} وقوله تعالى: {وقولوا للناس حسنا}.
فهذا باب وذلك باب آخر، والخلط بينهما ظاهر شائع بسبب الأمية الشرعية مع أنها من أصول الإسلام ومبانيه العظام، وكان الأنسب تعديل مثل هذه الشروط لتتلاءم مع أصول الاعتقاد عند أهل الإسلام كأن يقال: (وقف حملات الاعتداء) وهذا أيضا أقرب للتطبيق وأكثر واقعية من اشتراط إزالة الحواجز النفسية وإزالة أسباب العداوة مع أن أحد الأطراف رضخ لبنود الاتفاق تحت ضغوط الإكراه، والعقود يشترط فيها وضوح شروطها والقدرة على تطبيقها وإلا خرجت عن كونها عقودا تترتب عليها آثارها إلى رسائل أدبية لا اتفاقات قانونية!
3- وقد تجاوزت هذه الشروط أبعد من ذلك حيث جاء في المادة 11/1 من المعاهدة الأردنية: (إلغاء كل ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة)(وأن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كل المطبوعات الحكومية) وتجاوز إلى (اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد) ولا يخفى ما في ذلك من مصادمة لنصوص القرآن والسنة وكيف سيتعامل الطرف المسلم مع آيات القرآن مثل قوله تعالى: {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا}، وقوله تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم}.
وكيف سيتعامل الطرف اليهودي مع هذه الشروط -مع بطلانها شرعا بلا خلاف؛ لما فيها من طمس لمعالم الهوية الإسلامية-؟
وبهذا ونحوه يظهر مدى غلبة الأسلوب الأدبي على صياغة بنود هذه المعاهدة حتى خرجت عن كونها اتفاقية قانونية ستترتب عليها آثار ملزمة للطرفين أمام القانون والمحاكم الدولية في المستقبل.
نقلاً عن موقع د. حاكم المطيري:
http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=TlRNMEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp