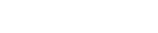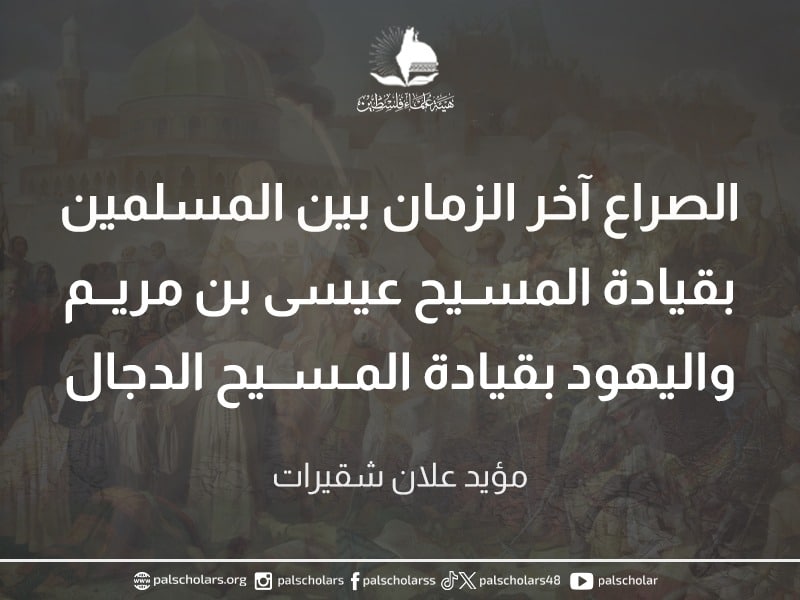2/11/2025
د. عمر الجيوسي – تقرير خاص نقلاً عن موقع الجزيرة https://aja.ws/8mpfaz
مقدمة: غزة بين الوصاية والسيادة
بعد وقف إطلاق النار في غزة، يسعى الفلسطينيون لإدارتها بإدارة وطنية فلسطينية توافقية. وتسعى جهات دولية لفرض إدارة أجنبية انتقالية عليها، وتم التخطيط لعدة سيناريوهات ومقترحات خارجية، منها:
• ( إدارة مدنية دولية) : وهو اقتراح تبلور في أروقة الأمم المتحدة والبيت الأبيض يقضي بإرسال إدارة مدنية أجنبية لتسيير شؤون القطاع، مثل مقترح “اللجنة الدولية لإدارة غزة” (GITA) لإدارة مدنية انتقالية تحت إشراف دولي مباشر يرأسها توني بلير.
• ( حزام غزة الإنساني ) : وهو تصور نقلته بي بي سي عربي عن رويترز (23 أكتوبر 2025)، يضم مراكز خدمية وقواعد للقوات الدولية لتثبيت الاستقرار ونزع السلاح.
•( غزّتان) : وهو ما نقله الخبير الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين عن مشروع يقسم القطاع إلى جزء مزدهر يخضع لإشراف دولي وآخر مدمر تحت حكم حماس، في محاولة يائسة لإضعاف الحركة عبر “الهندسة الاجتماعية”.
وأما على الصعيد الفلسطيني فقد اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة (أكتوبر 2025) على تشكيل لجنة وطنية مؤقتة من المستقلين لإدارة القطاع. وأكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحيّة لقناة الجزيرة (26 أكتوبر 2025) « أن حركة حماس ستُسلم مقاليد الإدارة بما فيها الأمن للجنة وطنية توافقية، مع الحفاظ على وحدة القرار الوطني »
هذه السيناريوهات تثير تساؤلات حول مدى ديمومة التوازن بين السيادة الفلسطينية والاحتياجات الإنسانية والأمنية، وهو ما يدفعنا لمقاربة ومقارنة وفحص هذه السيناريوهات وإسقاط هذه تجارب الإدارات الأجنبية السابقة في [ كوسوفو، تيمور الشرقية، العراق، البوسنة والهرسك، وكذلك نموذج السلطة الفلسطينية ]على تجربة غزة بعد توقف الحرب .
كوسوفو: الدولة الوليدة تحت الوصاية الدولية
عقب حرب استقلال كوسوفو عن صربيا عام 1999، تولت الأمم المتحدة عبر بعثة ( بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو : UNMIK ) إدارة الإقليم، ووصف الأمين العام آنذاك، كوفي عنان، التجربة بأنها “نموذج لبناء السلام من الصفر”. لكن التجربة أظهرت أن فرض السلام من الخارج جعل الدولة رهينة للجهات المانحة، ولم تتمكن كوسوفو من بناء جيش أو مؤسسات مستقلة فعليًا. وهو ما أراده الصرب ، ورغم تعهد الرئيس الصربي الأسبق بوريس تاديتش بعدم اللجوء للقوة لمنع هذا الاستقلال، إلا أنه قال: “لا يمكن اعتبار كوسوفو دولة ذات سيادة ونرفض الاعتراف باستقلالها”. ولا زالت كوسوفو في صراع مفتوح ، ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو رسميا جزءا من أراضيها .
تيمور الشرقية: بين الاستقلال والتبعية
في عام 1999، خضعت تيمور الشرقية لإدارة الأمم المتحدة بعد عقود من (الاحتلال ) الإندونيسي، وأصبحت دولة مستقلة رسميًا.
لكن المتنفذّين في تيمور الشرقية قد أسسوا على علاقات اقتصادية وإدارية غير مؤسسية مع الجهات الدولية؛ فطغى على بلدهم عدم الاستقرار السياسي وغياب الإصلاحات، وقد صف الزعيم الثوري السابق خوسيه راموس هورتا، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، تجربة بلده ـ تيمور الشرقية ـ بأنها (خلفّت نخبة مرتبطة بالمانحين وانقطع المجتمع عن جذوره ) .
العراق: تشويه الدولة عبر الإدارة الانتقالية
بعد غزو العراق عام 2003، تولّت السلطة الائتلافية المؤقتة التي خضعت لقيادة الإدارة الأمريكية إدارة شؤون البلاد. وتحت إشراف وزارة الدفاع الأمريكية، تم تشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي الوكالة المدنية المكلفة بإعادة إعمار العراق بعد الحرب، برئاسة بول بريمر، الذي كان المهندس للمحاصصة الطائفية وواضع أسس الفساد وإشاعة الفوضى وتحطيم مؤسسات الدولة.
في 23 مايو 2003، أصدرت السلطة الأمر رقم 2 “حلّ الكيانات”، الذي قضى بحلّ وزارة الدفاع العراقية، والجيش، والقوات الجوية والبحرية، وغيرها من المؤسسات الأمنية والعسكرية (السلطة الائتلافية المؤقتة، الأمر رقم(2).
هذا القرار ترك مئات الآلاف من الجنود والموظفين الحكوميين بلا عمل أو راتب، ما خلق فجوة اقتصادية واجتماعية وأمنية، وساهم في تصاعد الهجمات المسلحة ضد قوات الاحتلال، كما أشار تقرير (منظمة هيومن رايتس ووتش 2006) إلى أن تفكيك المؤسسات الأمنية ترك آلاف العراقيين بلا دخل، مما فاقم حالة الفوضى.
الوثائق الرسمية والتقارير الدولية توضح أن هذه السياسات لم تكن مجرد أخطاء إدارية، بل خطوات مدروسة من الإدارة الأمريكية لإضعاف الدولة العراقية بشكل مباشر. فالتجربة العراقية بعد 2003 تُظهر بوضوح أن الإدارة الأمريكية تتحمّل مسؤولية مباشرة في تفكيك مؤسسات الدولة، وتشكل تحذيرًا لأي تدخل أجنبي يمارس تفكيكًا منظّمًا لمؤسسات دولة دون بناء بديل متماسك.
السلطة الفلسطينية: بين فكّي الاحتلال والوصاية
منذ اتفاق أوسلو، يجمع نموذج السلطة الفلسطينية بين حكم ذاتي وإشراف أجنبي مكثف، حيث أشرف الجنرال الأمريكي كيث دايتون على تدريب الأجهزة الأمنية. وجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام خطة أمنية أميركية خطة أمنية تتم فيها مقايضة الأمن بالاقتصاد وبعد ثلاثين عاما وجد الفلسطينيون أن الاتفاقيات تغرق السلطة بطلبات تعجيزية، وتسحب منها التمويل والتمثيل والثروات والقدرة على الحركة.ولأسباب من داخل السلطة التي لم تجب على أسئلة الذات وكذلك لم تضع الأسئلة المرحلية والاستراتيجية الصحيحة وخصوصا في هذا المرحلة وابتعادها عن مواطنها ؛ فإن “87% من سكان الضفة غير راضين عن أداء السلطة ويعتبرونها امتدادًا لإدارة أمنية تخدم الاحتلال” كما أشار تقرير مركز الأبحاث الفلسطيني (2023) .
نموذج السلطة والنماذج السابقة يشكلون تحذيرا كبيرا للتجربة الانتقالية في غزة كي لا تكرر تجارب الإدارات الأجنبية؛ فأضرار وكوارث التبعية تنمو طرديًا مع أي توسيع لدور المانحين في تحديد ميزانية القطاع أو الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار، وهو ما أشار إليه تقرير (2024) (مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق: SIGIR ) حيث يعتبر أن الصناديق الخارجية غالبًا هي أداة ضبط سياسي وضغط اقتصادي.
والإدارة الأجنبية قد تحول الإعمار إلى أداة للضبط السياسي والاقتصادي، بدل أن يكون رافعة للتنمية والسيادة المحلية. وفي هذا السياق، يحذّر الخبير الاقتصادي عمر شعبان، مؤسس مؤسسة “بال ثينك”، بعد حرب 2014، من أن آليات الإعمار التي تقودها الأمم المتحدة والدول المانحة أعادت إنتاج الحصار وفتحت المجال للفساد. اليوم، يؤكد خبراء محليون ودوليون أن أي إدارة خارجية مشروطة لإعادة إعمار غزة، ما لم تُبنَ على سيادة القرار الفلسطيني واستقلال صندوق الإعمار، قد تعيد إنتاج أدوات السيطرة نفسها التي شهدتها التجارب السابقة.
نزع السلاح: دروس من تجارب دولية
تُظهر التجارب أن نزع السلاح بعد الصراع قضية سيادية لا تقنية فقط، في كوسوفو أدت السيطرة الأجنبية على الأمن بعد نزع سلاح المقاومة إلى تهميش السلطات المحلية.
وبقيت فيها قوات دولية ضعيفة لا زالت تسعى لتدريب الشرطة وقمع الفساد.وتظهر هذه التجربة مخاطر الموافقة على نزع السلاح؛ إذ أصبح السلاح جزءًا من رقابة القوى الأجنبية، وكان له تأثير واضح على القرارات الوطنية والهوية الثقافية.
وفي العراق أدى تفكيك الجيش إلى فراغ أمني سريع ساهم في تصاعد الميليشيات والصراعات المحلية. وفي البوسنة والهرسك، أدى التفكيك الجزئي للأسلحة دون مؤسسات مراقبة قوية إلى تجدد التوترات.
أما في تيمور الشرقية فكان تحويل سلاح المقاومة إلى الجيش الوطني شرطًا للسلام. وفي هذا الإطار، وفي سياق الهوية الوطنية للسلاح. وبينما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه (في الأمم المتحدة ـ 25 سبتمبر 2025) حركة حماس والفصائل الأخرى إلى تسليم سلاحها للسلطة، مؤكدًا ضرورة «دولة بقانون واحد وقوات أمن شرعية واحدة ».
بينما أكد خليل الحية أن «سلاحنا الذي نحمله نحن وكل الفصائل الفلسطينية مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، فإذا انتهى هذا الاحتلال وأقيمت لنا دولة فلسطينية، فهذا السلاح وحاملوه سيتحولون إلى الدولة »
المقاومة ترى أن السلاح يظل مرتبطًا بالدفاع عن الأرض ومواجهة الاحتلال، وليكون أداة أمنية داخلية لحماية المدنيين ولضمان الاستقرار، ومن خطر السلاح المنفلت الذي قد يُستغل للعنف الداخلي أو ضد المدنيين.
وكذلك يتساءل الفلسطينيون في الضفة والقدس، كيف يتركون عزلا بلا وسيلة دفاع أمام تهديدات المستوطنين والمسلحين دون حماية؟
وربما تخلص التجارب الدولية السابقة إلى أن أي مسعى لنزع السلاح قبل قيام دولة ذات سيادة ومؤسسات أمنية راسخة قد يُعيد إنتاج سيناريوهات الفوضى والانقسام التي شهدتها تجارب كوسوفو والعراق والبوسنة التي لا تزال أسيرة اتفاق دايتون الذي أوقف الحرب دون أن ينهي الانقسام.
وأما بخصوص القوات الدولية والأممية فقد أكدت الفصائل الفلسطينية ـ على لسان خليل الحية في اللقاء المتلفز على قناة الجزيرة ـ “قبولها بالقوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار، مشددين على أن القرار الأممي سيحدد نوعية هذه القوات ومدتها وآليات عملها”. وأشار إلى أن هذا التوافق تم مع حركة فتح أيضًا.
غزة ، الإعمار والسيادة ولعبة الأمم
بعد انتهاء الأعمال القتالية، تقف الإدارة الوطنية في غزة أمام تحديات هائلة تتعلق بملفات إعادة الإعمار والنزوح الداخلي والاستقرار الاجتماعي، في ظل أضرار غير مسبوقة طالت البنية التحتية والاقتصاد، ووفقًا للتقرير المشترك الصادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي (فبراير 2025)، تُقدَّر احتياجات إعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية بنحو 53.2 مليار دولار على مدى عشر سنوات، منها نحو 20 مليار دولار عاجلة مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى. كما تُقدَّر الأضرار المادية بنحو 30 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية بما يقارب 19 مليار دولار، وفق ما جاء في التقرير المنشور على مواقع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي الميدان الإنساني، تُواصل وكالة الأونروا تسجيل موجات نزوح داخلي لمئات الآلاف، مع تعثّر في المساعدات وتوفير الطعام والعلاج، ما يبرز حجم التحدي الإنساني المباشر الذي تواجهه المؤسسات المحلية.
وتحذر تقارير أممية من أن تأخر الإعمار سيؤدي إلى تدهور إضافي في قطاعات الزراعة والمياه والتعليم والمرافق الصحية، مما يفاقم من مخاطر النزوح الداخلي ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى الطويل.
إلى جانب الأبعاد المادية والاقتصادية، تواجه غزة أيضًا تحديات ثقافية حادة. فالأنظمة الانتقالية غالبًا تبدأ بنزع السلاح وتنتهي بنزع الهوية؛ ففي كوسوفو أُغلقت مدارس اللغة الصربية، وفي تيمور الشرقية أُعيدت كتابة المناهج، وفي العراق مسحت الرموز الوطنية. وفي غزة، هناك تخوف من إعادة صياغة المناهج والخطاب الديني والاجتماعي بما يتماشى مع ما يُسمى “قيم السلام العالمي” (جوناثان برينر)، ما يضع عنصر الثقافة والهوية في قلب معادلة إعادة الإعمار والاستقرار.
وفي السياق السياسي، أعلنت الفصائل الفلسطينية حرصها على الحفاظ على حساسية استثمار الوقت والظرف، وحرص الكل الفلسطيني على السيادة الفلسطينية في إدارة القطاع. وقد عبّر خليل الحية عن ذلك قائلًا: “ليس لدى الحركة أي تحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، وستسلم كل مقاليد الإدارة بما فيها الأمن.”
وإذا كان على الحكومة الوطنية التي يطمح لها الفلسطينيون في غزة أن تراقب وتعمل على تحويل أموال الإعمار إلى مشروع وطني يحفظ السيادة ويعيد بناء الإنسان والمكان، كي تظلّ رهينة دوامة المساعدات المشروطة وتجارب الخارج الثقيلة، وأن تحذر من استنساخ التجارب الفاشلة التي شهدتها دول مثل العراق وكوسوفو والبوسنة، وأن تدرك تماما ما ورد في دراسات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أن الاعتماد الطويل على المساعدات الخارجية قد أدى إلى تآكل القرار المحلي وتحولات ديموغرافية واسعة) .، وما وثّقه مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق (2006) ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (2018) ( أن العراق أُنفق ما يصل إلى 60 مليار دولار ضمن برامج الإعمار، مع بقاء آثار عميقة على مؤسسات الدولة وارتفاع نسب الفساد، بينما لا زالت كوسوفو تعتمد على الدعم الخارجي).
الخاتمة: السيادة الفلسطينية: شرط أساسي لإعمار غزة واستقرارها
تظهر تجارب كوسوفو وتيمور الشرقية والعراق والإدرات الأجنبية لها ولغزة ، أنها كانت على شكل صيغة استعمارية محدثة ووصاية بغطاء إنساني من الخارج ، وأداة لتكريس نفوذ القوى الغربية المنتصرة.
وفي حالة غزة الآن علينا استحضار تقرير معهد كارنيغي للسلام الدولي ( 3 ديسمبر ـ 2018) إلى أن الكيانات غير المعترف بها دوليًا تواجه مخاطر “الاعتراف الزاحف”، بالإضافة إلى تحديات داخلية مرتبطة بضعف البنية القانونية والإدارية واعتمادها على المساعدات الخارجية، ما يحد من قدرة أي إدارة أجنبية على ممارسة صلاحياتها بشكل كامل.
واستحضار تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (فبراير 2025) والذي جاء فيه 🙁 تحقيق استقرار مستدام في غزة يتطلب حلولًا تراعي السيادة الفلسطينية وتوازنًا بين الدعم الدولي والقرار الوطني، لتجنب تكرار التجارب السابقة في مناطق أخرى ) .