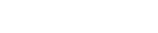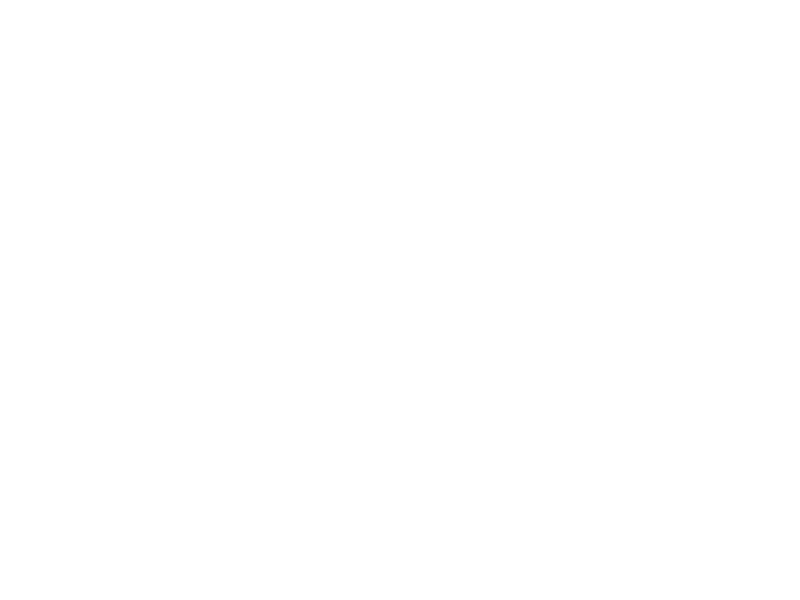إبراهيم العجلان

هل عداءٌ على أمة الإسلام أشد وأنكى من عداء يهود المغضوب عليهم؟
هل عرف المسلمون في تاريخهم أمةً أغدرَ وأحقدَ وأكيدَ من هذه الأمة المرذولة الملعونة في كتب الله، وعلى لسان أنبياء الله؟
لقد كانت سيرة يهود معنا ظلامٌ في ظلام، وأياديهم القذرة ملآ بالجُرم والإجرام، وحسبُنا أن نستعرض صفحةً من عدائهم لنا، صفحةً لا نختلف على شناعتها وبشاعتها، صفحةً تشعَّبَت منها صفحاتٌ وصفحات من الحقد والعداوات، إنها صفحة العداء اليهودي لمقام محمد – صلى الله عليه وسلم.
لقد حدَّثتنا آيات ربنا أن يهود المدينة كانوا على يقينٍ بمبعث آخر الأنبياء، وكانت يهود تتوعَّد قبائل العرب بأنها أول مَنْ يؤمن بهذا النبي المنتظَر، وأنهم سيقتلون المشركين قتل إرمَ وعاد؛ قال تعالى مُبيِّنًا حالهم: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} [البقرة: 89].
لقد عرفت يهودُ وصف النبي – صلى الله عليه وسلم – وبَيَّنَت اسمَه ورسمَه بما يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل: {الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146]، فلما بعث الله نبيَّه – صلى الله عليه وسلم – إلى قومه في مكة كانت يهود تَتسمَّع أخبار هذا النبي وتتشوَّق للقائه.
ويأتي هذا اللقاء، وتحين المقابلة الأولى، يوم أن هاجر النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة، فتسامع الناس بمجيئه، فتسارعوا وانجفلوا إليه، ولفِظَت يثربُ رجالها ونساءها وأطفالها لاستقبال ورؤية هذا النبي الكريم.
وكان ممن مشى إليه حُيَيُّ بنُ أخطب وأخوه أبو ياسر، وكانا من سادات يهود، ذهبا إليه مغلِّسين قبل صلاة الفجر، فأمعنا النظرَ فيه، وسَمِعا كلامَه، فما رجِعا من عنده إلا مع مغيب الشمس، رجَعَا منه كالِّين فاترين يمشيان الهوينى، فقال أبو ياسر لأخيه حُيَيِّ بن أخطب: أهُوَ هو؟ أمحمدٌ النبي الذي ننتظره؟
قال: هو هو.
قال: فما عندك فيه؟
قال: عداوتُه ما بقيت.
وتبدأ هذه العداوة الجبانة، وتتعدد في صورٍ وقوالب شتى، بدءًا من غمز النبي – صلى الله عليه وسلم – ولمز زوجاته، إلى هجائه باللسان، إلى تهديده وأصحابه علانيةً، مع أن المصطفى – صلى الله عليه وسلم – قد هادَنهم وصالَحَهم ووقَّع معهم اتفاقية تعايش وسلام.
ولنقف مع أحداث ثلاثة لنرى حجم هذا العداء السافر، والمكر الكُبَّار الذي لا يُحسنه إلا هؤلاء القطيع الدَّنِس النَّجِس:
الحدث الأول:
ها هو رسولنا – صلى الله عليه وسلم – يسعى جاهدًا يجمع ديةَ رجلين مشركَيْن قتلهما أحدُ المسلمين، جعل المصطفى – صلى الله عليه وسلم – يجمع هذه الديَة من إخوانه المسلمين ومن أحلافهم، وكان من أحلافهم يهودُ بني النضير.
مشى رسول الهدى إلى ديار بني النضير يطلب منهم العون في قضاء الديَة، وذلك بحسب المعاهدة بين الجميع على النصرة والحِلْف.
دخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أرض بني النضير مع بعض أصحابه، وحلَّ ضيفًا بين أظهرهم، ولكن هل أكرموا الضيفَ في الدار؟ وهل وفَّوا بالعهد وقاموا بواجب النصرة؟ كلا، كلا ..
لقد تحركت في قلوبهم عقارب الخيانة، فأقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون، وقالوا: إنكم لن تجدوا محمدًا في ساعة خير من هذه الساعة، ثم اتفقوا أن يغتالوا النبي – صلى الله عليه وسلم ، ففكَّروا وقرَّروا أن يصعد رجلٌ منهم سطح المنزل، فيلقي عليه حجرًا ليرتاحوا منه، فانتدب رجل منهم لهذه المهمة القذرة، وصعد سطح المنزل بصخرة عظيمة ليلقيها على الجسد الشريف، ولكن خبر السماء كان أسرع من رُقِيّ هذا الغادر الخائن.
فقام النبي – صلى الله عليه وسلم – من مكانه، وانسحب بصمت مظهرًا لأصحابه أنه سيعود إليهم، فلما تباطئه الصحابة قاموا في طلبه، فأدركوه وهو متجهٌ إلى المدينة، فأخبرهم بغدرة يهود، فوقعت في نفوسهم موقعًا عظيمًا، وكانت نهاية هذه المكيدة إجلاء يهود بني النضير من المدينة.
وموقفٌ آخر من مكائد يهود لمقام نبيِّنا – صلى الله عليه وسلم -:
ها هي يهود تتنفس دفائن الحقد، وهي ترى النبي – صلى الله عليه وسلم – قد كَسَر شوكة قريش، وأعداد الداخلين في دين محمد في ازدياد.
فاجتمع رؤوسهم ورؤساؤهم، فدبَّروا مكيدةً للتخلص من النبي – صلى الله عليه وسلم ، مكيدة لا تليق إلا بطبائع يهود، قرَّروا أن يسحروا النبي – صلى الله عليه وسلم ، فهم أهل هذه الصنعة ومحترفيها، تعلَّمَها آباؤهم من الشياطين التي سخَّرها الله مع سليمان: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102].
وبعد أن اختارت يهود طريقة الإيذاء نظروا وبحثوا عن أسحرهم وأمهرهم، فإذا برجلٍ من يهود بني زُريق يقال له: لُبيد بن الأعصم، أغروه بالمال، ووعدوه بالنوال إن أتمَّ هذه المكيدة.
فأقام عدوُّ الله ستة أشهر يُخطط ويُفكِّر ويُدبِّر عملية السحر، وفي بعض الروايات: أنه أظهر الإسلام حتى يسهُل عليه إتمام المهمة، ويظفَر هذا اليهودي بمشطٍ للنبي – صلى الله عليه وسلم – فيعقد بها عقدةَ السحر.
ويؤثر هذا السحر في جسد النبي – صلى الله عليه وسلم – لا على عقله وفكره، فأنبياء الله معصومون فيما يبلغون، وإنما كان أثر وتأثير هذا السحر أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يظنُّ ويُخيَّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى شكا لعائشة – رضي الله عنها – هذا الظنَّ الذي يعتريه.
وما هي إلا أيام معدودات، إلا والعناية الإلهية تحوط بالنبي – صلى الله عليه وسلم – فينزل جبريل – عليه السلام – ويُخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – بمكيدة يهود ومكان السحر الذي ألقِي في بئر لبني زُريق.
وجعل جبريل – عليه السلام – يرقي النبي – صلى الله عليه وسلم – بالمعوذتين، وكان كلما قرأ آيةً انحلَّت عقدة، حتى قام المصطفى – صلى الله عليه وسلم – كأنما نشط من عِقال، وردَّ الله كيد يهود بغيظهم، لم ينالوا خيرًا، وكفى الله نبيَّه شرَّهم.
وموقف آخر من عداء يهود تصغُر دونه كل العداوات:
ها هو رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخرج من غزوة خيبر منتصرًا مسقِطًا آخر الرايات اليهودية المناوئة له، وأفلَست كل حيل يهود في مواجهة الدعوة الإسلامية، وإطفاء نور الله تعالى عندما مكر اليهود مكرهم، وعند الله مكرُهم، وإن كان مكرُهم لتزول منه الجبال.
لقد قرَّر اليهود قرارًا خطيرًا، ونجحوا في تنفيذه، قرَّروا أن يدُسُّوا السمَّ في طعام النبي – صلى الله عليه وسلم – فعَمَدت امرأةٌ من أشقى اليهود إلى شاةٍ فذبحتها وطبختها وأشربتها السم حتى نقِع فيها، ثم سألت: أيُّ اللحم أحبُّ إلى محمد؟ قالوا: الذِّراع، فعَمَدَت إلى الذراع فأشبَعَتها سُمًّا، ثم دعَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم – إلى هذه الوليمة، وقدَّمت الشاة بين يديه وأصحابه، فأخذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذراع الشاة ورفعها، ثم مضغ مضغةً لم يستسغها، فنطقت حينها الذِّراع بأمر الله.
تكلَّمَت الذراع وهي بين فكيّ النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – خوفًا عليه لتخبره بأنها مسمومة، فيرمي النبي – صلى الله عليه وسلم – الذراع، ويأمر أصحابَه برفع أيديهم عن الشاة، وكان أحد أصحابه – وهو بشر بن البراء بن معرور – قد نَهَش منها نهشةً ولم يستسغها، لكن كرِه أن يلفِظها من فِيْه خشية أن يُنغِّص على النبي – صلى الله عليه وسلم – طعامَه.
ويسري السمُّ، ويأخذُ طريقه، فما قام بشر بن البراء من مكانه حتى تغيَّر لونه، وماطله الوجع، ثم توفي بعد ذلك من أثره.
أما نبينا – صلى الله عليه وسلم – فقد حبس الله عنه هذا السمَّ؛ فلم يَسْرِ في عروقه حتى يُكمل الدعوة ويبلِّغ الرسالة، وكان – عليه الصلاة والسلام – يشعر بنغزات هذا السمِّ حينًا بعد حين، حتى إذا أكمل الله الدين، وأتمَّ النعمة - تحرك هذا السم في البدن الشريف؛ فكان – صلى الله عليه وسلم – يقول في مرضه الذي مات فيه: ((مازالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري))؛ أي: عروقي.
لقد تقطعت نياط عروق المصطفى – صلى الله عليه وسلم – بسبب هذا السمِّ الذي دسته يهود، فالمسلمون يحتسبون رسولهم – صلى الله عليه وسلم – لقي ربه شهيدًا.
ولكن؛ هل انتهت مكائد يهود عند هذا الحد؟ كلا – إخوة الإيمان – أحباب محمد – صلى الله عليه وسلم.
هذه اليد اليهودية التي حملت الحجر لتلقيه على أطهر البشر، واليد التي عقدت العُقَد، واليد التي دسَّت السمَّ؛ هي اليد التي تسببت في قتل الخليفة الصالح، الذي كانت تستحي منه ملائكة الرحمن؛ عثمان بن عفان!! وهي اليد التي طعنت المسلمين في ظهورهم، وتسمَّت باسم الدولة الفاطمية، والتي ظاهِرها التشيع والرَّفض، وباطنها الكفر المحض، وهي اليد التي خلعت وألغت الخلافة الإسلامية العثمانية.
هذه اليد هي هي اليد التي ترتكب المجازر تلو المجازر لإخواننا في فلسطين منذ ستين سنة، هذه اليد الملطخة بالدماء، الملأى بالخيانة هي هي اليد التي تمد إلينا اليوم لنسالمها، لتَعِدَنا بعد ذلك بتعايش زاهر معها!!
هذه اليد الغادرة التي تمد يد الصلح والمصالحة، ستلوي يد مَنْ يصافحها حتى يعلن الهزيمة والاستسلام لهم، والاعتراف بأنه لهم حقًّا في أرضٍ اغتصبوها.
لنتذكَّر قبل أن نمدَّ أيادينا لهذه اليد السارقة أن أرض فلسطين لا يملك أي فلسطيني – فضلا عن غيرهم – التفريط فيها؛ فلكل مسلم حقٌّ فيها، هذه الأرض اشتريناها بدماء الصحابة والتابعين، ومهج جيوش صلاح الدين، وليس لكائنٍ مَن كان أن يبيعها بدنيا مؤثَرة أو عرشٍ يبقيه.
هذه اليد التي ترفع المصافحة لن تصافحنا بحرارة حقًّا، ولن تحتضننا صدقًا؛ إلا إذا أطعنا تلمودهم واتبعنا أهوائهم: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 145]، {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة: 120].
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة: 64].
بارك الله لي ولكم…..
الخطبة الثانية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،، أما بعد..
فيا إخوة الإيمان:
وفي الوقت الذي يُصدِّر فيه حاخامات اليهود الفتاوى الدينية لتبرير المجزرة الإسرائيلية، نرى ونسمع – وللأسف – أقلامًا وأصواتًا ليست بخافتة تصف ما جرى ويجري بأنه صراع لأجل أرض ومناطحة سياسية بين طرفين!!
هذه النُّخَب الثقافية – كما تسمي نفسها – تنزِّه الدين عن هذا الصراع، حتى لا يلَّوث جوهر الدين، وحفاظًا على نقاء الدين – كما يزعمون ويرددون – فماذا يريد هؤلاء المشوِّشون الملبِّسون؟!
هل يريدون إقناعنا أن آيات القرآن نزلت في قوم ماتوا وكانوا، ولا صلاحية لها في تصوير اليهود بعد ذلك؟
هل يريدون إقناعنا أن دولة إسرائيل في أصلها لم تكن دولة دينية توارتية؟
هل يريدوننا أن نقاوم ونجاهد لا لأجل عقيدة وهوية؟
إننا يجب أن نستيقن – عباد الله – أن خلافنا وصراعنا مع يهود هو خلاف عقيدة ودين، قبل أن يكون خلاف أرض وتراب، وما صهاينة اليوم إلا خَلَف أسوأ لسَلَف سيِّء.
صهاينة اليوم أشدُّ عداءً لنا من عداء آبائهم بالأمس.
صهاينة اليوم احتلوا أراضينا، واغتصبوها، وقتلوا أهلها، ومن لم يقتلوه شرَّدوه أو سجنوه واستضعفوه، وهذا شيءٌ لم يفعله أسلافهم.
صهاينة اليوم لم يمنعهم دينهم عن انتهاك حرمة سَبْتِهم! فبدؤوا حربهم الجوية يوم السبت، وحربهم البرية يوم السبت أيضًا، وهذا شيءٌ لم يفعله يهود بني قريظة مع النبي – صلى الله عليه وسلم.
صهاينة اليوم هدموا المساجد على الركَّع السُّجود، ومنعوا مساجد الله أن يُذكَر فيها اسمه، فإذا لم يكن تدمير دور العبادة عداءً دينيًّا؛ فلا يوجد في الأرض شيء اسمه عداء ديني.
صهاينة اليوم قتلوا الشيوخ والنساء والأطفال، يوم أن عجز أو جبن يهود الأمس عن هذا الإثم العظيم.
أما يكفينا ما ذاقته قضية فلسطين من تشويش وتلبيس وتزوير؟ لقد كانت قضية فلسطين أول ما كانت قضية إسلامية، فَقُلِّمَت فأصبحت قضية عربية، ثم حُجِّمَت فأضحت قضية فلسطينية، ثم خُنِقَتْ فغدت قضية الأراضي المحتلة، يعني أن هناك أرضان: أرضٌ محتلة، وأرضٌ إسرائيليةٌ لا نزاع فيها!
ثم إلى متى هذه الانهزامية، وتنحية راية الدين والإسلام عن هذا الصراع؟ أليست هذه الراية تخدم القضية الفلسطينية في الدرجة الأولى، فإذا رفعناها سمعنا صدى الاستجابة لها في أحراش أندونيسيا وأدغال أفريقيا؟! أليست هذا الراية هي الراية التي ستقطع وتبتر اليهود غدًا، فيعرفها الحجر والشجر، فينادي: ((يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهوديٌّ خلفي، تعال فاقتله)).
والعجب أن ساسة اليهود وكبراءهم قد علموا أن نهايتهم لن تكون إلاَّ على يد هذه الراية الإسلامية، يوم أن يرجع المسلمون لدينهم ويقاتلون لأجل مبادئهم!
لقد قالتها رئيسة وزراء إسرائيل (جولدا مائير): “نحن لا نخاف من المسلمين إلاَّ عندما يصلون الفجر في المسجد كما يصلُّون الجمعة”!
أما وزير الدفاع الأسبق (موشي ديان) فقد قال مخاطبًا أحد المسلمين: “حقًّا سيأتي يومٌ نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءةٌ نجد لها في كتبنا أصلاً، ولكن متى؟ إذا قام فيكم شعبٌ يعتز بتراثه، ويحترم دينه، ويقدِّر أما أما قيمته الحضارية”.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد…..
نقلاً عن موقع الألوكة