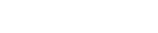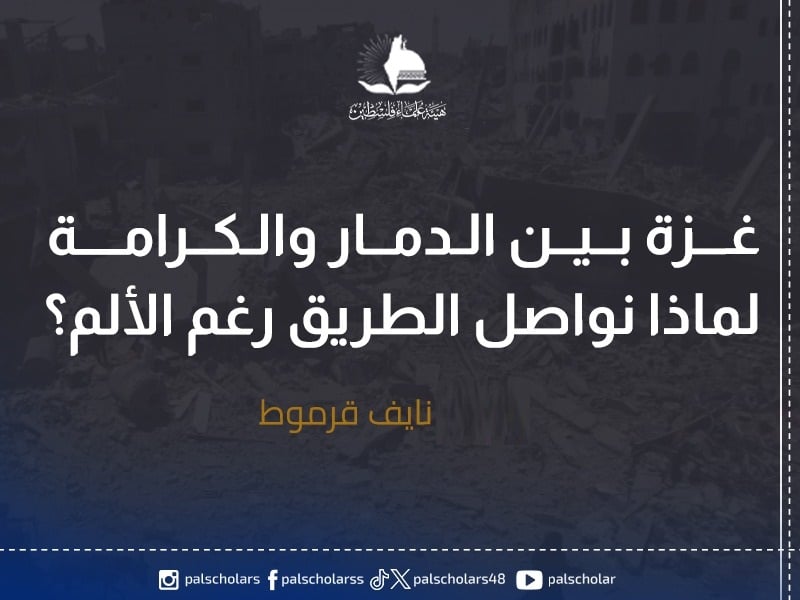14/2/2025

كلمة الحرية في اللغة العربية لا تدل إلا على المعاني الحسنة المحمودة، فالحرّ: كل شيء فاخر، ومنه قولهم: سحابة حرة؛ أي كثيرة المطر، وطين حرّ أي لا رمل فيه. والحرّ: الفعل الحسن، يقال: ما هذا منك بحر؛ أي بحسن ولا جميل. والحرّ: نقيض العبد، وحرره: أعتقه.
والحرية في نظر الإسلام هي: انفلات الإنسان من استعباد الناس له؛ ليكون عبدا خالصا لله تعالى. لذا كان توحيد الله تعالى هو موضوع جميع الرسالات السماوية، قال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (النحل: 36). وبهذا تكون الحرية المنشودة في العبودية الحقة لله تعالى. وهذا ما فهمه الصحابة الكرام بجلاء ووضوح، وما أبلغ جواب ربعي بن عامر، رضي الله عنه، لرستم قائد الفرس، يوم القادسية، حين سأله ما الذي جاء بكم؟ قال: “جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام”.
فرسالة الإسلام لا تكتمل إلا بالدعوة إلى الحرية والعدل وتغيير الناس لحياة أفضل. وقد أصّل سيد قطب لمفهوم الحرية تأصيلا فذا عند تفسير قوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) وسمَّى سجود المسلم في صلاته “سجدة الحرية” فبها ينعتق الإنسان من كل عبودية لغير الله، وكل استعباد يمارسه إنسان ضد إنسان آخر هو في الحقيقة نزع لحريته، ولن يكون الإنسان كريما في ظل عبوديته لمخلوق مثله، “فالحرية ملازمة للكرامة الإنسانية، فهي حق طبيعي لكل إنسان، وهي أغلى وأثمن شيء يقدسه الإنسان ويحرص عليه” (الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته 6/720).
***
مبدأ إتاحة الحرية في الإسلام:
الحرية في الإسلام لا تعني الانفلات من كل قيد، بل هي منضبطة بالأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية، فلا عبث وفوضى باسم التحرر، ولا ضرر ولا ضرار باسم الحرية، فإذا تعارضت مصلحة خاصة مع مصلحة عامة قدمت العامة بلا ريب.
ويمكن تعريف مبدأ إتاحة الحرية في الإسلام بأنه: تمكين الإنسان من ممارسة حقوقه المعنوية والمادية دون الإضرار بغيره.
ويقصد بالحقوق المعنوية حرية التفكير وإبداء الرأي، ومن ثم حرية الاعتقاد تبعا، وأما الحقوق المادية فهي كحرية العمل والتملك والتنقل ونحو ذلك. وهذه كلها تندرج تحت ما يسمى الآن بالحريات العامة.
***
حرية الاعتقاد والتفكير:
اعتقاد أمر ما هو ثمرة من ثمار التفكير، فبعد التفكر والتدبر يهتدي الإنسان لدينٍ ما يعتقد صحته، ويقوى هذا الاعتقاد كلما كان منهج التفكير الذي اتبعه الإنسان سليما لا يعارض المنطق، حتى يصبح هذا الاعتقاد من القوة والصلابة بحيث لا يسهل تغييره أو زعزعته، ولو عن طريق الإكراه، وهذا ما تفيده كلمة “عقد” التي اشتق منها “عقيدة” فالعقد نقيض الحل، وهو يفيد الملازمة، ومنه قول النبي، صلى الله عليه وسلم: “الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة” (متفق عليه).
وتتجلى حرية الاعتقاد والتفكير في الإسلام من خلال عدة أمور وهي:
الإسلام لا يكره أحدا على اعتناقه :
إن واجب المسلمين تجاه غيرهم دعوتهم إلى الإسلام وتبيان طريق الرشاد لهم وتحذيرهم من طريق الغي والضلال، كل ذلك بالحجة والبرهان لا بالضغط والإكراه، فالإيمان معناه التصديق، والتصديق محله القلب، فإن ملك الإنسان تعذيب الجوارح لإكراه غيره على تغيير عقيدته، فإنه لا يملك بحال إكراه قلبه على ذلك.
إن حرية الاختيار حق مكفول لجميع الناس ولو خالفت اختياراتهم العقل والبرهان، قال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (يونس: 99). وهذه ممارسة أصيلة عند المسلمين، شهد بذلك المستشرقون المنصفون، قال بتلر في كتابه فتح العرب لمصر واصفا حال الأقباط فيها بعد الفتح: “وأصبح القبط في مأمن من الخوف الذي كان يلجئهم إلى إنكار عقيدتهم أو إخفائها تقية ومداراة، فعادت الحياة إلى مذهب القبط في هذا الجو الجديد، جو الحرية الدينية” (ص454، 455)، وقال في موضع آخر: “وكانوا من قبل تحت نيرين من ظلم حكام الدنيا واضطهاد أهل الدين، فأصبحوا وقد فك من قيدهم في أمور الدنيا وأرخي من عنانهم، وأما دينهم فقد صاروا فيه إلى تنفس حر وأمر طليق” (ص460).
إقرار مبدأ الاجتهاد:
الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في سبيل الوصول إلى الصواب، فلابد لصحته من تحري أساليب البحث العلمي الدقيق، لذا اشترط الأصوليون في المجتهد شروطا لابد من تحققها فيه ليكون أهلا لإبداء رأيه، فلابد أن يكون عالما باللغة العربية متمكنا في فهم الكتاب والسنة عالما بالقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة قادرا على القياس وإدراك الواقع، ولا يجبر فقيه على اتباع طريقة بعينها في التفكير لاستنباط الأحكام والحكم على النوازل، وفي المقابل لا يقبل الإسلام الاستناد إلى مبدأ حرية الرأي والتفكير لنشر الفساد والضلال لما يترتب عليها من إضرار بمصالح الناس العامة والخاصة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (الأحزاب: 70)، وقال: (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (الإسراء:53).
إقرار مبدأ الشورى:
الشورى مظهر من مظاهر حرية الرأي في الإسلام، ولقد سميت سورة في القرآن الكريم باسم “الشورى” للدلالة على أهميتها، فعن طريقها تتخذ القرارات المهمة في الدولة من اختيار القيادة إلى تشريع القوانين التي تنظم حياة الناس وتحفظ حقوقهم، وقد أمر الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي بمشاورة أصحابه فقال: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (آل عمران: 159)، وقال مبينا أن التشاور من صفات المؤمنين: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) (الشورى: 38).
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ربط الله خيرية الأمة الإسلامية بشرطين ملازمين للخيرية، فإن وجدا استحقت الأمة وصف الخيرية، وهما: الإيمان بالله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران: 110)، وكذا فإن التواصي بالحق والتناصح بين المؤمنين سبيل المفلحين الناجين، قال تعالى: (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (سورة العصر).
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: “الدين النصيحة” (رواه مسلم).
ولا عجب بعد ذلك أن عدّ النبي، صلى الله عليه وسلم، المجاهر بكلمة الحق والعدل من أعظم الجهاد حيث قال: “إن من أعظم الجهاد كلمة عدل -وفي رواية: حق- عند سلطان جائر” (رواه النسائي وابن ماجه وأحمد والترمذي). ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نكون إمعات نقلد غيرنا بلا رأي وتمحيص فقال: “لا تكونوا إمعة؛ تقولون إن أحسن الناس أحسنَّا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا” (رواه الترمذي).
حرية ممارسة الحقوق المادية:
لعل التمتع بحق حرية العمل هي أهم مرتكز لتنظيم عجلة الاقتصاد وتنميته في المجتمع في نظر الإسلام، ولترسيخ دعائم هذا الحق قام التشريع الإسلامي بثلاثة إجراءات على النحو الآتي:
نهي القادر على العمل عن سؤال الناس أباح الإسلام للمحتاج سؤال الناس للضرورة سدا لحاجاته الأساسية، وشرع الزكاة والصدقات سبيلا للقضاء على الفقر والعوز، وكره للناس كثرة السؤال، قال النبي، صلى الله عليه وسلم: “ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم” (متفق عليه)، ونهى القادر على العمل عن سؤال الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: “لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه” (رواه البخاري)
حث المسلمين على العمل:
الناظر في نصوص الشريعة الغراء يجد أن الإسلام فضل العامل على القاعد، وجعل اليد العليا خيرا من اليد السفلى، ورغّب في الأعمال المختلفة لتحقيق مصالح العباد، كممارسة التجارة والزراعة والصناعة، حتى ظهرت في أحكام الشركات وعقود المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها، مما يسهم في بناء اقتصاد المجتمع لتحقيق الرخاء والرفاه.
اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص:
العمل متاح لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو محاباة، وقد مارس أهل الذمة أعمالهم المختلفة في الدولة الإسلامية بكل حرية.
وبجانب حرية العمل هناك حرية التنقل وحرية التملك، وقد جاء الإسلام موافقا لفطرة الإنسان فاحترم الملكية الخاصة، فللإنسان مطلق الحرية في التصرف فيما يملك، بشرط عدم الإضرار بالآخرين، وإذا تعارضت مصلحة خاصة مع مصلحة عامة قدمت المصلحة العامة، بشرط تعويض صاحب الملك، فيجوز لتوسيع شارع عام أو بناء جسر أو توسعة مسجد أو سوق، لحاجة عامة، أن تنزع أرض من مالكها على أن يعوض التعويض المناسب؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.
***
وفي الختام
لا عجب أن يتغنى الشعراء والثوار بالحرية وأن يبذلوا النفس من أجلها، فالطغيان والاحتلال والاستبداد هي في جوهرها سلب للحرية، ولله در المجاهدين الثائرين عندما تغنوا ببيت أمير الشعراء أحمد شوقي:
وللحرية الحمراء باب ** بكل يد مضرجة يدق
حتى لقوا ربهم أعزة أحرارا، وألهموا الأمة للسير على درب الحرية التي كفلها الإسلام وغرسها في قلوب معتنقيه.
**************
نقلاً عن: